 |
 |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: 111- 113]. ﴿ وَقَالُوا ﴾ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بقرينة قوله بعده: ﴿ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ جمع هائد، وقيل: يهودًا فحذفت الياء الزائدة، وقدم هودًا على نصارى لتقدمها في الزمان، ﴿ أَوْ نَصَارَى ﴾ «أو» للتفصيل والتنويع، فهي من كلام الحاكي في حكايته وليست من الكلام المحكي؛ إذ معلوم أن اليهودي لا يأمر بالنصرانية، ولا النصراني يأمر باليهودية ﴿ تِلْكَ ﴾ المقولة الصادرة منهم ﴿ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ جمع أمنية، وهي: ما يتمنَّاه المرء بدون ما يعمل للفوز به، فيكون غرورًا. وفيه: أن من اغتر بالأماني، وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها؛ ففيه شَبه من اليهود والنصارى. ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ الحجة الواضحة ﴿ إِنْ ﴾ أتى بـ «إن» المفيدة للشك في صدقهم مع القطع بعدم الصدق لاستدراجهم حتى يعلموا أنهم غير صادقين حين يعجزون عن البرهان؛ لأن كل اعتقاد لا يقيم معتقده دليل اعتقاده فهو اعتقاد كاذب؛ لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه، ومن باب أوْلَى لا يكون صادقًا عند مَنْ يريد أن يروج عليه اعتقاده. ﴿ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 94، 95]، وقوله: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الجمعة: 6]. وفيه: عدل الله -عز وجل- في مخاطبة عباده، حيث قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بيِّنة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير. روي أنه لما جاء وفد نصارى نَجْران من اليمن إلى المدينة التقى باليهود في مجلس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولعدائهم السابق تَمَارَوْا، فادَّعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديًّا، وادَّعَت النصارى أن الجنة لا يدخلها إلا من كان نصرانيًّا، فرَدَّ الله تعالى عليهم، وأبطل دعواهم؛ حيث طالبهم بالبرهان عليها فلم يقدروا، وأثبت تعالى دخول الجنة لمن زكَّى نفسه بالإِيمان الصحيح والعمل الصالح. ونَجْران قبيلة من عرب اليمن كانوا ينزلون قرية كبيرة تُسمَّى نجران بين اليمن واليمامة، وهم على دين النصرانية، ولهم الكعبة اليمانية المشهورة، وهي كنيستهم التي ذكرها الأعشى في شعره، وقد وَفَد وَفْدٌ منهم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ستين رجلًا، عليهم اثنا عشر نقيبًا، ورئيسهم السيد وهو عبد المسيح، وأمين الوفد العاقب واسمه الأيهم، وكان وفودهم في السنة الثانية من الهجرة. ﴿ بَلَى ﴾ كلمة يُجاب بها المنفي لإثبات نقيض النفي وهو الإثبات، سواء وقعت بعد استفهام عن نفي وهو الغالب نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: 8] بلى أي هو أحكم الحاكمين، أو بعد خبر منفي نحو ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: 3]. ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ﴾ وإسلام الوجه لله هو تسليم الذات لأوامر الله تعالى؛ أي: شدة الامتثال؛ لأن أسلم بمعنى ألقى السلاح وترك المقاومة، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ [آل عمران: 20]. والوجه هنا يحتمل أن يُراد به الجارحة خُصَّ بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاء، أو لأنه فيه أكثر الحواس، أو لأنه عبَّر به عن الذات، ومنه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: 88] ويحتمل أن يُراد به الجهة، والمعنى: أخلص طريقته في الدين لله تعالى. ﴿ لِلَّهِ ﴾ انقاد ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ مخلص، جملة مؤكدة من حيث المعنى؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن.. أي ليس الأمر كما تزعمون، فلا يدخل الجنة يهودي ولا نصراني؛ ولكن يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن؛ أي: عبد آمن فصدق وعمل صالحًا فأحسن. وقيل: إظهار أنه لا يغني إسلام القلب وحده ولا العمل بدون إخلاص بل لا نجاة إلا بهما، ورحمة الله فوق ذلك؛ إذ لا يخلو امرؤ عن تقصير. ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم، ولو مع حسن النية؛ لعدم الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر مشروط بأمرين: الأول: إسلام الوجه لله؛ والثاني: الإحسان. ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ فأجره مستقر له عند ربه، ولما أحال أجره على الله أضاف الظرف إلى لفظة ربه ﴿ عِندَ رَبِّهِ ﴾ الناظر في مصالحة ومربيه ومدبر أحواله، ليكون ذلك أطمع له؛ فلذلك أتى بصفة الرب، ولم يأتِ بالضمير العائد على الله في الجملة قبله (يعني: فله أجره عنده)، ولا بالظاهر بلفظ الله (يعني: فله أجره عند الله). فأضاف العندية إليه لفائدتين: الفائدة الأولى: أنه عظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم؛ ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاه أنه قال: (فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ)؛ [البخاري]. والفائدة الثانية: أن هذا محفوظ غاية الحفظ، ولن يضيع؛ لأنك لا يمكن أن تجد أحدًا أحفظ من الله؛ إذًا فلن يضيع هذا العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان. فالإضافة إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعامل، وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة. ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلونه من أمرهم ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ فيما مضى من أمرهم، وما يتركونه من أمر الدنيا. وجمع الضمير ﴿ عَلَيْهِمْ، هُمْ ﴾ حملًا على معنى «من»، فحمل أوَّلًا على اللفظ في قوله: ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾، وهذا هو الأفصح، وهو أن يبدأ أولًا بالحمل على اللفظ، ثم بالحمل على المعنى، وهو من تفنُّن العربية للفصاحة ودفع سآمة التكرار. وفيه: انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين؛ وهما الإخلاص والمتابعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]. وغير المؤمنين تُملأ قلوبهم رُعْبًا وحزنًا؛ قال تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: 166]، وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 167]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [مريم: 39] إلى غير ذلك من الآية الدالة على هوان هؤلاء الذين لم يهتدوا إلى صراط الحميد. ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْء ﴾ يعتد به من الدين الحق ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ﴾ التوراة والإنجيل، وهذا تعجب ونعي عليهم في مقالتهم تلك؛ إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه، شاهدة توراتهم ببشارة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وصحة نبوَّتهما، وإنجيلهم شاهد بصحة نبوَّة موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ كُتُب الله يُصدِّق بعضُها بعضًا، فكل فريق يتلو كتابه، ويعلم شريعة التوراة والإنجيل؛ ولكنهم تجاحدوا كفرًا وعنادًا. وفي هذا تنبيه لأمَّة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أن من كان عالمًا بالقرآن، يكون واقفًا عنده، عاملًا بما فيه، قائلًا بما تضمنه، لا أن يخالف قوله ما هو شاهد على مخالفته منه، فيكون في ذلك كاليهود والنصارى. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ تشبيه في الادِّعاء على أنهم ليسوا على شيء ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لا علم عندهم ولا كتاب سماوي ﴿ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ وكذلك قال غير هؤلاء من الجاهلين، الذين كفروا بالنبوَّات، مثل هذه الأقوال، وكفروا عنادًا وحسدًا. ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ ﴾ يفصل ويقضي ﴿ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ والمقام مقام تحذير. قال ابن عاشور: والآية معطوفة على قوله: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ لزيادة بيان أن المجازفة دأبهم، وأن رمي المخالف لهم بأنه ضالٌّ شنشنة قديمة فيهم، فهم يرمون المخالفين بالضلال لمجرد المخالفة، فقديمًا رمت اليهود النصارى بالضلال ورمت النصارى اليهود بمثله، فلا تعجبوا من حكم كل فريق منهم بأن المسلمين لا يدخلون الجنة، وفي ذلك إنحاء على أهل الكتاب، وتطمين لخواطر المسلمين، ودفع الشبهة عن المشركين بأنهم يتخذون من طعن أهل الكتاب في الإسلام حجة لأنفسهم على مناوأته وثباتًا على شركهم. وفي الآية إثبات الحكم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾، وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي، وكوني، وجزائي. فالشرعي: مثل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الممتحنة: 10]. والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يوسف: 80]. والجزائي: مثل هذه الآية: ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني عليه: إنْ خيرًا فخيرٌ؛ وإنْ شرًّا فشَرٌّ؛ هذا الحكم يوم القيامة بين الناس إمَّا بالعدل أو بالفضل، ولا يمكن أن يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 49]، وقوله تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا) [مسلم]؛ هذا بالنسبة لحقوق الله، أما بالنسبة لحقوق الخَلْق فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل. فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضل، فما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ [يونس: 4]؟ فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه، والفضل زيادة. 

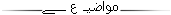
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴾ | جنــــون | الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية | 12 | 01-03-2023 04:11 AM |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ الم ﴾ | جنــــون | الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية | 7 | 12-27-2022 10:11 PM |
| ﴿ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ | لا أشبه احد ّ! | الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية | 13 | 09-06-2022 02:00 PM |
| ﴿وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ﴾ | ملكة الجوري | الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية | 13 | 02-13-2022 09:26 PM |
| ﴿ ومن أحسن قولا؟ ﴾ | ملكة الجوري | الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية | 28 | 02-09-2022 03:44 PM |
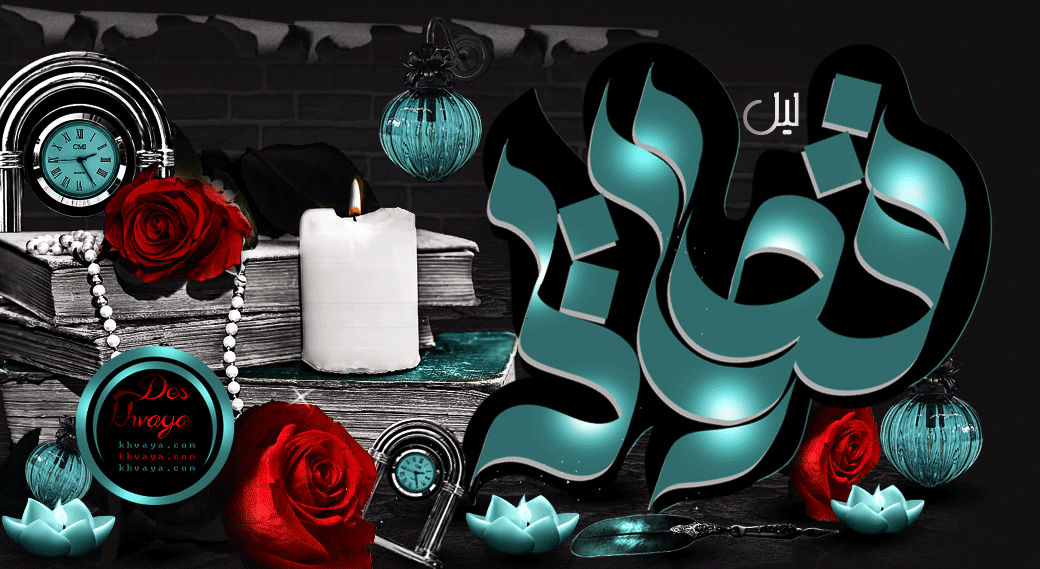 |