
 |
 |
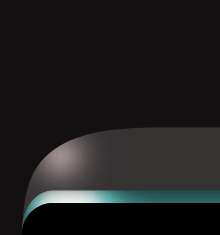 |
|
|
|
|
||||||||
 |
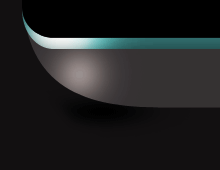 |
| …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… { .. كل ماهو جديد للشعراء والشاعرات من مقروء و مسموع وتمنع الردود .. } |
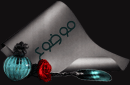
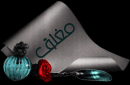 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ابي عبد الرحمن بن عقيل

مبادئ فى نظريةالشعروالجمال لأبي عبد الرحمن بن عقيل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أولاً : من هو الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى؟ قال شيخنا عبد العزيز الحنوط حفظه الله : أما عن شيحنا أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ فقد كان في العلم بحراً لا تكدِّره الدِّلاء ، وله لَسَنٌ وبلاغة وبصر في الحديث ورجاله ،وعربية مُتقنةٌ ، وباعٌ مديد في الفقه لا يُجارى فيه ، وكان حجة في التفسير ، وكذا في الأداب والمنطق والشعر والتأريخ والأنساب ، وكان عجيباً في الفهم والذكاء وسعة العلم ، وكان عجباً في إلقاء الدرس ، وكان ذا ذهنٍ ثاقب وحدْسٍ صائبٍ ، عذب المنطق ، كريم الشمائل ، وكامل السُّؤدُد ، لا يَملُّ جليسُه منه ، متواضعاً ذا فضائل جمة ، وتواليف كثيرة تصل إلى مائة عنوان مابين كتاب من عدة مجلدات إلى رسائل صغيرة ، وتتناول هذه المؤلفات مختلف الفنون والمعارف فبعضها في الدين والأدب والتاريخ وبعضها في النقد والشعر والفلسفة وقسم آخر في اللغة والرحلات والأنساب وغير ذلك .والميزة العظيمة لهذا الشيخ الجليل أنه سلفي المنهج لا يتعصب لإمام ولا مذهب إنما الدليل غايته والحق مطلبه ونصرته . ومن أراد أن يتعرف على السيرة الذاتية لشيخنا الجليل فما عليه إلا أن يرجع إلى ماكتبه الشيخ عن نفسه في : 1ـ شيء من التباريح ( سيرةٌ ذاتيةٌ ... وهمومٌ ثقافية ) وقد صدر منه جزءين . 2ـ الحِباءُ من العَيْبَةِ غِبَّ زيارتي لطيبة ولمن يريد ترجمة عن العلامة الكبير أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ فلينظر إلى كتاب : " شَيْخُ الكَتَبَة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري : حياته ، وآثاره ، وما كتب عنه " للدكتور أمين سليمان سيدو. الطبعة الأولى 1425ه 2004م ـ النادي الأدبي بالرياض القسم الأول استفتاح وتوطئة الحمد لله الذي خلق الإنسان .. علمه البيان ..خلق الإنسان من علق وهو الأكرم الذي علم بالقلم .. علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على هادي الأمة، ونبي الرحمة .. معلم الكتاب والحكمة . وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن الشعر فن قائم بذاته وهو فرع من الأنواع الأدبية يشترك معها في كونه تعبيراً فنياً، وله خصوصيته التي تميزه عن بقية الأنواع الأدبية . والسلف يصنفون الشعر في الآداب فحسب، ويشعرون في لفتاتهم النقدية بأنه فن جميل، ويتسع مدى معرفتهم بعلاقته بأحد فروع الفنون الجميلة، وهو فرع الموسيقى . وتطور العلم البشري، واكتسب التصنيف العلمي دقة وتمحيصاً، فأدخلت الأنواع الأدبية - بما فيها الشعر- في الفنون الجميلة. قال أبو عبدالرحمن : وإذن نبدأ بتحليل الشعر في تصنيفه العلمي من الأعم إلى الأخص، فنرى أولاً أنه فن جميل . وفي نفس الوقت نرى أن الشعر في ذاته نص فني، أو نموذج جمالي.. وهذا يقتضي أن يكون له علم خاص به كأي حقل معرفي . وعلم الشعر نقده، ونظريته، وتاريخه، وظواهره الأصولية .. إنه متن لعلم . وبما أن الجمال هو أعم ما يُصنف فيه الشعر: فإن علم الجمال ونظرياته هو أساس قيم الشعر النقدية . ومن أهم هذه العلاقات ما لم تتم هوية الشعر إلا به، وذلك هو المدد الموسيقي للشعر. ومنها ما لا تكمل جماليته بدون واحد منها كالتصوير . إذن يضاف ثانية إلى الشعر (النقد، والنظرية) عناصر نقدية من خصوصيات الفنون الجميلة كالموسيقى والتصوير.. وكل ذلك أخص من علم الجمال المتعلق بفلسفة الإحساس بالجمال، وسيكولوجيته، ورسم خصائصه في الذات والموضوع. ثم ننظر إلى الشعر ثالثة فنراه جمالاً تعبيرياً كلامياً، فنسبر من نماذجه ونماذج الفنون التعبيرية الكلامية الجميلة الأخرى ما يشارك فيه غيره من خصائص جمالية لنحقق الجمال الشعري الأخص. وحينئذ نسترفد اللغة في متونها وعلومها، ونسترفد البلاغة في علومها ونماذجها لبناء نظرية الشعر - بخاصيته - ونقده . إذن الغرض من استرفاد متون وعلوم التعبير الكلامي أن نستخلص علم ما هو جميل من الكلام، لنميز خاصية الجمال الكلامي عن بقية الفنون الجميلة، لأننا نسبر فناً من الفنون الجميلة . والذي يحكم لنا بجمال ما نستخلصه من متون التعبير الكلامي وعلومه هو ما لدينا من نظريات وأصول علم الجمال، وعلوم الفنون الجميلة . قال أبو عبدالرحمن : وتبقى أمور مقحمة في نظرية الشعر ونقده وعلومة ليست من خاصية الشعر وتصنيفه، فمن ذلك المضمون كأن يكون جميلاً خلقياً أو قبيحاً، وكأن يكون جميلاً منطقياً أو قبيحاً (والمعادل لكل ذلك أن يكون خيراً)، أو شراً، أو حقاً، أو باطلاً) .. فهذه أمور تتعلق بسلوك الفكر، وسلوك الجوارح .. وهذان السلوكان هما مضمون الشعر، وليسا شرط وجوده . وبيان ذلك بالإلماح إلى ظاهرتين : أولاهما : أن للغة العربية حقيقة، وهي أن تكون محفوظة عن العرب وقت السليقة، وأن ترتبط بمعناها المأثور، وتسميها حينئذ لغة عربية . ثم تسمع كلمة أخرى مرتبطة بمعناها، ولكنها ليست محفوظة عن العرب، وهي مما حدث بعد السليقة، وليست جارية على أصول الفصحى، فتحكم بأنها غير عربية، وبأنها عامية أو أعجمية. ثم تركب الكلمات العربية المأثورة معبراً وداعياً إلى قبح من شر أو باطل، فتظل المفردة عربية، ويظل التركيب عربياً، لأن المضمون الجميل أو القبيح ليس شرط التمييز بالعربية، وتحقيق ماهية اللغة العربية . وهكذا الشعر ومضمونة .. يظل فسق أبي نواس في فنه الشعري شعراً، لأنه حقق مدلولاً ما هو جميل في التعبير الكلامي وفق أصول مأخوذة من علم الجمال بعامة، ثم من علوم الفنون الجميلة، ثم من خاصية الجمال في التعبير الكلامي . قال أبو عبدالرحمن : ومعاذ الله أن أكون داعية للباطل والشر والقبح، وإنما أقول : قبح السلوك الفكري والعملي من قيم أخرى خارج دائرة التخصص الشعري يقوم بها المربون والمصلحون، ونبراسهم الدين والأخلاق وعزائم الفكر.. وبغير فن التخصيص الشعري يقولون : أيها الشعراء المدهشون الذين تملكون إبداع النص وظفوا شعركم - باسم المنطق والأخلاق لا باسم التخصيص الشعري - لرسالتكم الحقيقية في الحياة . وهذا النداء متوجه للغة الشعر الخصوصية، وللغة العلم العادية التقريرية المباشرة، وللغة الخطابة التي هي تعبير بين وبين . وأخراهما : أن الشعر ومضمونة غيران، وليسا شيئاً واحداً . وهذه حقيقة تُحرِج من درَّبه بعض معلميه التراثيين مدى عمره الأدبي بأن الشكل والمضمون لا ينفصلان . قال أبو عبدالرحمن : الانفصال متحقق في وجهتين : أولاهما : أن تأخذ مضمون النص الشعرى وتعبر عنه بكلام عادي مباشر لا مسحة فيه من الجمال، فتقول : هذا مضمون واحد عَّبر عنه الشاعر فكان شعراً، وعبرتُ عنه فكان نظماً، فالشكلان مختلفان . وأخراهما : إبقاء المضمون على تعبير الشاعر - وذلك هو الشكل - والتفريق بينهما بالحكم، فتقول : بيت أبي نواس في الخمرة شعر جميل، لأنه عبر عنه بشعر!. وذلك المضمون قبيح، ولكن بغير ملكة الجمال التي تعطي شكل الشعر خاصيته، وإنما ذلك بحكم الدين والأخلاق اللذين يستقبحان هذا السلوك، فهو جمال فكري معنوي، وليس جمالاً تعبيراً . وتوظيف الشعر، وشرف مضمونه رسالة لا تعطيك إياها نظرية الشعر التي من الدين والمنطق خارج دائرة النظرية الشعرية التي يتخصص بها ما هو شعر دون ما هو خلق ودين وحقيقة .. أو عصيان وفجور وإباحية . ولو جاء مدح العفة في نظم عادي لا مسحة فيهمن مسحات الجمال الشعري لكان المضمون جميلاً في الدين والأخلاق، ولكان النص قبيحاً أو بارداً بمفهوم الشعر، أو لكان بارداً لا يثير جمالأ ولا قبيحاً . إذن حقيقة الجمال الشعري مثول القدرة على التعبير الجميل عن أي مضمون جميل أو قبيح. قال أبو عبدالرحمن : والذي أحرج القوم في غياب التصور للفصل بين الشكل والمضمون أنهم يطالبون بتحقيق وجودين منفصلين لنص شعري، فتقول : قال أبو نواس شكلاً منفصلاً عن المضمون !! . وهذا محال بلا ريب، لأن الشاعر حقق مراده بحيله الفني، ولا ينفصل مضمونه عن وسيله أدائه، إلا أن هذه الوحدة غير مؤثرة في محل النزاع . وإنما محل النزاع القدرة على التعبير الجميل عن مضمون جميل أو قبيح، وهذا متحقق بالجهتين اللتين ذكرتهما آنفاً. فالشعر قدرة على الأداء الجميل لأي مضمون . والمضمون إرادة سلوكية فحسب تكون بالشعر وبالكلام العادي . والتفريق بين المضمون والشكل تفريق لغوي، وتفريق تجربة بشرية .. إنه تفريق مثلاً بين أساليب طه حسين والزيات وسيد قطب ودريني خشبة وأساليب الهمذاني والحريري وكتاب عصور البديع المتكلف لو تناولوا كلهم مضموناً واحداً.. إذن المضمون الواحد قابل التعبير به أكثر من شكل . أما أنهما لا ينفصلان إذا اجتمعا فتلك قضية أخرى لا تمنع من قدرة الأديب في البداية -قبل الجمع بينهما- من اختيار الأسلوب الذي يريده للمضمون الذي أراده. ألا ترى أن زيداً من الناس لا ينفصل لحظة من الزمن منذ وجد من كونه حياً أو ميتاً بالتعبير الحقيقي لا المجازي .. فهل كون زيد حياً حتماً أو ميتاً حتماً .. لا ينفصل عن الحياة أو الموت .. هل كونه حتماً كذلك يمنع من كون زيد والحياة غيرين، وكون زيد والموت غيرين ؟!. قال أبو عبدالرحمن : ومن الأمور الفضولية المقحمة في علم الشعر ونقده ونظريته وتاريخه ما يتعلق بصحة البناء لغة من جهة المفردة والرابطة والصيغة وصحة التركيب نحواً. فهذا شرط عربية اللغة، أو فارسية اللغة، أو إنجليزية اللغة .. إلخ. والشعر إنما تصطفي نظريتهُ الظاهرةَ الجمالية في التعبير، لا مقومات الصحة لغوياً . وإذا أراد الشاعر أن يعبر بلغة عربية، فمن شرط إرادته أن يحقق الصفة لشعره بأن يكون عربياً . وإذا كان حقُّ على عربي أن لا يقول غير الشعر عربي فصيح فليس ذلك من مقتضيات خاصية الشعر، وإنما يطلب لذلك مسوغ من غير نظرية الشعر. ومسائل البلاغة عناصر جمالية، وهي تراعي قدرة الشاعر على تحقيق مراده، فإذا كانت إرادته أن يقول شعراً فصيحاً فحينئذ يكون عجزه قبحاً بمقتضى النظرية الشعرية . ومن الأمور الفضولية المقحمة إدخال دلالة الشعر اللغوية والتاريخية والأخلاقية والجغرافية في علم الشعر. فهذا يسرد نصوص الشعر في وصف الطبيعة بالأندلس، وآخر يسرد النصوص ويبوِّبها على أغراض الشعر من مدح وهجاء وغزل.. إلخ، وثالث يستظهر من نماذج الشعر أسماء الأعلام البلدانية أو الأحداث التاريخية، ثم يسمون ذلك نقداً أدبياً، أو دراسات أدبية . وإنما كل ذلك تاريخ، وجغرافيا، وترجمة للشاعر.. وعلاقة الشعر بكل ذلك أن الشعر رافد ومصدر. ولا يدخل في علم الشعر إلا ما رصد ظاهرة جمالية فقننها، أو أرخ لها، أو فلسفها سيكلوجياً رابطاً لها بملكة الإبداع، أو سبرها في المسار الأدبي التاريخي، وذلك هو الأدب المقارن . قال أبو عبيد عبدالرحمن : وحينما أربط الشعر بشرطه الجمالي : فليس معنى ذلك أن فلسفتي الجمالية جزئية، ولا أنها دونية تقنع بمجانية الجمال للتسلية فحسب!. بل الجمال في تجربتي العلمية عطاء علمي وفكري، والحس الجمالي ذو مستويات علواً ودنواً تُرصد في الموضوع بناء على مستويات ذاتية علواً ودنواً أيضاً في التربية والفكر والعلم . وتضمحل مجانية الجمال في الإحساس بمقدار ما يتربى الحس علمياً وفكرياً . ومن أهم عناصر الجمال الدهشة، والإثارة، والقدرة على التغيير باستقطاب الجمهور المتلقي، والجبروت الفكري، والجدة والابتكار، والإيحاء ، والعظمة. إنني لا أدعو إلى الجمالية بتعبير شعبي رخيص، وإنما أعبر عن علم ضخم قائم بذاته هو المعيار الثالث من معايير الوجود التي لا معيار آخر إلا وهو مشتق منها. وكل ذي تجربة علمية عريضة في فن الشعر متناً وعلماً، وكل ذي تطلع إلى مزيد من الكشف والإضافة يؤذيه غاية الإيذاء موقفان غير حميدين : أولهما: موقف من نظر إلى الشعر (نظرة تاريخية محدودة الزمان والمكان محصورة التجربة العلمية) على أنه فن مستقل غاية الاستقلال عن روافد أخرى، وعن فنون شقيقة يرضع معها من لبان واحد . فهو مثلا ينظر إلى موسيقية الشعر وفق النموذج المأثور منذ عهد امرئ القيس إلى عهود الموشحات، ولا ينظر إلى المسار التاريخي للجمال في الفنون الجميلة الأخرى (وهو يحفل بمعطيات جمالية يتجدد بها شباب الشعر، ومتعته فلا يبدو مملاً) . وثانيهما : موقف من تحمس للتجديد بدون تأصيل واحترام لخصوصيات العلوم والفنون التي تميزها . فعلى سبيل المثال : الموسيقية جزء من ماهية الشعر، وليس من الضروري أن تكون تلك الموسيقية هي معهودنا التراثي التاريخي . فسلب الشعر موسيقيته تغيير لهوية الشعر، والخلط بين المتغايرات ليس من لغة العلم، ولا من سلوك عصر يحترم التخصص!. والجمود على المعهود الموسيقي تعطيل للملكة، وانصراف عن مسار جمالي يكتسب منه الشعر وجودة المعتبر. إذن لابد من الانطلاق بالشعر إلى مجاله الجمالي الأرحب المتدفق، لتكون عناصر التجديد للموسيقى في ذاتها عناصر تجديد في الشعر . كان البيت في تراثنا ذا لحن واحد، وكانت القصيدة كلها تكراراً للحن البيت ،لأن الموسيقى كانت كذلك . وصارت الموسيقى هذا اليوم ذات ألحان (كوبليهات)، زكان الموسيقار يتلطف في الانتقال من كوبليه بأنغام تدريجية حتى لا يصدم مشاعر الأذن، فاقتضى الأمر أن تلبي القصيدة هذا المطلب. وقل (1) مثل ذلك عن بقية الفنون الجميلة ذات العلاقة الوشيجة بالشعر. ولقد حدد الأستاذ مجاهد دائرة النقد في مجال ضيق من العمل الفني، وجعل السعة لعالم الجمال.. قال :"العمل الفني عبارة عن ثلاث دوائر متداخلة : الدائرة الأولى الأكبر تضم العناصر التي تجعل هذا العمل الفني بالذات شعراً أو قصة أو رسماً.. إلخ كالإيقاع أو اللون مثلاً. والدائرة الثالثة الأصغر تضم العناصر الأسلوبية والخصائص المميزة للأديب أو المفكر مثل الجمل القصيرة غير المترابطة عند هيمنجواي، أو عالم الكابوس كما عند الروائي التشيكي فرانزكافكا. إن الدائرة الأخيرة هي مجال تخصص الناقد الذي يُعنى بالأسلوب الخاص للفنان وقدرته على استخدامه ومدى أصالته. أما الدائرة الأولى فهي مجال تخصص عالم الجمال، لأنه معني بالمسائل العامة والأسس المشتركة للأعمال الفنية، وما الذي يميزها؟ . أما الدائرة الوسطى فهي أرض مشتركة بين عالم الجمال والناقد .. فالأول يستطيع أن يبين الخصائص النوعية للنوع الفني لدى الفنان أو الأديب . إن الناقد مهتم بإصدار الحكم على العمل الفني على حين أن عالم الجمال مهتم بما وراء هذا الحكم من خصائص موجودة في العمل الفني .. الناقد يقف عند حدود ما هو جزئي بينما عالم الجمال مهتم بما هو كلي يُطبَّق على كل الفنون" (2) . قال أبو عبدالرحمن : بل الدائرة الأولى ميدان الناقد في بناء النظرية الأدبية التي يستمد منها أحكامه النقدية . فالدائرة الأولى هي المجال التأصيلي للناقد، والدائرة الثالثة هي المجال التطبيقي للناقد. وعمل عالم الجمال في الدائرة الأولى التأصيل لما هو جميل بإطلاق. وعمل الناقد في الدائرة الأولى التأصيل للجمال الفني فحسب. وليست مهمة الناقد الحكم فحسب .. بل التأصيل، والتفسير التصوري لمدلول النص، والتفسير التعليلي لقدرة الفنان، وجلاء سر الإبداع والجمال في النص. قال أبو عبدالرحمن : وكنت أحس بنشاط في التأليف والبحث، وأنجز العمل، وأنشط لتصحيح التجارب لأولى منه، ثم يدركني العجز والملل من مواصلة التصحيح والتعديل، ويتعلق نشاطي بعمل آخر لا أكرر فيه جهدي .. وبهذا السبب تكدست لدى أسفار تنتظر معاودة التصحيح والتعديل .. بعضها مر عليه أعوام ، وبعضها مر عليه شهور، فاضطررت إلى الاستعانة - بعد الله - بأخوين كريمين ضليعين في لغة العرب، بصيرين بدقائق الرسم الإملائي هما الأستاذان مجاور السكران، وعبدالله بن عبدالعزيز الهدلق .. والأخير شاب وقور من أبناء بلدتي شقراء .. وقد بهرني علم هذا الشاب الصموت بحفظه، ووعيه العلمي المبكِّر، ومتابعته .. وكنت قبله أحسبني في لغة العرب وعلومها ابن بَجدتها وعذيقها المرجَّب !! .. فجلى عني غمة غماء في الإسراع بإنجاز أعمالي، وصحح لي ما ندَّ عن بصري وبصيرتي من إصلاح، وما كنت أجهله أصلاً، وترجح لي أن أعمالي مستقبلاً ستصدر إن شاء الله سليمة الأداء محكمة البناء، وكنت قبل ذلك أعاني كثرة التطبيع فيما نشر من مؤلفاتي مع أوشاب من اللكنة، وأخطاء في الرسم الإملائي .. لا أستثني سوى كتيب صغير أجهدت نفسي في تكرار تصحيحه - وهو كتيب الألوان من كتاب الفصل لابن حزم الذي صدر منذ بضعة عشر عاماً - فخرج كما أهوى بريئاً من العلل. وفي كتابي هذا عن النظرية الشعرية والجمالية أوردت قول أحمد عبدالمعطي حجازي: "كما تمدنا الحضرة الصوفية".. فعلقت بقولي :"هذا التعبير دليل على تغلغل قدسية التصوف في نفوس المثقفين فضلاً عن العامة". ولم أتنبه إلى أعجمية هذا الأسلوب، فكتب أخي الهدلق يقول :"قال العدناني :"ويقولون : فلان لا يملك ديناراً فضلاً عن فَلْس .. والصواب : فلان لا يملك فلساً فضلاً عن دينار، لأن كلمة (فضلاً) تستعمل في موضع يُستبعد فيه الأدنى الذي يجب أن يأتي قبلها، لذا تقع (فضلاً) بين كلامين متغايرين المعنى، وأكثر استعمالها بعد نفي كما يقول القطب الشيرازي. 

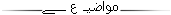
|
|
|
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
|
وعندما نقول : فلان لا يملك كوخاً فضلاً عن قصر: نعني أنه لا يملك كوخاً ولا قصراً، وعدم ملكه للقصر أولى بالانتفاء ، فكأننا قلنا: لا يملك كوخاً فكيف يملك قصراً؟.
قال أبو حيان التوحيدي:"لم أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب من كلام العرب". ولست أرى بأساً باستعمال هذا التركيب،وإن كنت أرى أ، قولنا :"لا يملك فلساً بَلْه ديناراً" أبلغ"(3) . فصحة العبارة إذن :"هذا التعبير دليل على تغلل قدسية التصوف في نفوس العامة فضلاً عن المثقفين .."اهـ. قال أبو عبدالرحمن : وحرصت أن أتمحل لتعبيري بوجه يخرجه من اللكنة حفظاً لسمعتي العلمية، ولكنني وجدت العبارة فاسدة على كل تقدير، وليس العيب أن الأدنى لم يرد قبلها لننفي الأعلى الذي يأتي بعدها، فنقول كما قال العدناني :" لست أرى بأساً باستعمال هذا التركيب" . وليس الخلل في كون هذا التركيب لم يسمع من العرب ، فقد برهنت في مباحثي أن التركيب عمل عقلي لا نقلي يشترط سماعة، وإنما المشترط صحة المفردة لغة، وصحة التركيب نحواً وبلاغة .. ولو كان وجه الخلل ذلك، لأخذنا استقراء أبي حيان على البال . وإنما الخلل في كون كلمة "فضلاً" لا تنتج لغةً هذا المعنى الذي فهموه من هذا التركيب الأعجمي .. أي لا تنتج نفي الأعلى الذي بعدها، فقد استقرأت معانيها في المعجم، فلم أجد من بينها هذا النفي.. لهذا أعتبر هذا التركيب عامياً لا يليق بالفصحاء، ولهذا أيضاً ألغيت عبارتي في التعليق على حجازي، ووضعت بديلاً خيراً منها. ولقد بيَّن ابن فارس أن الأصل في مادة الفاء والضاد واللام زيادة في شئ (4) . وقال الراغب :"الفضل. الزيادة عن الاقتصار، وذلك ضربان : محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه.. والفضل في المحمود أكثر استعمالاً، والفضول في المذموم. والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات. وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان .. وعلى هذا النحو قوله: "ولقد كرمنا بني آدم" (سورة الإسراء/70) إلى قوله: "تفضيلاً". وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر .. فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه، وأن يستفيد الفضل كالفرس والحمار .. لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص بها الإنسان .. والفضل الثالث قد يكون عرضياً فيوجد السبيل على اكتسابه، ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله :"والله فضل بعضكم على بعض في الرزق" (سورة النحل/71)، "لتتبتغوا فضلاً من ربكم" (سورة الإسراء /12).. يعني : المال وما يكتسب" (5) . -قال أبو عبدالرحمن : الأصل في المادة الزيادة المحمودة، ولهذا أُخذ من المادة الوصف للمدح كفاضل، والتسمية للتيمن كالفاضل، ثم توسع بها لكل زيادة وإن كانت غير محمودة . والبقية تسمى فضلة وهي الأقل، وإنما روعي في تسميتها أنها بقيتْ زيادةً عن الحاجة . ونقل الزبيدي عن التوقيف للمناوي أن الفضل ابتداء إحسان بلاغة (6) . قال أبو عبدالرحمن هذا الاصطلاح مبني على الحقيقة اللغوية، إذ الأصل الزيادة المحمودة.. وما زاج عن حاجة الكريم يصدق به، فسمى فضلاً، لأنه زيادة ، ولأنه زيادة ممدوحة. وقال الزبيدي :"والفضولي بالضم المشتغل بما لا يعنيه .. وقال الراغب: الفضول جمع الفضل .. وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل : فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه، لأنه جعل علماً على نوع من الكلام فنزِّل منزلة المفرد .. والفضولي في عرف الفقهاء من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي؟ .. وزاد الصاغاني : وفتح الفاء منه خطأ"(7). قال أبو عبدالرحمن : تلخص من معاني فضل دورانها على الزيادة، والبقية. وقولهم :"فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار": لا ينطبق على معنى فضل لغة، لأنك إن جعلت فضلاً بمعنى الزيادة كان المعنى : فلان لا يملك درهماً زيادة عن دينار. وليس معنى الجملة نفي ملكه للدرهم والدينار معاً، بل المراد نفي ملكه للدرهم تنصيصاً، ونفي ملكه للدرهم والدينار معاً، بل المراد نفي ملكه للدرهم تنصيصاً، ونفي ملكه للدينار بالأولوية . وإن جعلت فضلاً بمعنى البقية كان المعنى : فلان لا يملك درهماً بقية عن دينار. وليس معنى الجملة نفي ملكه للدرهم . وبعد هذا فلا معنى لكون الدرهم بقية عن دينار، لأن الدرهم جزء من الدينار، ولا يوصف بالبقية إلا في سياق خاص، كأن يكون في جراب دينارُ مصروفاً دراهم، فتجد في الجراب درهماً، فيقال لك : هذا بقية الدينار . قال أبو عبدالرحمن : وبعد هذا التحرير - خلال رحلتي لتونس في الأسبوع الأخير من شعبان عام 1417هـ ، وجدت رسالة خطية لابن هشام بدار الكتب الوطنية التونسية برقم 2636 أجاب فيها على أسئلة نحوية أولها إعراب "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار" (8) وقال في هذه الرسالة :"وهذا التركيب زعم بعضهم أنه مسموع، وأنشد عليه: "فلا يبقى على هذا الغلق * * * صخرة صماء فضلاً عن رمق" ثم قال :"وانتصاب فضلاً على وجهين محكيين عن الفارسي: أحدهما : أن يكون مصدراً لفعل محذوف، وذلك الفعل نعت للنكرة . والثاني : أن يكون حالاً من معمول الفعل المذكر". ، ثم قال "يقال : فضل عنه، وعليه. بمعنى زاد. فإن قدرته مصدراً فالتقدير : لا يملك درهماً يفضل فضلاً عن دينار. وذلك الفعل المحذوف صفة، بل يجوز أن يكون حالاً". ثم ذكر أن وجه الصفة أقوى ، لأن نعت النكرة يكون أقيس .وإن قدرته حالاً فصاحبها يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ضمير المصدر محذوفاً (9) أي لا يملكه الملك . الثاني : أن يكون درهماً حالاً . وسوغ مجيء الحال من النكرة أنها في سياق النفي، فخرجت النكرة من حيز الإبهام إلى حيز العموم، وسوغه أيضاً ضعف مجيء الوصف هاهنا . ثم قال : فإن قلت :"هلا أجاز الفارسي في "فضلاً " كونه صفة لدرهم :قلت : زعم أبو حيان أن ذلك لا يجوز، لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أُريدت المبالغة". ثم رد على أبي حيان وناقشه، ثم حكم أن تنزيل وجوه الإعراب تلك على المعنى المراد عسر، ثم قال :"والذي يظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال : إنه في الأصل جملتان مستقلتان، ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيُرُ حصل الإشكال بسببه. وتوجيه ذلك أ، يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جواباً لمستخبر (10) قال : أيملك فلان درهماً؟! . أو رداً على مخبر :قال : فلان يملك ديناراً. فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهماً. ثم استؤنف كلام آخر . ولك في تقديره وجهان: أحدهما : أن يقدر : أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار استفهمت عنه - أو زيادة عن دينار أخبرتَ بملكك له. ثم حذفت جملة "أخبرتك بهذا"، وبفي معموله وهو فضلاً" . والثاني : أن يقدر فضل انتقاء الدرهم عن فلان على انتقاء الدينار عنه. ومعنى ذلك أن يكون حالة هذا المذكور في الفقرة معروفة عند الناس . والفقير إنما يُنفى عنه في العادة ملك الأسياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة(12) ، فوقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه. أي أكثر منه . قال أبو عبدالرحمن : الشاهد أورده ابن هشام بصيغة "زعم" ولم يُعز إلى قائل ،ولم يحُقَّق ثبوته عن العرب، ولعله - إن صح - عن راجز بعد فساد السليقة ، وهو لا يوافق معاني "فضل" في لغة العرب ، وهذا يكفي في رده، لأن المعجم المنقول أثبتُ وأوجبُ مما فيه من دعوى شاهد لم يحقق . وأما إعراب فضلاًُ مصدراً فتقديره : لا يملك درهماً يفضل فضلاً عن دينار . والإعراب يوهم أحد معنيين هما : 1.أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار. أي لا يملك درهماً يفضل عن ملكه ديناراً . ومعنى الجملة : لا يملك درهماً ولا يملك ديناراً من باب أولى . 2.أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار . أي يفضل عن جملة الدينار المكَّون من دراهم. فهو لا يملك جزءاً من دينار . وهذا يحقق بعض معنى الجملة وهو انتقاء ملكه لجزء من دينار وهو الدرهم، ولا يحقق بقية معنى الجملة وهو أنه لا يملك كل الدينار من باب أولى . وهكذا إعرابه حالاً تقديره : لا يملك درهماً حالة كونه فاضلاً عن دينار. وهو يحتمل الاحتمالين المذكورين آنفاً عن الإعراب بالمصدر، ويخالف المعنى المستعمل لجملة "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار" . ووجه المخالفة في كل ذلك أن فضلاً لغة لا تدل على معنى أولوية المنفي في الجملة المذكورة . وأما تقدير ابن هشام على الوجه الأول فيصبح لغة ونحواً ما بقي المقدر ظاهراً، أو ما بقيت الجملة في سياق يشعر بأن المقدر زيادة الخبر أو الإخبار . أما جملة "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار" فالمعنى الذي تستعمل له لا يقتضي تقدير زيادة الخبر أو الاستخبار، وإنما يقتضي نفي الملك للدرهم، ونفي الملك للدينار علي سبيل الأولوية . ودعوى التقدير بهذا الطول - على فرض صحتها - تفسِّر استعمال هذه الجملة بهذا المعنى غير المطابق لمعاني فضل اللغوية، ولا تسوِّغ مشروعية استعمالها، لتغيُّر فضلاً من معنى الزيادة إلى الأولوية . ولو فتح باب دعوى التقدير بمثل هذا - دون برهان - لما ساغ وجود خطأ أو عامية . وأما تقدير ابن هشام الثاني فينجو إلى استعمال فضلاً بمعنى البقية، وهذا صحيح في لغة العرب، والمعنى حينئذ: فلان لا يملك درهمأ ، وهذا المنفي فاضل عن نفي الأكثر وهو الدينار. وهذا المعنى الصحيح لغة لا يكاد يظهر وجهه نحواً، وعلى توجهه فالمنفي إنما هو الأقل الفاضل عن نفي الأكثر. وإنما جاء هذا بدلالة خارجية هو أن الفقير يُنفى عنه الحقير من الأشياء . وهذه الدلالة غير مسلَّمة، لأن الفقير ما كان فقيراً إلا بنفي ما يسد خلته من الضروري لا من الحقير. وعلى التسليم بهذه الدلالة فلا يكون معناها كما قال ابن هشام "وقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه" ، وذلك لسببين : أولهما : أن الناس - في دعوى ابن هشام - نفوا الحقير ولم ينفوا الكثير . فصار نفي الكثير من باب أولى . لا أن الحقير الذي نفوه عقيدةً فاضل عن الكثير الذي لم ينفوه إلا بدلالة العقل بدلالة الأولوية . وثانيهما : ليس نفي ملك الدرهم فاضلاً عن نفْيِ ملك الدينار، لأن من لا يملك الدينار قد يملك الدرهم. وإنما نفْيُ ملكَ الدينار حاصل من نفي ملكية الدرهم . وقد عبَّر عن هذا المعنى بكلمة لا تدل عليه وهي"فضلاً " ومعناها الزيادة أو البقية، وقد استعملت بمعنى الأولوية، وليس ذلك من معانيها. وقلت في كتابي هذا :"وقد يكون الأنين قبيحاً لو صدر من أخن أو ذوي لثغة قبيحة" . فقال أخي الهدلق :"إن الأنين مخرجه حلقي، واللثغة في اللسان. فكيف تؤثر اللثغة القبيحة على أنين الآنِّ وتجعله قبيحاً ؟!". فما كان مني إلا المبادرة إلى تطهير كتابي من هذه الغفلة الصلعاء!. وقال أخي الهدلق :"لقد درج جِلّة المحققين على الإحالة على المعجم بالمادة وليس برقم الصفحة ، لئلا يخفي على القارئ موضع الإحالة لتغيُّر صفحات الكتاب ما بين طبعة وأخرى". قال أبو عبدالرحمن : وقد عصيته في هذه الملاحظة، لأن ذكر الصفحة والجزء ضروري لإثبات الرجوع إلى الطبعة التي يعيِّن المؤلف هُويتها في ثبت مراجعه، ولأن معرفة المادة بدهي يدل عليه السياق ونفس المادة التي هي محل البحث . ومنهجي أن أذكر المادة اللغوية إضافة إلى الصفحة والجزء عندما تكون الإحالة إلى معلومة موجودة في مادة لغوية أخرى ذات علاقة بالمادة محل البحث . وورد في كتابي التعبير بقيمتي الحق والخير، وفني التصوير والنحت، ومفهومي الإحساس والإدراك، وطعمي التفاحة الحمراء والخضراء، ومعنيي الإشعاع والإحراق . وقلت أيضاً :"وهو مذهب المفكر المعاصر أو زبورن في كتابية نظرية الجمال، وعلم الجمال والنقد". وقلت :"إنه تفريق مثلاً بين أساليب طه حسين والزيات وسيد قطب ودريني خشبة، وأساليب الهمذاني والحريري". ولم يرتض لي أخي الهدلق هاته التعبيرات، وهداني إلى ول الدكتور بكر أبو زيد:"لم أقل مصنفي، ولا مسندي، لأن قاعدة العطف (أن العطف) يكون على المضاف لا على المضاف إليه، فكأن السياق : مصنف عبدالرازق ومصنف ابن أبي شيبة . أما لو قلت : "مصنفي عبدالرازق وابن أبي شيبة" فكأنما قيل : مصنفي عبدالرازق ومصنف ابن أبي شيبة . أما لو قلت :"مصطفي عبدالرازق وابن أبي شيبة" فكأنما قيل : مصنفي عبدالرزاق، ومصنفي ابن أبي شيبة ، فتنبه ، وانظر : "قطوف أدبية" لعبدالسلام هارون: (ص/462)"(13). قال أبو عبدالرحمن : وكل ما ذكرته تعبير سليم صحيح على الأصل، وبيان ذلك أنك تقول : ذلك أنك تقول : لابد من التقيد بقيمتي الحق والخير. والمراد قيمةُ الحق معطوفةُ على قيمة الخير . وليس المراد أن للحق قيمتين وأن للخير قيمتين، فيكون التقدير : لابد من التقيد بقيمتي الحق وقيمتي الخير .فتكون القيم أربعاً .وإذا أردت هذا المعنى فلابد أن تظهر المعطوف، فتقول : بقيمتي الحق وقيمتي الخير . وقولك "لابد من التقيد بقيمتي الحق والخير" لا ينصرف فيه الذهن إلى غير قيمتين فحسب واحدة للحق، وأخرى للخير. والبرهان على ذلك ثلاثة أمور : أولها : أن التعبير اصطلاح فلسفي، وقد جرى الاصطلاح على أن الحق في ذاته قيمة .إلا أن الحق أخص، لأن القيم متعددة، فالإضافة لتمييز المضاف مثل حب بر . وليس في العرف الاصطلاحي أن الحق أكثر من قيمة إذا قوبل بالقيمتين الباقيتين وهما الخير والجمال، وإنما يقال : قيم الحق - إذا لم تذكر القيمتان الأخريان - والمراد البراهين والأحكام . وثانيها : أن العطف في الأصل على أقرب مذكور، وأقرب مذكور الحق، فالعطف إذن عطف مضاف إليه على مضاف إليه، فتكون القيمتان مضافتين إلى المضاف والمعطوف عليه معاً. هذا هو الأصل حتى يقوم برهان على خلافة ، وقد أسلفت البرهان على أن خلاف هذا الأصل غير محتمل، فقام لنا برهانان في توجيه الكلام بعطف الخير على الحق : أحدهما برهان الأصل ، وثانيهما برهان امتناع غير الأصل . وثالثهما : أن الأصل عدم التقدير ، فلا يرد احتمال : قيمتي الحق وقيمتي الخير. وأما الاحتجاج بقوله تعالى "على لسان داود وعيسى" حيث أفرد المضاف إلى اثنين ولم يقل :"لساني" فغير وارد هاهنا، ولا يعني أن القاعدة إفراد المضاف بإطلاق، بل يعني خروج هذا المثال على الأصل بناء على أحد الاحتمالين في تفسير الآية الكريمة وفق قاعدة متحققة وهي التخفيف على اللسان مع أمن اللبس وتعيُّن المراد . ويأتي شرح ذلك بعد أسطر إن شاء الله . ولو قيل "لابد من التقيد بقيمة الحق والخير" لتعين أن المراد قيمة واحدة مشتركة . وهكذا تُوجَّه بقية الأمثلة : فني التصوير والنحت ، وأساليب طه والزيات .إلخ . وقولي عن أوزبورن "في كتابيه نظرية الجمال، وعلم الجمال والنقد" أصح من قول "في كتابه نظرية .إلخ" لأن الاحتمال يرد بأن العنوانين اسم كتاب واحد إلا بتقدير : في كتابه نظرية الجمال، وكتابه علم الجمال. وهذا تقدير لغير الظاهر وإلغاء للظاهر، والأولى حمل الكلام على ظاهره ما دام غير ممتنع . والصواب ما أنكره شيخنا العلامة الدكتور بكر أبو زيد، وهو "مصنفي عبدالرازق وابن أبي شيبة" . ولا يجوز مصنف - بالإفراد - إلا إذا كان المصنف من تأليفهما معاً . وما نقله الدكتور إنما هو رأي أنستاس الكرملي الخاطئ، وليس رأي عبدالسلام هارون الصحيح . ودعوى أن القاعدة "العطف على المضاف لا المضاف إليه" يدفعها قاعدة "أن العطف على أقرب مذكور" . وإنما يكون العطف على المضاف عند إظهار المعطوف إذا قلت : قرأت مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة . فتجعل مصنفاً الثانية منصوبة لأنها معطوفة على مصنف الأولى، وأهملت قاعدة العطف على أقرب مذكر، لأن الخبر عن المضاف وليس عن المضاف إليه . أي أن تعلق فعل القراءة بالمضاف . والخلاف هاهنا ليس في عطف مضاف موجود ظاهر ، وإنما الخلاف في تقدير ذلك المضاف مما يترتب عليه إلغاء الظاهر وهو عطف "ابن أبي شيبة" على أقرب مذكور وهو المضاف إليه "عبدالرزاق" . وليس كل الناس يعلم أن عبدالرزاق وابن أبي شيبة - أو غيرهما - لم يشتركا في مصنف واحد، وإنما يعلم ذلك جمهور الخاصة، فلا نلبس على غير العالم ونقول "مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة" ونحن نريد مصنف كل واحد مهما . قال أبو عبدالرحمن : إذن الأصل حمل الكلام على ظاهره، وهو أن كل مفرد أو مثنى أو جمع أحيل إلى مفرد أو مثنى أو جمع فظاهره أن المضاف للمضاف إليه إذا كان واحداً، وأنه مشترك إذا كان المضاف إليه أكثر من واحد. ويرد في كلام العرب خلاف هذا الأصل من أجل سنة العرب في طلب السهولة على اللسان في النطق . وتحقيق هذا المطلب مشروطاً بأمن اللبس . أي تعيُّن المراد بغير احتمال معتبر ومن هنا أسوق تحقيق العلماء لنماذج ممَّا خرج عن الظاهر، وكان أرجح من الظاهر للخفة وأمن اللبس مبيدأ بكلام أنستاس الكرملي الذي فنده الأستاذ عبدالسلام هارون . قال أبو عبدالرحمن : كان أنستاس الكرملي يتعقب تعبيرات لعبدالسلام منها عبارته "معجمي استينجاس وريتشارد سن" فيقول "وهذا تعبير مولد لا تعرفه لغة القرآن، وقد أولع به المعاصرون، واستعمله صاحب تاج العروس والمصباح وغيرهما من اللغويين في إيراد شروحهم لبعض الكلم . ولو فكروا قليلاً لعدلوا عنه ، لأن معناه أن لاستينجاس معجمين ولريتشاردسن أيضاً . معجمين، إذ قد يكون للمؤلف الواحد تأليفان (14) . فالعطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه (15) ، فكأنك تقول : معجمي استينجاس ومعجمي ريتشاردسن . والصواب معجم استينجاس وريتشارسن" (16) . ثم رد عبدالسلام على أنستناس بقوله : ليت شعري كيف نفرق بين وجهي هذه العبارة - التي جعلتها الصواب- إذا أريد بها مرة أن لكل واحد من الشخصين معجماً خاصاً، وأريد بها مرة أخرى أن الشخصين اشتركا في وضع معجم واحد ؟. وقد أشرت إلى لغة القرآن ، ولعلك تعني ما جاء في قوله تعالى "على لسان داود وعيسى بن مريم" حيث أفرد (لسان) . وهذه مسألة خلافية بعيدة عن مسألتنا، وهي مسألة الإضافة إلى متضمنين مفرقين (17) باعتبار أن اللسان جزء من داود وعيسي عليهما السلام، وانظر تفصيلهما والخلاف فيها في همع الهوامع (1/51) في نهاية باب الجمع(18). أما مسألتنا هذه فهي إضافة ما ليس جزءاً مما أضيف إليه، فكلمة (معجم) ليست جزءاً من أحد الشخصين . ومذهب البصريين فيها أن ما ورد على خلاف الأصل - وهو المطابقة - فمسموع، وقاسه الكوفيون . أما ابن مالك فقاسه إذا أُمن اللبس . واللبس في مسألتنا هذه غير مأمون كما أسلفت. فما ذهبتُ إليه في عبارتي هو الأرجح الأصوب عند النحاة"(19). قال أبو عبدالرحمن : إذن إحالة المتع من عبارة "معجمي" إلى عبدالسلام من التقميش السريع . وقبل تحقيق هذه المسألة أحب إيراد شئ من كلام المعربين للآية من سورة المائدة، وشيء من نصوص همع الهوامع . فأما الآية الكريمة فقد تكلم عن تأويلها السمين بقولة "وجاء قوله"على لسان" بالإفراد دون التثنية والجمع، فلم يقل : على لساني، ولا على ألسنة، لقاعدة كلية ، وهي : أن كل جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أُضيفا إلى كليهما من غير تفريق جازَ فيهما ثلاثة أوجهٍ: لفظُ الجمع - وهو المختار - ويليه التثنية عند بعضهم ، وعند بعضهم الإفراد مقدم على التثنية ، فيقال : قطعت رؤوس الكبشين . ومنه "فقد صفت قلوبكما" . فقولي "جزأين" تحرز من شيئين ليسا بجزأين نحو درهميكما ، وقد جاء من بيوتكما وعمائمكما وأسيافكما لأمن اللبس. وبقولي "مفردين" تحرز من نحو العينين واليدين . فأما قوله تعالى "فاقطعوا أيديهما" ففهم بالإجماع . وبقولي "من غير تفريق" تحرز من نحو قطعت رأس الكبشين : السمين والكبش الهزيل، ومنه هذه الآية فلا يجوز إلا الإفراد . وقال بعضهم : هو مختار . أي فيجوز غيره، وقد مضى تحقيق هذه القاعدة في سورة المائدة بكلام طوسل فعليك بالالتفات إليه" (20) .
|
|
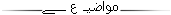
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||