
 |
 |
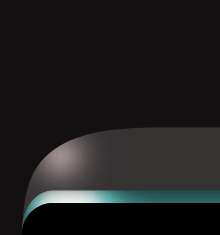 |
|
|
|
|
||||||||
 |
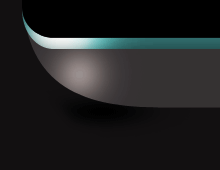 |
| …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… { .. كل ماهو جديد للشعراء والشاعرات من مقروء و مسموع وتمنع الردود .. } |
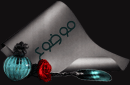
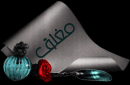 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
 |
ابي عبد الرحمن بن عقيل
مبادئ فى نظريةالشعروالجمال لأبي عبد الرحمن بن عقيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أولاً : من هو الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى؟ قال شيخنا عبد العزيز الحنوط حفظه الله : أما عن شيحنا أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ فقد كان في العلم بحراً لا تكدِّره الدِّلاء ، وله لَسَنٌ وبلاغة وبصر في الحديث ورجاله ،وعربية مُتقنةٌ ، وباعٌ مديد في الفقه لا يُجارى فيه ، وكان حجة في التفسير ، وكذا في الأداب والمنطق والشعر والتأريخ والأنساب ، وكان عجيباً في الفهم والذكاء وسعة العلم ، وكان عجباً في إلقاء الدرس ، وكان ذا ذهنٍ ثاقب وحدْسٍ صائبٍ ، عذب المنطق ، كريم الشمائل ، وكامل السُّؤدُد ، لا يَملُّ جليسُه منه ، متواضعاً ذا فضائل جمة ، وتواليف كثيرة تصل إلى مائة عنوان مابين كتاب من عدة مجلدات إلى رسائل صغيرة ، وتتناول هذه المؤلفات مختلف الفنون والمعارف فبعضها في الدين والأدب والتاريخ وبعضها في النقد والشعر والفلسفة وقسم آخر في اللغة والرحلات والأنساب وغير ذلك .والميزة العظيمة لهذا الشيخ الجليل أنه سلفي المنهج لا يتعصب لإمام ولا مذهب إنما الدليل غايته والحق مطلبه ونصرته . ومن أراد أن يتعرف على السيرة الذاتية لشيخنا الجليل فما عليه إلا أن يرجع إلى ماكتبه الشيخ عن نفسه في : 1ـ شيء من التباريح ( سيرةٌ ذاتيةٌ ... وهمومٌ ثقافية ) وقد صدر منه جزءين . 2ـ الحِباءُ من العَيْبَةِ غِبَّ زيارتي لطيبة ولمن يريد ترجمة عن العلامة الكبير أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ فلينظر إلى كتاب : " شَيْخُ الكَتَبَة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري : حياته ، وآثاره ، وما كتب عنه " للدكتور أمين سليمان سيدو. الطبعة الأولى 1425ه 2004م ـ النادي الأدبي بالرياض القسم الأول استفتاح وتوطئة الحمد لله الذي خلق الإنسان .. علمه البيان ..خلق الإنسان من علق وهو الأكرم الذي علم بالقلم .. علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على هادي الأمة، ونبي الرحمة .. معلم الكتاب والحكمة . وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن الشعر فن قائم بذاته وهو فرع من الأنواع الأدبية يشترك معها في كونه تعبيراً فنياً، وله خصوصيته التي تميزه عن بقية الأنواع الأدبية . والسلف يصنفون الشعر في الآداب فحسب، ويشعرون في لفتاتهم النقدية بأنه فن جميل، ويتسع مدى معرفتهم بعلاقته بأحد فروع الفنون الجميلة، وهو فرع الموسيقى . وتطور العلم البشري، واكتسب التصنيف العلمي دقة وتمحيصاً، فأدخلت الأنواع الأدبية - بما فيها الشعر- في الفنون الجميلة. قال أبو عبدالرحمن : وإذن نبدأ بتحليل الشعر في تصنيفه العلمي من الأعم إلى الأخص، فنرى أولاً أنه فن جميل . وفي نفس الوقت نرى أن الشعر في ذاته نص فني، أو نموذج جمالي.. وهذا يقتضي أن يكون له علم خاص به كأي حقل معرفي . وعلم الشعر نقده، ونظريته، وتاريخه، وظواهره الأصولية .. إنه متن لعلم . وبما أن الجمال هو أعم ما يُصنف فيه الشعر: فإن علم الجمال ونظرياته هو أساس قيم الشعر النقدية . ومن أهم هذه العلاقات ما لم تتم هوية الشعر إلا به، وذلك هو المدد الموسيقي للشعر. ومنها ما لا تكمل جماليته بدون واحد منها كالتصوير . إذن يضاف ثانية إلى الشعر (النقد، والنظرية) عناصر نقدية من خصوصيات الفنون الجميلة كالموسيقى والتصوير.. وكل ذلك أخص من علم الجمال المتعلق بفلسفة الإحساس بالجمال، وسيكولوجيته، ورسم خصائصه في الذات والموضوع. ثم ننظر إلى الشعر ثالثة فنراه جمالاً تعبيرياً كلامياً، فنسبر من نماذجه ونماذج الفنون التعبيرية الكلامية الجميلة الأخرى ما يشارك فيه غيره من خصائص جمالية لنحقق الجمال الشعري الأخص. وحينئذ نسترفد اللغة في متونها وعلومها، ونسترفد البلاغة في علومها ونماذجها لبناء نظرية الشعر - بخاصيته - ونقده . إذن الغرض من استرفاد متون وعلوم التعبير الكلامي أن نستخلص علم ما هو جميل من الكلام، لنميز خاصية الجمال الكلامي عن بقية الفنون الجميلة، لأننا نسبر فناً من الفنون الجميلة . والذي يحكم لنا بجمال ما نستخلصه من متون التعبير الكلامي وعلومه هو ما لدينا من نظريات وأصول علم الجمال، وعلوم الفنون الجميلة . قال أبو عبدالرحمن : وتبقى أمور مقحمة في نظرية الشعر ونقده وعلومة ليست من خاصية الشعر وتصنيفه، فمن ذلك المضمون كأن يكون جميلاً خلقياً أو قبيحاً، وكأن يكون جميلاً منطقياً أو قبيحاً (والمعادل لكل ذلك أن يكون خيراً)، أو شراً، أو حقاً، أو باطلاً) .. فهذه أمور تتعلق بسلوك الفكر، وسلوك الجوارح .. وهذان السلوكان هما مضمون الشعر، وليسا شرط وجوده . وبيان ذلك بالإلماح إلى ظاهرتين : أولاهما : أن للغة العربية حقيقة، وهي أن تكون محفوظة عن العرب وقت السليقة، وأن ترتبط بمعناها المأثور، وتسميها حينئذ لغة عربية . ثم تسمع كلمة أخرى مرتبطة بمعناها، ولكنها ليست محفوظة عن العرب، وهي مما حدث بعد السليقة، وليست جارية على أصول الفصحى، فتحكم بأنها غير عربية، وبأنها عامية أو أعجمية. ثم تركب الكلمات العربية المأثورة معبراً وداعياً إلى قبح من شر أو باطل، فتظل المفردة عربية، ويظل التركيب عربياً، لأن المضمون الجميل أو القبيح ليس شرط التمييز بالعربية، وتحقيق ماهية اللغة العربية . وهكذا الشعر ومضمونة .. يظل فسق أبي نواس في فنه الشعري شعراً، لأنه حقق مدلولاً ما هو جميل في التعبير الكلامي وفق أصول مأخوذة من علم الجمال بعامة، ثم من علوم الفنون الجميلة، ثم من خاصية الجمال في التعبير الكلامي . قال أبو عبدالرحمن : ومعاذ الله أن أكون داعية للباطل والشر والقبح، وإنما أقول : قبح السلوك الفكري والعملي من قيم أخرى خارج دائرة التخصص الشعري يقوم بها المربون والمصلحون، ونبراسهم الدين والأخلاق وعزائم الفكر.. وبغير فن التخصيص الشعري يقولون : أيها الشعراء المدهشون الذين تملكون إبداع النص وظفوا شعركم - باسم المنطق والأخلاق لا باسم التخصيص الشعري - لرسالتكم الحقيقية في الحياة . وهذا النداء متوجه للغة الشعر الخصوصية، وللغة العلم العادية التقريرية المباشرة، وللغة الخطابة التي هي تعبير بين وبين . وأخراهما : أن الشعر ومضمونة غيران، وليسا شيئاً واحداً . وهذه حقيقة تُحرِج من درَّبه بعض معلميه التراثيين مدى عمره الأدبي بأن الشكل والمضمون لا ينفصلان . قال أبو عبدالرحمن : الانفصال متحقق في وجهتين : أولاهما : أن تأخذ مضمون النص الشعرى وتعبر عنه بكلام عادي مباشر لا مسحة فيه من الجمال، فتقول : هذا مضمون واحد عَّبر عنه الشاعر فكان شعراً، وعبرتُ عنه فكان نظماً، فالشكلان مختلفان . وأخراهما : إبقاء المضمون على تعبير الشاعر - وذلك هو الشكل - والتفريق بينهما بالحكم، فتقول : بيت أبي نواس في الخمرة شعر جميل، لأنه عبر عنه بشعر!. وذلك المضمون قبيح، ولكن بغير ملكة الجمال التي تعطي شكل الشعر خاصيته، وإنما ذلك بحكم الدين والأخلاق اللذين يستقبحان هذا السلوك، فهو جمال فكري معنوي، وليس جمالاً تعبيراً . وتوظيف الشعر، وشرف مضمونه رسالة لا تعطيك إياها نظرية الشعر التي من الدين والمنطق خارج دائرة النظرية الشعرية التي يتخصص بها ما هو شعر دون ما هو خلق ودين وحقيقة .. أو عصيان وفجور وإباحية . ولو جاء مدح العفة في نظم عادي لا مسحة فيهمن مسحات الجمال الشعري لكان المضمون جميلاً في الدين والأخلاق، ولكان النص قبيحاً أو بارداً بمفهوم الشعر، أو لكان بارداً لا يثير جمالأ ولا قبيحاً . إذن حقيقة الجمال الشعري مثول القدرة على التعبير الجميل عن أي مضمون جميل أو قبيح. قال أبو عبدالرحمن : والذي أحرج القوم في غياب التصور للفصل بين الشكل والمضمون أنهم يطالبون بتحقيق وجودين منفصلين لنص شعري، فتقول : قال أبو نواس شكلاً منفصلاً عن المضمون !! . وهذا محال بلا ريب، لأن الشاعر حقق مراده بحيله الفني، ولا ينفصل مضمونه عن وسيله أدائه، إلا أن هذه الوحدة غير مؤثرة في محل النزاع . وإنما محل النزاع القدرة على التعبير الجميل عن مضمون جميل أو قبيح، وهذا متحقق بالجهتين اللتين ذكرتهما آنفاً. فالشعر قدرة على الأداء الجميل لأي مضمون . والمضمون إرادة سلوكية فحسب تكون بالشعر وبالكلام العادي . والتفريق بين المضمون والشكل تفريق لغوي، وتفريق تجربة بشرية .. إنه تفريق مثلاً بين أساليب طه حسين والزيات وسيد قطب ودريني خشبة وأساليب الهمذاني والحريري وكتاب عصور البديع المتكلف لو تناولوا كلهم مضموناً واحداً.. إذن المضمون الواحد قابل التعبير به أكثر من شكل . أما أنهما لا ينفصلان إذا اجتمعا فتلك قضية أخرى لا تمنع من قدرة الأديب في البداية -قبل الجمع بينهما- من اختيار الأسلوب الذي يريده للمضمون الذي أراده. ألا ترى أن زيداً من الناس لا ينفصل لحظة من الزمن منذ وجد من كونه حياً أو ميتاً بالتعبير الحقيقي لا المجازي .. فهل كون زيد حياً حتماً أو ميتاً حتماً .. لا ينفصل عن الحياة أو الموت .. هل كونه حتماً كذلك يمنع من كون زيد والحياة غيرين، وكون زيد والموت غيرين ؟!. قال أبو عبدالرحمن : ومن الأمور الفضولية المقحمة في علم الشعر ونقده ونظريته وتاريخه ما يتعلق بصحة البناء لغة من جهة المفردة والرابطة والصيغة وصحة التركيب نحواً. فهذا شرط عربية اللغة، أو فارسية اللغة، أو إنجليزية اللغة .. إلخ. والشعر إنما تصطفي نظريتهُ الظاهرةَ الجمالية في التعبير، لا مقومات الصحة لغوياً . وإذا أراد الشاعر أن يعبر بلغة عربية، فمن شرط إرادته أن يحقق الصفة لشعره بأن يكون عربياً . وإذا كان حقُّ على عربي أن لا يقول غير الشعر عربي فصيح فليس ذلك من مقتضيات خاصية الشعر، وإنما يطلب لذلك مسوغ من غير نظرية الشعر. ومسائل البلاغة عناصر جمالية، وهي تراعي قدرة الشاعر على تحقيق مراده، فإذا كانت إرادته أن يقول شعراً فصيحاً فحينئذ يكون عجزه قبحاً بمقتضى النظرية الشعرية . ومن الأمور الفضولية المقحمة إدخال دلالة الشعر اللغوية والتاريخية والأخلاقية والجغرافية في علم الشعر. فهذا يسرد نصوص الشعر في وصف الطبيعة بالأندلس، وآخر يسرد النصوص ويبوِّبها على أغراض الشعر من مدح وهجاء وغزل.. إلخ، وثالث يستظهر من نماذج الشعر أسماء الأعلام البلدانية أو الأحداث التاريخية، ثم يسمون ذلك نقداً أدبياً، أو دراسات أدبية . وإنما كل ذلك تاريخ، وجغرافيا، وترجمة للشاعر.. وعلاقة الشعر بكل ذلك أن الشعر رافد ومصدر. ولا يدخل في علم الشعر إلا ما رصد ظاهرة جمالية فقننها، أو أرخ لها، أو فلسفها سيكلوجياً رابطاً لها بملكة الإبداع، أو سبرها في المسار الأدبي التاريخي، وذلك هو الأدب المقارن . قال أبو عبيد عبدالرحمن : وحينما أربط الشعر بشرطه الجمالي : فليس معنى ذلك أن فلسفتي الجمالية جزئية، ولا أنها دونية تقنع بمجانية الجمال للتسلية فحسب!. بل الجمال في تجربتي العلمية عطاء علمي وفكري، والحس الجمالي ذو مستويات علواً ودنواً تُرصد في الموضوع بناء على مستويات ذاتية علواً ودنواً أيضاً في التربية والفكر والعلم . وتضمحل مجانية الجمال في الإحساس بمقدار ما يتربى الحس علمياً وفكرياً . ومن أهم عناصر الجمال الدهشة، والإثارة، والقدرة على التغيير باستقطاب الجمهور المتلقي، والجبروت الفكري، والجدة والابتكار، والإيحاء ، والعظمة. إنني لا أدعو إلى الجمالية بتعبير شعبي رخيص، وإنما أعبر عن علم ضخم قائم بذاته هو المعيار الثالث من معايير الوجود التي لا معيار آخر إلا وهو مشتق منها. وكل ذي تجربة علمية عريضة في فن الشعر متناً وعلماً، وكل ذي تطلع إلى مزيد من الكشف والإضافة يؤذيه غاية الإيذاء موقفان غير حميدين : أولهما: موقف من نظر إلى الشعر (نظرة تاريخية محدودة الزمان والمكان محصورة التجربة العلمية) على أنه فن مستقل غاية الاستقلال عن روافد أخرى، وعن فنون شقيقة يرضع معها من لبان واحد . فهو مثلا ينظر إلى موسيقية الشعر وفق النموذج المأثور منذ عهد امرئ القيس إلى عهود الموشحات، ولا ينظر إلى المسار التاريخي للجمال في الفنون الجميلة الأخرى (وهو يحفل بمعطيات جمالية يتجدد بها شباب الشعر، ومتعته فلا يبدو مملاً) . وثانيهما : موقف من تحمس للتجديد بدون تأصيل واحترام لخصوصيات العلوم والفنون التي تميزها . فعلى سبيل المثال : الموسيقية جزء من ماهية الشعر، وليس من الضروري أن تكون تلك الموسيقية هي معهودنا التراثي التاريخي . فسلب الشعر موسيقيته تغيير لهوية الشعر، والخلط بين المتغايرات ليس من لغة العلم، ولا من سلوك عصر يحترم التخصص!. والجمود على المعهود الموسيقي تعطيل للملكة، وانصراف عن مسار جمالي يكتسب منه الشعر وجودة المعتبر. إذن لابد من الانطلاق بالشعر إلى مجاله الجمالي الأرحب المتدفق، لتكون عناصر التجديد للموسيقى في ذاتها عناصر تجديد في الشعر . كان البيت في تراثنا ذا لحن واحد، وكانت القصيدة كلها تكراراً للحن البيت ،لأن الموسيقى كانت كذلك . وصارت الموسيقى هذا اليوم ذات ألحان (كوبليهات)، زكان الموسيقار يتلطف في الانتقال من كوبليه بأنغام تدريجية حتى لا يصدم مشاعر الأذن، فاقتضى الأمر أن تلبي القصيدة هذا المطلب. وقل (1) مثل ذلك عن بقية الفنون الجميلة ذات العلاقة الوشيجة بالشعر. ولقد حدد الأستاذ مجاهد دائرة النقد في مجال ضيق من العمل الفني، وجعل السعة لعالم الجمال.. قال :"العمل الفني عبارة عن ثلاث دوائر متداخلة : الدائرة الأولى الأكبر تضم العناصر التي تجعل هذا العمل الفني بالذات شعراً أو قصة أو رسماً.. إلخ كالإيقاع أو اللون مثلاً. والدائرة الثالثة الأصغر تضم العناصر الأسلوبية والخصائص المميزة للأديب أو المفكر مثل الجمل القصيرة غير المترابطة عند هيمنجواي، أو عالم الكابوس كما عند الروائي التشيكي فرانزكافكا. إن الدائرة الأخيرة هي مجال تخصص الناقد الذي يُعنى بالأسلوب الخاص للفنان وقدرته على استخدامه ومدى أصالته. أما الدائرة الأولى فهي مجال تخصص عالم الجمال، لأنه معني بالمسائل العامة والأسس المشتركة للأعمال الفنية، وما الذي يميزها؟ . أما الدائرة الوسطى فهي أرض مشتركة بين عالم الجمال والناقد .. فالأول يستطيع أن يبين الخصائص النوعية للنوع الفني لدى الفنان أو الأديب . إن الناقد مهتم بإصدار الحكم على العمل الفني على حين أن عالم الجمال مهتم بما وراء هذا الحكم من خصائص موجودة في العمل الفني .. الناقد يقف عند حدود ما هو جزئي بينما عالم الجمال مهتم بما هو كلي يُطبَّق على كل الفنون" (2) . قال أبو عبدالرحمن : بل الدائرة الأولى ميدان الناقد في بناء النظرية الأدبية التي يستمد منها أحكامه النقدية . فالدائرة الأولى هي المجال التأصيلي للناقد، والدائرة الثالثة هي المجال التطبيقي للناقد. وعمل عالم الجمال في الدائرة الأولى التأصيل لما هو جميل بإطلاق. وعمل الناقد في الدائرة الأولى التأصيل للجمال الفني فحسب. وليست مهمة الناقد الحكم فحسب .. بل التأصيل، والتفسير التصوري لمدلول النص، والتفسير التعليلي لقدرة الفنان، وجلاء سر الإبداع والجمال في النص. قال أبو عبدالرحمن : وكنت أحس بنشاط في التأليف والبحث، وأنجز العمل، وأنشط لتصحيح التجارب لأولى منه، ثم يدركني العجز والملل من مواصلة التصحيح والتعديل، ويتعلق نشاطي بعمل آخر لا أكرر فيه جهدي .. وبهذا السبب تكدست لدى أسفار تنتظر معاودة التصحيح والتعديل .. بعضها مر عليه أعوام ، وبعضها مر عليه شهور، فاضطررت إلى الاستعانة - بعد الله - بأخوين كريمين ضليعين في لغة العرب، بصيرين بدقائق الرسم الإملائي هما الأستاذان مجاور السكران، وعبدالله بن عبدالعزيز الهدلق .. والأخير شاب وقور من أبناء بلدتي شقراء .. وقد بهرني علم هذا الشاب الصموت بحفظه، ووعيه العلمي المبكِّر، ومتابعته .. وكنت قبله أحسبني في لغة العرب وعلومها ابن بَجدتها وعذيقها المرجَّب !! .. فجلى عني غمة غماء في الإسراع بإنجاز أعمالي، وصحح لي ما ندَّ عن بصري وبصيرتي من إصلاح، وما كنت أجهله أصلاً، وترجح لي أن أعمالي مستقبلاً ستصدر إن شاء الله سليمة الأداء محكمة البناء، وكنت قبل ذلك أعاني كثرة التطبيع فيما نشر من مؤلفاتي مع أوشاب من اللكنة، وأخطاء في الرسم الإملائي .. لا أستثني سوى كتيب صغير أجهدت نفسي في تكرار تصحيحه - وهو كتيب الألوان من كتاب الفصل لابن حزم الذي صدر منذ بضعة عشر عاماً - فخرج كما أهوى بريئاً من العلل. وفي كتابي هذا عن النظرية الشعرية والجمالية أوردت قول أحمد عبدالمعطي حجازي: "كما تمدنا الحضرة الصوفية".. فعلقت بقولي :"هذا التعبير دليل على تغلغل قدسية التصوف في نفوس المثقفين فضلاً عن العامة". ولم أتنبه إلى أعجمية هذا الأسلوب، فكتب أخي الهدلق يقول :"قال العدناني :"ويقولون : فلان لا يملك ديناراً فضلاً عن فَلْس .. والصواب : فلان لا يملك فلساً فضلاً عن دينار، لأن كلمة (فضلاً) تستعمل في موضع يُستبعد فيه الأدنى الذي يجب أن يأتي قبلها، لذا تقع (فضلاً) بين كلامين متغايرين المعنى، وأكثر استعمالها بعد نفي كما يقول القطب الشيرازي. |
|
|
#2 |
 |
وعندما نقول : فلان لا يملك كوخاً فضلاً عن قصر: نعني أنه لا يملك كوخاً ولا قصراً، وعدم ملكه للقصر أولى بالانتفاء ، فكأننا قلنا: لا يملك كوخاً فكيف يملك قصراً؟. قال أبو حيان التوحيدي:"لم أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب من كلام العرب". ولست أرى بأساً باستعمال هذا التركيب،وإن كنت أرى أ، قولنا :"لا يملك فلساً بَلْه ديناراً" أبلغ"(3) . فصحة العبارة إذن :"هذا التعبير دليل على تغلل قدسية التصوف في نفوس العامة فضلاً عن المثقفين .."اهـ. قال أبو عبدالرحمن : وحرصت أن أتمحل لتعبيري بوجه يخرجه من اللكنة حفظاً لسمعتي العلمية، ولكنني وجدت العبارة فاسدة على كل تقدير، وليس العيب أن الأدنى لم يرد قبلها لننفي الأعلى الذي يأتي بعدها، فنقول كما قال العدناني :" لست أرى بأساً باستعمال هذا التركيب" . وليس الخلل في كون هذا التركيب لم يسمع من العرب ، فقد برهنت في مباحثي أن التركيب عمل عقلي لا نقلي يشترط سماعة، وإنما المشترط صحة المفردة لغة، وصحة التركيب نحواً وبلاغة .. ولو كان وجه الخلل ذلك، لأخذنا استقراء أبي حيان على البال . وإنما الخلل في كون كلمة "فضلاً" لا تنتج لغةً هذا المعنى الذي فهموه من هذا التركيب الأعجمي .. أي لا تنتج نفي الأعلى الذي بعدها، فقد استقرأت معانيها في المعجم، فلم أجد من بينها هذا النفي.. لهذا أعتبر هذا التركيب عامياً لا يليق بالفصحاء، ولهذا أيضاً ألغيت عبارتي في التعليق على حجازي، ووضعت بديلاً خيراً منها. ولقد بيَّن ابن فارس أن الأصل في مادة الفاء والضاد واللام زيادة في شئ (4) . وقال الراغب :"الفضل. الزيادة عن الاقتصار، وذلك ضربان : محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه.. والفضل في المحمود أكثر استعمالاً، والفضول في المذموم. والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات. وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان .. وعلى هذا النحو قوله: "ولقد كرمنا بني آدم" (سورة الإسراء/70) إلى قوله: "تفضيلاً". وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر .. فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه، وأن يستفيد الفضل كالفرس والحمار .. لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص بها الإنسان .. والفضل الثالث قد يكون عرضياً فيوجد السبيل على اكتسابه، ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله :"والله فضل بعضكم على بعض في الرزق" (سورة النحل/71)، "لتتبتغوا فضلاً من ربكم" (سورة الإسراء /12).. يعني : المال وما يكتسب" (5) . -قال أبو عبدالرحمن : الأصل في المادة الزيادة المحمودة، ولهذا أُخذ من المادة الوصف للمدح كفاضل، والتسمية للتيمن كالفاضل، ثم توسع بها لكل زيادة وإن كانت غير محمودة . والبقية تسمى فضلة وهي الأقل، وإنما روعي في تسميتها أنها بقيتْ زيادةً عن الحاجة . ونقل الزبيدي عن التوقيف للمناوي أن الفضل ابتداء إحسان بلاغة (6) . قال أبو عبدالرحمن هذا الاصطلاح مبني على الحقيقة اللغوية، إذ الأصل الزيادة المحمودة.. وما زاج عن حاجة الكريم يصدق به، فسمى فضلاً، لأنه زيادة ، ولأنه زيادة ممدوحة. وقال الزبيدي :"والفضولي بالضم المشتغل بما لا يعنيه .. وقال الراغب: الفضول جمع الفضل .. وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل : فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه، لأنه جعل علماً على نوع من الكلام فنزِّل منزلة المفرد .. والفضولي في عرف الفقهاء من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي؟ .. وزاد الصاغاني : وفتح الفاء منه خطأ"(7). قال أبو عبدالرحمن : تلخص من معاني فضل دورانها على الزيادة، والبقية. وقولهم :"فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار": لا ينطبق على معنى فضل لغة، لأنك إن جعلت فضلاً بمعنى الزيادة كان المعنى : فلان لا يملك درهماً زيادة عن دينار. وليس معنى الجملة نفي ملكه للدرهم والدينار معاً، بل المراد نفي ملكه للدرهم تنصيصاً، ونفي ملكه للدرهم والدينار معاً، بل المراد نفي ملكه للدرهم تنصيصاً، ونفي ملكه للدينار بالأولوية . وإن جعلت فضلاً بمعنى البقية كان المعنى : فلان لا يملك درهماً بقية عن دينار. وليس معنى الجملة نفي ملكه للدرهم . وبعد هذا فلا معنى لكون الدرهم بقية عن دينار، لأن الدرهم جزء من الدينار، ولا يوصف بالبقية إلا في سياق خاص، كأن يكون في جراب دينارُ مصروفاً دراهم، فتجد في الجراب درهماً، فيقال لك : هذا بقية الدينار . قال أبو عبدالرحمن : وبعد هذا التحرير - خلال رحلتي لتونس في الأسبوع الأخير من شعبان عام 1417هـ ، وجدت رسالة خطية لابن هشام بدار الكتب الوطنية التونسية برقم 2636 أجاب فيها على أسئلة نحوية أولها إعراب "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار" (8) وقال في هذه الرسالة :"وهذا التركيب زعم بعضهم أنه مسموع، وأنشد عليه: "فلا يبقى على هذا الغلق * * * صخرة صماء فضلاً عن رمق" ثم قال :"وانتصاب فضلاً على وجهين محكيين عن الفارسي: أحدهما : أن يكون مصدراً لفعل محذوف، وذلك الفعل نعت للنكرة . والثاني : أن يكون حالاً من معمول الفعل المذكر". ، ثم قال "يقال : فضل عنه، وعليه. بمعنى زاد. فإن قدرته مصدراً فالتقدير : لا يملك درهماً يفضل فضلاً عن دينار. وذلك الفعل المحذوف صفة، بل يجوز أن يكون حالاً". ثم ذكر أن وجه الصفة أقوى ، لأن نعت النكرة يكون أقيس .وإن قدرته حالاً فصاحبها يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ضمير المصدر محذوفاً (9) أي لا يملكه الملك . الثاني : أن يكون درهماً حالاً . وسوغ مجيء الحال من النكرة أنها في سياق النفي، فخرجت النكرة من حيز الإبهام إلى حيز العموم، وسوغه أيضاً ضعف مجيء الوصف هاهنا . ثم قال : فإن قلت :"هلا أجاز الفارسي في "فضلاً " كونه صفة لدرهم :قلت : زعم أبو حيان أن ذلك لا يجوز، لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أُريدت المبالغة". ثم رد على أبي حيان وناقشه، ثم حكم أن تنزيل وجوه الإعراب تلك على المعنى المراد عسر، ثم قال :"والذي يظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال : إنه في الأصل جملتان مستقلتان، ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيُرُ حصل الإشكال بسببه. وتوجيه ذلك أ، يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جواباً لمستخبر (10) قال : أيملك فلان درهماً؟! . أو رداً على مخبر :قال : فلان يملك ديناراً. فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهماً. ثم استؤنف كلام آخر . ولك في تقديره وجهان: أحدهما : أن يقدر : أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار استفهمت عنه - أو زيادة عن دينار أخبرتَ بملكك له. ثم حذفت جملة "أخبرتك بهذا"، وبفي معموله وهو فضلاً" . والثاني : أن يقدر فضل انتقاء الدرهم عن فلان على انتقاء الدينار عنه. ومعنى ذلك أن يكون حالة هذا المذكور في الفقرة معروفة عند الناس . والفقير إنما يُنفى عنه في العادة ملك الأسياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة(12) ، فوقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه. أي أكثر منه . قال أبو عبدالرحمن : الشاهد أورده ابن هشام بصيغة "زعم" ولم يُعز إلى قائل ،ولم يحُقَّق ثبوته عن العرب، ولعله - إن صح - عن راجز بعد فساد السليقة ، وهو لا يوافق معاني "فضل" في لغة العرب ، وهذا يكفي في رده، لأن المعجم المنقول أثبتُ وأوجبُ مما فيه من دعوى شاهد لم يحقق . وأما إعراب فضلاًُ مصدراً فتقديره : لا يملك درهماً يفضل فضلاً عن دينار . والإعراب يوهم أحد معنيين هما : 1.أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار. أي لا يملك درهماً يفضل عن ملكه ديناراً . ومعنى الجملة : لا يملك درهماً ولا يملك ديناراً من باب أولى . 2.أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار . أي يفضل عن جملة الدينار المكَّون من دراهم. فهو لا يملك جزءاً من دينار . وهذا يحقق بعض معنى الجملة وهو انتقاء ملكه لجزء من دينار وهو الدرهم، ولا يحقق بقية معنى الجملة وهو أنه لا يملك كل الدينار من باب أولى . وهكذا إعرابه حالاً تقديره : لا يملك درهماً حالة كونه فاضلاً عن دينار. وهو يحتمل الاحتمالين المذكورين آنفاً عن الإعراب بالمصدر، ويخالف المعنى المستعمل لجملة "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار" . ووجه المخالفة في كل ذلك أن فضلاً لغة لا تدل على معنى أولوية المنفي في الجملة المذكورة . وأما تقدير ابن هشام على الوجه الأول فيصبح لغة ونحواً ما بقي المقدر ظاهراً، أو ما بقيت الجملة في سياق يشعر بأن المقدر زيادة الخبر أو الإخبار . أما جملة "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار" فالمعنى الذي تستعمل له لا يقتضي تقدير زيادة الخبر أو الاستخبار، وإنما يقتضي نفي الملك للدرهم، ونفي الملك للدينار علي سبيل الأولوية . ودعوى التقدير بهذا الطول - على فرض صحتها - تفسِّر استعمال هذه الجملة بهذا المعنى غير المطابق لمعاني فضل اللغوية، ولا تسوِّغ مشروعية استعمالها، لتغيُّر فضلاً من معنى الزيادة إلى الأولوية . ولو فتح باب دعوى التقدير بمثل هذا - دون برهان - لما ساغ وجود خطأ أو عامية . وأما تقدير ابن هشام الثاني فينجو إلى استعمال فضلاً بمعنى البقية، وهذا صحيح في لغة العرب، والمعنى حينئذ: فلان لا يملك درهمأ ، وهذا المنفي فاضل عن نفي الأكثر وهو الدينار. وهذا المعنى الصحيح لغة لا يكاد يظهر وجهه نحواً، وعلى توجهه فالمنفي إنما هو الأقل الفاضل عن نفي الأكثر. وإنما جاء هذا بدلالة خارجية هو أن الفقير يُنفى عنه الحقير من الأشياء . وهذه الدلالة غير مسلَّمة، لأن الفقير ما كان فقيراً إلا بنفي ما يسد خلته من الضروري لا من الحقير. وعلى التسليم بهذه الدلالة فلا يكون معناها كما قال ابن هشام "وقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه" ، وذلك لسببين : أولهما : أن الناس - في دعوى ابن هشام - نفوا الحقير ولم ينفوا الكثير . فصار نفي الكثير من باب أولى . لا أن الحقير الذي نفوه عقيدةً فاضل عن الكثير الذي لم ينفوه إلا بدلالة العقل بدلالة الأولوية . وثانيهما : ليس نفي ملك الدرهم فاضلاً عن نفْيِ ملك الدينار، لأن من لا يملك الدينار قد يملك الدرهم. وإنما نفْيُ ملكَ الدينار حاصل من نفي ملكية الدرهم . وقد عبَّر عن هذا المعنى بكلمة لا تدل عليه وهي"فضلاً " ومعناها الزيادة أو البقية، وقد استعملت بمعنى الأولوية، وليس ذلك من معانيها. وقلت في كتابي هذا :"وقد يكون الأنين قبيحاً لو صدر من أخن أو ذوي لثغة قبيحة" . فقال أخي الهدلق :"إن الأنين مخرجه حلقي، واللثغة في اللسان. فكيف تؤثر اللثغة القبيحة على أنين الآنِّ وتجعله قبيحاً ؟!". فما كان مني إلا المبادرة إلى تطهير كتابي من هذه الغفلة الصلعاء!. وقال أخي الهدلق :"لقد درج جِلّة المحققين على الإحالة على المعجم بالمادة وليس برقم الصفحة ، لئلا يخفي على القارئ موضع الإحالة لتغيُّر صفحات الكتاب ما بين طبعة وأخرى". قال أبو عبدالرحمن : وقد عصيته في هذه الملاحظة، لأن ذكر الصفحة والجزء ضروري لإثبات الرجوع إلى الطبعة التي يعيِّن المؤلف هُويتها في ثبت مراجعه، ولأن معرفة المادة بدهي يدل عليه السياق ونفس المادة التي هي محل البحث . ومنهجي أن أذكر المادة اللغوية إضافة إلى الصفحة والجزء عندما تكون الإحالة إلى معلومة موجودة في مادة لغوية أخرى ذات علاقة بالمادة محل البحث . وورد في كتابي التعبير بقيمتي الحق والخير، وفني التصوير والنحت، ومفهومي الإحساس والإدراك، وطعمي التفاحة الحمراء والخضراء، ومعنيي الإشعاع والإحراق . وقلت أيضاً :"وهو مذهب المفكر المعاصر أو زبورن في كتابية نظرية الجمال، وعلم الجمال والنقد". وقلت :"إنه تفريق مثلاً بين أساليب طه حسين والزيات وسيد قطب ودريني خشبة، وأساليب الهمذاني والحريري". ولم يرتض لي أخي الهدلق هاته التعبيرات، وهداني إلى ول الدكتور بكر أبو زيد:"لم أقل مصنفي، ولا مسندي، لأن قاعدة العطف (أن العطف) يكون على المضاف لا على المضاف إليه، فكأن السياق : مصنف عبدالرازق ومصنف ابن أبي شيبة . أما لو قلت : "مصنفي عبدالرازق وابن أبي شيبة" فكأنما قيل : مصنفي عبدالرازق ومصنف ابن أبي شيبة . أما لو قلت :"مصطفي عبدالرازق وابن أبي شيبة" فكأنما قيل : مصنفي عبدالرزاق، ومصنفي ابن أبي شيبة ، فتنبه ، وانظر : "قطوف أدبية" لعبدالسلام هارون: (ص/462)"(13). قال أبو عبدالرحمن : وكل ما ذكرته تعبير سليم صحيح على الأصل، وبيان ذلك أنك تقول : ذلك أنك تقول : لابد من التقيد بقيمتي الحق والخير. والمراد قيمةُ الحق معطوفةُ على قيمة الخير . وليس المراد أن للحق قيمتين وأن للخير قيمتين، فيكون التقدير : لابد من التقيد بقيمتي الحق وقيمتي الخير .فتكون القيم أربعاً .وإذا أردت هذا المعنى فلابد أن تظهر المعطوف، فتقول : بقيمتي الحق وقيمتي الخير . وقولك "لابد من التقيد بقيمتي الحق والخير" لا ينصرف فيه الذهن إلى غير قيمتين فحسب واحدة للحق، وأخرى للخير. والبرهان على ذلك ثلاثة أمور : أولها : أن التعبير اصطلاح فلسفي، وقد جرى الاصطلاح على أن الحق في ذاته قيمة .إلا أن الحق أخص، لأن القيم متعددة، فالإضافة لتمييز المضاف مثل حب بر . وليس في العرف الاصطلاحي أن الحق أكثر من قيمة إذا قوبل بالقيمتين الباقيتين وهما الخير والجمال، وإنما يقال : قيم الحق - إذا لم تذكر القيمتان الأخريان - والمراد البراهين والأحكام . وثانيها : أن العطف في الأصل على أقرب مذكور، وأقرب مذكور الحق، فالعطف إذن عطف مضاف إليه على مضاف إليه، فتكون القيمتان مضافتين إلى المضاف والمعطوف عليه معاً. هذا هو الأصل حتى يقوم برهان على خلافة ، وقد أسلفت البرهان على أن خلاف هذا الأصل غير محتمل، فقام لنا برهانان في توجيه الكلام بعطف الخير على الحق : أحدهما برهان الأصل ، وثانيهما برهان امتناع غير الأصل . وثالثهما : أن الأصل عدم التقدير ، فلا يرد احتمال : قيمتي الحق وقيمتي الخير. وأما الاحتجاج بقوله تعالى "على لسان داود وعيسى" حيث أفرد المضاف إلى اثنين ولم يقل :"لساني" فغير وارد هاهنا، ولا يعني أن القاعدة إفراد المضاف بإطلاق، بل يعني خروج هذا المثال على الأصل بناء على أحد الاحتمالين في تفسير الآية الكريمة وفق قاعدة متحققة وهي التخفيف على اللسان مع أمن اللبس وتعيُّن المراد . ويأتي شرح ذلك بعد أسطر إن شاء الله . ولو قيل "لابد من التقيد بقيمة الحق والخير" لتعين أن المراد قيمة واحدة مشتركة . وهكذا تُوجَّه بقية الأمثلة : فني التصوير والنحت ، وأساليب طه والزيات .إلخ . وقولي عن أوزبورن "في كتابيه نظرية الجمال، وعلم الجمال والنقد" أصح من قول "في كتابه نظرية .إلخ" لأن الاحتمال يرد بأن العنوانين اسم كتاب واحد إلا بتقدير : في كتابه نظرية الجمال، وكتابه علم الجمال. وهذا تقدير لغير الظاهر وإلغاء للظاهر، والأولى حمل الكلام على ظاهره ما دام غير ممتنع . والصواب ما أنكره شيخنا العلامة الدكتور بكر أبو زيد، وهو "مصنفي عبدالرازق وابن أبي شيبة" . ولا يجوز مصنف - بالإفراد - إلا إذا كان المصنف من تأليفهما معاً . وما نقله الدكتور إنما هو رأي أنستاس الكرملي الخاطئ، وليس رأي عبدالسلام هارون الصحيح . ودعوى أن القاعدة "العطف على المضاف لا المضاف إليه" يدفعها قاعدة "أن العطف على أقرب مذكور" . وإنما يكون العطف على المضاف عند إظهار المعطوف إذا قلت : قرأت مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة . فتجعل مصنفاً الثانية منصوبة لأنها معطوفة على مصنف الأولى، وأهملت قاعدة العطف على أقرب مذكر، لأن الخبر عن المضاف وليس عن المضاف إليه . أي أن تعلق فعل القراءة بالمضاف . والخلاف هاهنا ليس في عطف مضاف موجود ظاهر ، وإنما الخلاف في تقدير ذلك المضاف مما يترتب عليه إلغاء الظاهر وهو عطف "ابن أبي شيبة" على أقرب مذكور وهو المضاف إليه "عبدالرزاق" . وليس كل الناس يعلم أن عبدالرزاق وابن أبي شيبة - أو غيرهما - لم يشتركا في مصنف واحد، وإنما يعلم ذلك جمهور الخاصة، فلا نلبس على غير العالم ونقول "مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة" ونحن نريد مصنف كل واحد مهما . قال أبو عبدالرحمن : إذن الأصل حمل الكلام على ظاهره، وهو أن كل مفرد أو مثنى أو جمع أحيل إلى مفرد أو مثنى أو جمع فظاهره أن المضاف للمضاف إليه إذا كان واحداً، وأنه مشترك إذا كان المضاف إليه أكثر من واحد. ويرد في كلام العرب خلاف هذا الأصل من أجل سنة العرب في طلب السهولة على اللسان في النطق . وتحقيق هذا المطلب مشروطاً بأمن اللبس . أي تعيُّن المراد بغير احتمال معتبر ومن هنا أسوق تحقيق العلماء لنماذج ممَّا خرج عن الظاهر، وكان أرجح من الظاهر للخفة وأمن اللبس مبيدأ بكلام أنستاس الكرملي الذي فنده الأستاذ عبدالسلام هارون . قال أبو عبدالرحمن : كان أنستاس الكرملي يتعقب تعبيرات لعبدالسلام منها عبارته "معجمي استينجاس وريتشارد سن" فيقول "وهذا تعبير مولد لا تعرفه لغة القرآن، وقد أولع به المعاصرون، واستعمله صاحب تاج العروس والمصباح وغيرهما من اللغويين في إيراد شروحهم لبعض الكلم . ولو فكروا قليلاً لعدلوا عنه ، لأن معناه أن لاستينجاس معجمين ولريتشاردسن أيضاً . معجمين، إذ قد يكون للمؤلف الواحد تأليفان (14) . فالعطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه (15) ، فكأنك تقول : معجمي استينجاس ومعجمي ريتشاردسن . والصواب معجم استينجاس وريتشارسن" (16) . ثم رد عبدالسلام على أنستناس بقوله : ليت شعري كيف نفرق بين وجهي هذه العبارة - التي جعلتها الصواب- إذا أريد بها مرة أن لكل واحد من الشخصين معجماً خاصاً، وأريد بها مرة أخرى أن الشخصين اشتركا في وضع معجم واحد ؟. وقد أشرت إلى لغة القرآن ، ولعلك تعني ما جاء في قوله تعالى "على لسان داود وعيسى بن مريم" حيث أفرد (لسان) . وهذه مسألة خلافية بعيدة عن مسألتنا، وهي مسألة الإضافة إلى متضمنين مفرقين (17) باعتبار أن اللسان جزء من داود وعيسي عليهما السلام، وانظر تفصيلهما والخلاف فيها في همع الهوامع (1/51) في نهاية باب الجمع(18). أما مسألتنا هذه فهي إضافة ما ليس جزءاً مما أضيف إليه، فكلمة (معجم) ليست جزءاً من أحد الشخصين . ومذهب البصريين فيها أن ما ورد على خلاف الأصل - وهو المطابقة - فمسموع، وقاسه الكوفيون . أما ابن مالك فقاسه إذا أُمن اللبس . واللبس في مسألتنا هذه غير مأمون كما أسلفت. فما ذهبتُ إليه في عبارتي هو الأرجح الأصوب عند النحاة"(19). قال أبو عبدالرحمن : إذن إحالة المتع من عبارة "معجمي" إلى عبدالسلام من التقميش السريع . وقبل تحقيق هذه المسألة أحب إيراد شئ من كلام المعربين للآية من سورة المائدة، وشيء من نصوص همع الهوامع . فأما الآية الكريمة فقد تكلم عن تأويلها السمين بقولة "وجاء قوله"على لسان" بالإفراد دون التثنية والجمع، فلم يقل : على لساني، ولا على ألسنة، لقاعدة كلية ، وهي : أن كل جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أُضيفا إلى كليهما من غير تفريق جازَ فيهما ثلاثة أوجهٍ: لفظُ الجمع - وهو المختار - ويليه التثنية عند بعضهم ، وعند بعضهم الإفراد مقدم على التثنية ، فيقال : قطعت رؤوس الكبشين . ومنه "فقد صفت قلوبكما" . فقولي "جزأين" تحرز من شيئين ليسا بجزأين نحو درهميكما ، وقد جاء من بيوتكما وعمائمكما وأسيافكما لأمن اللبس. وبقولي "مفردين" تحرز من نحو العينين واليدين . فأما قوله تعالى "فاقطعوا أيديهما" ففهم بالإجماع . وبقولي "من غير تفريق" تحرز من نحو قطعت رأس الكبشين : السمين والكبش الهزيل، ومنه هذه الآية فلا يجوز إلا الإفراد . وقال بعضهم : هو مختار . أي فيجوز غيره، وقد مضى تحقيق هذه القاعدة في سورة المائدة بكلام طوسل فعليك بالالتفات إليه" (20) . |
|
|
#3 |
 |
وعن قول الله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (سورة المائدة/ 38) قال السمين"قوله :أيديهما" جمع واقع موقع التثنية لأمن اللبس، لأنه معلوم أنه يقطع من كل سارق يمينه، فهو من باب "صغت قلوبكما" ويدل على ذلك قراءة عبدالله "فاقطعوا أيمانهما" . واشترط النحويون في وقوع الجمع موقع التثنية شروطاً من جملتها : أن يكون ذلك الجزء المضاف مفرداً من صاحبه (21) بخلاف العينين واليدين والرجلين لو قلت : فقأت أعينهما وأنت تعني عينيهما، وكتفت أيديهما وأنت تعني يديهما . لم يجز للبس (22) . فلولا أن الدليل دل على أن المراد اليدان اليمنيان لما ساغ ذلك، وهذا مستفيض في لسانهم - أعني وقوع الجمع موقع التثنية بشروطة - قال تعالى :"فقد صغت قلوبكما". ولنذكر مفردين من صاحبيهما جاز فيهما ثلاثة أوجه : الأحسن الجمع، ويليه الإفراد عند بعضهم، ويليه التثنية. وقال بعضهم : الأحسن الجمع ثم التثنية ثم الإفراد نحو : قطعت رؤوس الكبشين، ورأس الكبشين، ورأسي الكبشين . قال : ومهمهمين قذفين مرتين * * * ظهراهما مثل ظهور الترسين فقولي "جزآن" تحرز من الشيئين المنفصلين لو قلت : قبضت دراهمكما . تعني درهميكما لم يجز للبس(25) . فلو أمن جاز كقوله : اضرباه بأسيافكما، وإلى مضاجعكما (26) . وقولنا "أضيفا" تحرز من تفرقهما كقوله "على لسان داود وعيسى بن مريم" (27) . وقولنا "لفظاً" مثاله ، فإن الإضافة فيه لفظية (28) .وقولنا "أو تقديراً" نحو قوله : رأيت بني البكري في حومة الوغى * * * كفاغري الأفواه عند عرين فإن تقديره كفاغري أفواههما . وإنما اختير الجمع على التثنية وإن كانت الأصل، لاستثقال توالي تثنيتين . وكان الجمع أولى من المفرد لمشاركته التثنية في الضم (29) . وبعده المفرد لعدم الثقل (30) . هذا عند بعضهم . قال لأان التثنية لم ترد إلا ضرورة كقوله: هما نفثا في فِيَّ من فمويهما * * * على النابح العوي أشد رجام بخلاف الإفراد فإنه ورد في فصيح الكلام ، ومنه مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما . قال بعضهم : الأحسن الجمع ثم الإفراد كقوله (31) : حمامة بطن الواديين ترنمي * * * سقاك من الغر الغوادي مطيرها وقال الزمخشري : "أيديهما" يديهما ، ونحوه : "فقد صغت قلوبكما" اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنيته المضاف، وأريد باليدين اليمنيان بدليل قراءة عبدالله "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم" . ورد عليه الشيخ (32) بأنهما ليسا بشيئين ، فإنه لا ينقاس(33) ، لأن المتبادر إلى الذهن من قولك : " قطعت آذان الزيدين" أربعة الآذان.. وهذا الرد ليس بشيء، لأن الدليل على أن المراد اليمنيان"(34). وعن قول الله تعالى "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما" (سورة التحريم /4) قال السمين "وقلوبكما" من إفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى استثقالاً لمجيئ تثنيتين لو قيل : قلباكما . ومن مجئ التثنية قوله : فتخالسا نفسيهما بنوافذ * * * كنوافذ العبط التي لا ترقع والأحسن في هذا الباب الجمع ثم الإفراد ثم التثنية . وقال ابن عصفور : لا يجوز الإفراد إلا في ضرورة كقوله : حمامة بطن الواديين ترنمي * * * سقاك من الغر الغوادي مطيرها وتبعه الشيخ وغلَّظ ابن مالك في كونه جعله أحسن من التثنية، وليس بغلظ للعلة التي ذكرها(36) ، وهي كراهة توالي تثنيتين مع أمن اللبس" (37) . قال أبو عبدالرحمن : تلخص من هذا التالي : 1.يضاف الجمع إلى المثنى والمراد المثنى لا الجمع كقوله تعالى "فقد صغت قلوبكما"، فإنما المراد به : قلب كل واحد منكما . فهما قلبان لا قلوب . والمسوغ لذلك التخفيف على اللسان، لأنه لو قال "قلباكما" لثقل الكلام بتوالي تثنيتين . وشرط الأخذ بهذا المسوغ أن يكون الجمع غير متحقق واقعاً . فأما الآية من سورة التحريم فاللبس مأمون بكون الاثنين ذوي قلبين فحسب . لكل واحد قلب واحد . وأما الآية من سورة المائدة عن السارق فتحتمل قطع الأيدي الأربع، إذ لكل سارق يدان، ولكن لما وجد البيان الشرعي من خارج الآية بأن القطع لليمين فحسب علم أن الأيدي بمعني التثنية على نحو "صغت قلوبكما"، لأنه ليس للسارقين غير يمينين . 2.إذا كان المضاف جزءاً واحداً من المضاف إليه، وكان المضاف إليه مثنى جاز فيه أيضاً أن تجعل المضاف مفرداً فتقول: قطعت رأس الكبشين. والمعنى رأس كل واحد على منهما. ووجه ذلك أن هذا المعنى متعين لا يُحتمل غيره، لأن الكبشين لا يشتركان في رأس واحد فتحمل الإفراد على الرأس المشترك، ولا يجوز حمل المفرد على رأس واحد منهما فحسب، فلم يحتمل العقل غير أن المراد رأس كل واحد منهما، فماَل المفرد حينئذ إلى معنى التثنية، وسوَّغ التعبير بالمفرد أن معنى التثنية متعين واقع، وأن المفرد على تقدير لا يحتمل معه غير معنى الاثنين، وذلك بتقدير "كل واحد من" أي قطعت رأس كل واحد من الكبشين. 3. ومن شواهد الجمع بمعنى التثنية قول الشماخ : رأيت بني البكري في حومة الوغى* * * كفاغري الأفواه عند عرين لم يقل الشاعر : فاغري الفوهين، وإنما قال : فاغري الأفواه، فعلم أن المراد التثنية لأنه ليس لهما غير فوهين. والأفواه متعين إضافتين إلى المثنى وهو ضمير الفاغرين . ولو أريد أفواه غيرهما لبقي الجمع على حقيقته، لأنك ستطلب معنى الجمع من أكثر من فاغر . 4. ومن شواهد الإفراد ما ذكره الشنقيطي . قال : "حمامة بطن الواديين ترنمي * * * سقاك من الغر الغوادي مطيرها استشهد به على وضع المفرد موضع المثنى، والأصل : بطني الواديين . قال أبو حيان : ومن العرب من يضع الجمع موضع الاثنين، ووجه ذلك : أنه لما أمن اللبس، وكره الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة : صرف لفظ التثنية الأولى إلى لفظ المفرد، لأنه أخف من الجمع، وذلك قليل جداً لا ينبغي أن يقاس عليه، ومنه قوله : حمامة بطن الواديين . إلخ . أراد : بطني الواديين فأفرد . وهذا البيت لتوبة بن الحمير" (38) . "بما في فؤادينا من الهم والهوى * * * فيحبر منهاض الفؤاد المشعف استشهد به معطوفاً على ما قبله، واستشهد به أبو حيان على وجه أصرح وأبين، ولفظه : ومن العرب من يخرج اللفظ على أصله من التثنية، فيقول : قطعت رأسي الكبشين، وذلك قليل ا هـ . ومنهاض الفؤاد الذي أصاب فؤاده هيض . أي كسر بعد جبر . والمشعف : الذي أصاب الحب سعاف قلبه، وهو رأسه عند معلق النياط . وقال : "نذود بذكر الله عنا من السرى * * * إذا كان قلبانا بنا يجفان الشاهد فيه كالذي قبله . قال أبو حيان في شرح التسهيل : وقال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور : وقد ذكر للقياس من وضع الجمع كوضع التثنية، فقال قطعت رؤوس الكبشين . هذا هو المختار، ومن العرب من يخرج اللفظ على أصله من التثنية، فيقول: قطعت رأسي الكبشين، وذلك قليل. قال الفرزدق : بما في فؤادينا . إلخ. وقال الآخر : نذود بذكر الله . إلخ ا هـ . وهذا البيت أظنه لعروة بن حزام أو لكعب صاحب ميلاء" (40) . هما نفثا في فِيَّ من فمويهما * * * على النابح العوي أشد رجام الشاهد فيه كالذي قبله . وفي شرح التسهيل لأبي حيان : وقد جمع الشاعر بين اللغتين، وأنشد البيت . وضمير المثني في قوله "هما نفثا في فِيَّ" لإبليس وابنه الذكورين في بيت قبل الشاهد . وفي البيت أيضاً الجمع بين البدل والمبدل منه، وهما الميم والواو . قال سيبوبيه : وأما فم فقد ذهب من أصله حرفان، لأنه كان أصله فوه، فأبدلوا الميم مكان الواو، فهذه الميم بمنزلة العين نحو ميم دم تثبت في الاسم، فمن ترك دم على حاله إذا أضيف ترك فم على حاله، ومن رد إلى دم اللام رد إلى فم العين، فجعلها مكان اللام، كما جعلوا الميم مكان العين، وأنشد البيت . ونفثا أي ألقيا على لساني يعني إبليس وابن إبليس، لأنه مما يقال :إن لكل شاعر شيطاناً، والنابح هنا أراد به من يتعرض للهجو والسب من الشعراء، وأصله في فِيَّ الكلب . ومثله : العاوي والرجام مصدر راجمه بالحجارة . أي راماه، وراجم فلان عن قومه إذا دافع عنهم . جعل الهجاء في مقابلة الهجاء كالمراجعة لجعله الهاجي كالكلب النابح . والبيت آخر قصيدة للفرزدق قالها في آخر عمره تائباً إلى الله تعالى مما فرط منه في مهاجاته الناس، وذم فيها إبليس، لإغوائه إياه في شبابه" (41) . وقال : فتخالسا نفسيهما بنوافذ * * * كنوافذ العبط التي لا ترقع الشاهد في قوله "فتخالسا نفسيهما" وتقدم ما في هذا النوع . وقال ابن الأنباري : والأكثر فتخالسا أنفسهما، لأن كل شيئين من شيئين : (42) يثنيان بلفظ الجمع كقولك : ضربت صدورهما وظهورهما . قال الله تعالى : "فقد صغت قلوبكما" والضمير للشجاعين المذكورين قبل هذا البيت في عد أبيات من قصيدة أبي ذؤيب الهذلي المشهورة" (43) . ومن الله أستمد العون، وأستلهم الرشد . وكتبه لكم : أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري {وفي الحيِّ أحوى ينفضُ المَرْدَ شادنُ * * * مظاهرُ سمطيْ لؤلؤ وزبرجد خذولُ تُراعي ربرباً بخميلة * * * تناولُ أطرافَ البريرِ وترتدي وتبسم عن أَلْمى كأن منوَّراً * * * تخلَّل حُرَّ الرملِ دعصُ له ندي سقته إياةُ الشمسِ إلا لثاتِه * * * أُسِفَّ ولم تَكْدِمْ عليه بإثمد ووجهُ كأن الشمس حلت رداءها * * * عليه نقيُّ اللونِ لم يتخدد "طرفة بن العبد" أحوى في شفتيه سمرة . المرد الغض من ثمر الأراك . مظاهر لبس ثوباً فوق ثوب . شبه حبيبه بظبي . خذول : خذلت أولادها . تراعي ربرباً ترعى مع قطيع من الظباء . الخميلة رملة منبتة . البرير شجر الآراك ، فهي ترتدي بأغصانه . الألأمى يضرب لون شفتيه إلى السواد . منوراً أقحوان له نور بفتح النون . حر الرمل : خالصة . الدعص الكثيب من الرمل . إياة الشمس شعاعها . لثاته مغارز أسنانه . والكدم العض . واللثات لا يستجيب بريقها، ونساء العرب يلعسنها بالإثمد . التخدد كثرة التجاعيد } (1)في مثل هذا لا توضع النقطتان، لأن مقو القول لم يرد، وإنما حكي موجزه. (2)دراسات في علم الجمال ص21. (3)الأخطاء الشائعة ص195.. قال أبو عبدالرحمن: وعبارة القطب الشيرازي نقلها عنه الزبيدي من كتابه شرح المفتاح، وذلك بتاج العروس 15/582. (4)مقاييس اللغة ص838. (5)المفردات ص639. (6)تاج العروس 15/578. (7)تاج العروس 15/581. (8)تقع في مجموع، ومقداره خمس عشرة صفحة، وهي كثيرة التصحيف والتحريف، وقد أوردها السيوطي بكتابه الأشباه والنظائر 6/130-169، ولم يعلق عليها بشيء، وكذلك محقق الكتاب الدكتور عبدالعال سالم مكرم لم يعلق بشيء على مسألة "فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار". (9)في الأصل: محذوف. (10)في الأصل: لمستخير. (11)في الأصل: تقريره.. والسياق يقتضي ما أثبته، وهو المثبت في أشباه النظائر. (12)في الأصل الكثير. (13)تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال ص83. (14)قال أبو عبدالرحمن: ليس هذا بصحيح، بل لإدارة هذا المعنى تعبير آخر وهو الإظهار، فيقول: معجمي فلان، ومعجمي فلان. (15)وذلك عندما يكون المضاف الآخر ظاهراً، أو قام البرهان بلا لبس أنه متعين التقدير.. ولا تعين هاهنا، لأنه ليس كل أحد يعلم لكل واحد من المذكورين معجماً مستقلاً، بل يحتمل الجاهل أنهما اشتركا في تأليفه. (16)قطوف أدبية ص461-462. (17)أي مفرقين بالعطف. (18)قال أبو عبالرحمن: للآية احتمالان: أحدهما: أن يكون المراد باللسان اللغة، وحينئذ يكون لسان داوود وعيسى عليهما السلام واحداً، فالكلام على ظاهره. وثانيهما: أن يكون المراد باللسان الجارحة، فحينئذ يتعين أن المراد لسانان بتعين تقدير مضاف آخر هكذا: لسان داوود ولسان عيسى، لأنه متعين بالضرورة أن لكل واحد لساناً، وأنهما غير مشتركين في لسان واحد.. فلما أمن اللبس بهذا التعين اختير الإفراد لأنه أخف. (19)قطوف أدبية ص485. (20)الدر المصون 4/382. (21)أي أن الواحد من المضاف كالقلب (مفرد القلوب المضافة إلى المثنى) جزء واحد من المضاف إليه وليس جزأين فأكثر كاليدين، فلا يقع الجمع حينئذ موقع التثنية، لأنه لو جعل بمعنى المثنى لكان في ذلك إلغاء لمقتضى الجمع بلا برهان.. والجمع هو الدلالة الصحيحة، لأن عند كل رجل يدين ثنتين، وللاثنان أربع، وذلك جمع. وإنما حملت آية السرقة من سورة المائدة على التثنية لأنه قام البرهان على أن المراد جزء واحد لا يوجد في المفرد غيره وهو اليد اليمين، فليس للإنسان غير يمين واحدة. (22)وجه البس أن قولك للاثنين:"عيونكما" ظاهر في الجمع، لأن للاثنين أربع أعين، فلو جعل للمثنى لا لتبس المثنى بالجمع، ولاقتضى الأمر التوقف في دلالة "عيونكما" حتى يأني مرجح من خارج يعين هل المراد المثنى أو الجمع. وأجود من التعبير بأمن اللبس أن تقول: إن حمل الجمع على المثنى حينئذ إلغاء للظاهر وهو الجمع، وإعمال لغير الظاهر وهو التثنية بلا برهان. (23)أي لم يجز حمل الجمع في قولك:"أعينهما" على معنى المثنى، لأن الظاهر الجمع، إذ لهما أرع أعين. (24)كالقلب فإنه جزء واحد من الإنسان ليس له غير قلب واحد.. قال تعالى:{ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه}[سورة الأحزاب/4]. فالقلب جزء، والرجل كل. (25)لأنه لم يقم برهان على أنه ليس عندهما غير درهمين. (26)الضرب بالأسياف يحتمل معنى الجمع فلا يحمل على التثنية، لأن الفرد ق يجالد بسيفين في المرة الواحدة، وقد يجالد طرفاص واحداً بأكثر من سيف في عدة مرات.. إلا أن هذا خلاف العادة. المضاجع إذا أريد بهما الزمان الواحد فلا لبس، وإذا لم ترد وحدة الزمان فقد يكون للإنسان أكثر من مضجع في عدة أماكن. (27)فلم يقل:"على لسانيهما" فتكون الإضافة إلى مثنى. (28)أي مثل"قلوبكما" و"رؤس الكبشين" فإن الرجلين والكبشين مثنيان لفظاً لا تقديراً. (29)والتثنية ضم واحد إلى واحد، والجمع ضم أكثر من واحد. (30)التعليل قاصر هاهنا، لأن عدم الثقل مشترك بين الجمع والتثنية: وإنما يقال: يعبر بالجمع والمفرد معاً في المسألة المذكورة:لأن توالي تثنيتين مستثقل، وقدم الجمع على المفرد على الرغم من اشتراكهما في الخفة! لأن الجمع يشارك المثنى في معنى الضم. (31)وجه هذا التفضيل فيما يظهر لي أن التثنية هي الأصل فقدمت على المفرد لمجرد الخفة، وقدم الجمع للخفة ولأمر آخر غير مجرد الخفة وهو مشاركة المثنى في الضم. (32)هو أبو حيان النحوي. (33)وهو قلوبكما. (34)وهو الأيدي، لأن للفرد أكثر من يد. ورد السمين على شيخه أبي حيان وجيه جداً، وكلام الزمخشري صحيح. (35)الدر المصون 4/262-264. (36)بل يقال: التثنية أولى من الإفراد والإفراد جائز بما جاز به الجمع من الخفة حسب الشروط المذكورة. (37)الدر المصون 10/366. (38)الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية 1/154-155. (39)الدرر اللوامع 1/155. (40)الدرر اللوامع 1/155-156. (41)الدرر اللوامع 1/156-157. (42)يتحتم في مثل هذا وضع نقطتين فوق بعض: ليعلم أن ما بعدهما خبر وليس وصفاً. (43)الدرر اللوامع 1/158 |
|
|
#4 |
 |
القسم الثاني الباب الأول : النظرية الجمالية : الفصل الأول : معنى الجمال ، وعلمة وتاريخه . الفصل الثاني : الحكم الجمالي . الفصل الثالث : برجسون والحدس الفني . الفصل الرابع : كروتشه وفلسفة الفن . { قال عمر بن علي المطوعي : أمير كله كرم سعدنا * * * بأخذ المجد منه واقتباسه يحاكي النيل حين يروم نَيلاً * * * ويحكي باسلاً في وقت باسه قال ابن رشيق : أراد أن يناسب، فجاء القافيتان كما ترى في اللفظ ليس بينهما في الخط تناسب إلا مجاورة الحروف . "وهذا أسهل معنى لمن حاوله، وأقرب شئ لمن تناوله، ولكنه من أبواب الفراغ وقلة الفائدة" . وهو مما لا يشك في تكلفه، وقد كثَّر منه هؤلاء الساقة المتعقَّبون في نثرهم ونظمهم حتى برد، ورك، فأين هذا العمل من قول القاءل وهو أبو فراس : سكرت من لحظه لا من مدامته * * * ومال بالنوم عن عيني تمايله وما السلاف دهتني بل سوالفه * * * ولا الشمول ازدهتني بل شمائله ألوى بصبريَ أصداغ لوين له * * * وعًلَّ صدري بما تحوي غلائله؟ فما كان من التجنيس هكذا فهو الجيد المستحسن، وما ظهرت فيه الكلفة فلا فائدة فيه . "العمدة لابن رشيق" 1/559-560 " الفصل الأول : معنى الجمال، وعلمه، وتاريخه : إن تعريف الجمال يأتي - كغيره من التعريفات - لإفادة التصور، وذلك يأتي بالتعريف، والمثال الشارح، والتقسيم . وأبلغ من ذلك أن تنثر بعض العناصر التي تدرك فيما هو جميل، وأن تشخص الآثار الوجدانية في الذات من جراء ما هو جميل . فقول أرسطو مثلاً في منشأ الميتافيزيقيا "إنه ذلك الشعور بالدهشة الذي يبلغ كماله في الحكمة" (1) فهذا عنصر جمالي . وقال ر . ف . جونسن "الفيلسوف القروسطي المسيحي العظيم توماس أكواينس عرَّف الجمال بأسلوب مقبول على أنه ذلك الذي لدى الرؤية يسر . أي أنه يسر لمحض كونه موضوعاً للتأمل سواء عن طريق الحواس أو في داخل الذهن ذاته . والروائي الفرنسي ستندال من القرن التاسع عشر وصف الجمال بعبارات أكثر شروداً على أنه الوعد بالسعادة . وأظهر بذلك رؤياً ربما كانت أعمق في المشاعر التي يثيرها الجميل" (2) . قال أبو عبدعبدالرحمن : السرور وجدان في القلب، وكذلك السعادة التي جعل الجمال وعداً بها . وفي هذا السياق تعبيرات مجازية، وعمومات، وتخصيصات لا تأخذ بمفهوم الحد الأرسطي العلمي، ولكنها مفيدة جداً في استجلاء العناصر التي تؤلف تعريفه، وهي تتناول القسم الأهم من الجمال (لأنه يتعلق بالإنسان وإبداعه)، وهو الجمال الفني، وقد أورد تلك العناصر الدكتور محمد ذكي العشماوي، فقال "ومع ذلك فقد يعجبنا أحياناً بعض المقولات التي تصدر عن الفنانين في تناولهم لماهية الفن، والتي قد تعترض دراساتهم، أو نجدها منثورة في بحوثهم، أو مبثوثة في كتبهم، أو مطروحة على ألسنة الناس ممن يهتمون بهذا الميدان أو ذلك من ميادين الفن كأن تسمع أحدهم يقول مثلاً : الفن هو إدراك عاطفي للحقيقة . أو هو تلك الدنيا الفريدة والمبتدعة والحية والمحتفظة بحيويتها وطزاجتها على الدوام . أو هو تلك الغرة من الصور التي يشنها الخيال على الواقع . أو هو أن تتناول الواقع بأنامل ورعة، وترفعة إلى مستوى المثال . أو هو تلك المسافات المرتعشة التي تجدها بين الكلمات أو الارتفاعات والانخفاضات التي تكون بين الأصوات أو الحركات أو الألوان . أو هو زجاجة الويسكي(3) التي يقدمها لك الفنان لتنقلك إلى عوالم من النشوة والانبهار . أو هو تلك الدهشة التي تعتريك وتسيطر عليك عند رؤيتك لمنظر طبيعي أخاذ تراه لأول مرة . أو هو الذي يقدم لك تذاكر الطائرة، ولا يحجز لك في الفنادق، أو يحدد لك الأماكن التي تزورها، بل يتركك تتأمل ما تشاء بطريقتك الخاصة . أمثال هذه العبارات وغيرها قد تستهوينا أثناء قراءنها، وقد تنجح في إثارة العديد من المشاعر لشدة تركيزها وقوة إيحائها، وما تنطوي عليه أحياناً من الصدق في الدلالة على معنى الفن، أو في التعبير عن زاوية من زواياها. لذلك قد نفرح عند الوقوع عليها، أو إلى تحديد الإطار العام لماهية الفن . ذلك الإطار الذي يصلح أساساً أن تتوقف عليه صحة القضايا والأحكام . إن هذه المقولات السابقة أشيه بصور الفن التي تنطلق من الفنان بطريقة تلقائية أو نصف واعية دون أن يكون له علم بطبيعتها، فهي تضيئ ولكنها قد تسيئ إلى أصحابها أو تضره"(4) . قال أبو عبدالرحمن : بتحليل معاني هذه التعريفات نجد العناصر التالية : 1. ربط العاطفة بالمعرفة باعتبار الفن إدراكاً عاطفياً . 2. الندرة، والإبداع . 3. الحيوية (الحركة، والنبض، والتجدد) . وعنصر التجدد هو المقابل للملل والرتابة . 4.خصوبة الخيال إذ يكاثر الواقع (الأعيان الطبيعية) بصور فنية خيالية . 5.القدسية بالنفوذ من الواقع إلى المثال . 6. إشارات في الموضوع تثير الجمال، ففي النص المسافات المرتعشة، وفي التطريب الارتفاعات والانخفاضات، وفي التمثيل الرقص والحركات، وفي التشكيل الألوان . 7. النشوة والانبهار، وذلك قريب من الدهشة التي مر ذكرها . 8. التحليق والانتقاء . وكل ما نثر من تلك العناصر سيحوجنا إلى تعريفات لغوية به لنقع على أشياء محددة . وهذا ما ستجده إن شاء الله في الباب الرابع . قال أبو عبدالرحمن : أصبح الفن عرفاً على الفن الجمالي، ولهذا فكل تعريف يصف الفن ويوضحه بالجمال فإنما يكون تعريفاً يميز الفنون الجمالية عن غيرها، ولا يكون تعريفاً يحد الفن الجمالي ذاته . قال الدكتور العشماوي "من علماء الجمال من يرى أن الفن هو القدرة على توليد الجمال أو المهارة في استحداث متعة جمالية" (5) . قال أبو عبدالرحمن : هذا تمييز للفن الجمالي عن عموم الفنون، وليس تحديداً له . إلا إن ما سيحكيه الدكتور من مذاهب ليس نموذجاً لدعوى تعريف الفن بالقدرة على توليد الجمال . قال : "من هؤلاء ساتنيانا الذي يفرق في الفن بين معنيين : معنى عام يجعل فيه الفن مجموع العمليات الشعورية الفعالة التي تلعب دوراً هاماً في حياة العقل، والتي تعدِّل البيئة وتكيفها وتصوغها حتى تتمكن من تحقيق أغراضها (6) . ومعنى خاص يجعل من الفن مجرد استجابة للحاجة إلى المتعة أو اللذة دون أن يكون للحقيقة أي مدخل فيها . اللهم إلا أن تكون على حد قول الدكتور زكريا إبراهيم : عاملاً مساعداً قد يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية" (7). ويواصل الدكتور زكريا شرحه للمعنى الأول فيقول "والفن بالمعنى الأول إنما هو عبارة عن غريزة تشكيلية شاعرة بغرضها، بحيث أنه لو قدر للطير وهو يبني عشه أن يشعر بفائدة ما يصنع : لصح أن نقول عنه : إنه يمارس نشاطاً فنياً . وتبعاً لذلك فإن الفن بمعناه العام هو كل فعل تلقائي يؤازره النجاح، ويحالفه التوفيق بشرط أن يتجاوز البدن لكي يمد إلى العالم، فيجعل منه منبهاً أكثر توافقاً مع النفس(8)"(9) . قال أبو عبدالرحمن : المعنى الأول يشمل كل فن صناعي وجمالي . ويتميز الفن الجمالي بأن القيمة الجمالية غايته . أما الفن الصناعي فقد يُنظر فيه إلى عنصر جمالي، فيكون موضوعاً لإحساس جمالي . إن القيمة الجمالية تكون أساساً لا بالتبع في كل الفنون الجميلة . والعمليات الشعورية المذكورة في المعنى الأول لا تميز الفن الجمالي من الفن الصناعي، بل هي إحدى وسائل الأداء للفنين، فهي مشتركة . والمعنى الثاني تعريف للفن الجمالي المجاني . أما الفن الجمالي المعبر القابل للالتزام فيقتضي تحويراً في العبارة بأن يقال: إن الفن الجمالي لا يكون فناً بشرطه الجمالي إلا بأن يحقق متعة ولذة . وفرق بين أن يحقق الفن المتعة بضربة لازب، وأن يكون مجرد محقق للمتعة . والدكتور العشماوي في سياقه لتعريفات الفن التبس عليه كون الجمال - ومن آثاره المتعة واللذة - شرطاً لما يسمى فناً جميلاً، وكون مجرد المتعة واللذة ليس هو كل الفن الجمالي . بل الجمال السامي ما أضاف إلى المتعة معرفة وتوجيه سلوك . قال "ومن الين عرفوا الفن بأنه متعة فنية أو لذة جمالية كثيرون منهم مولر فرينغلس في كتابه سيكلوجية الفن . ذكر أن لفظ الفن هي من الألفاظ التي تطلق على شتى ضروب النشاط أو الإنتاج التي يجوز أو ينبغب أحياناً أن تتولد منها آثار جمالية . وعلى الرغم من أن في الفن قدرة على توليد الجمال، وأن الإحساس بالجمال (وكذلك الإحساس باللذة والمتعة) هما (10) شيئان مصاحبان لعملية التذوق، وعملية الإبداع على السواء : (11) فإنهما ليسا شرطأ لوجوده أو تحققه، ومن ثم فلا نظن أن تعريفنا للفن بأنه لذة يمكن أن يحقق الهدف من التعريف الذي ننشده أو نسعى إليه، فقد يكون الأثر الفني باعثاً على اللذة، وقادراً على توليد أكبر قدر من الإحساس بالمتعة . ويكون في ذات الوقت رديئاً من الناحية الفنية . وقد نقرأ قصيدة شعرية أو نستمتع بلوحة فنية في لحظة ما، ثم تتغير اللحظة ويتغير الموقف النفسي فإذا اللوحة يختلف تأثيرها وإذا القصيدة الشعرية تفقد مذاقها أو معناها، وهذا وحده يكفي دليلاً على أن اللذة ليست دائماً معياراً صادقاً أو سليماً لقياس الفن، أو دليلاً على وجوده" (12) . قال أبو عبدالرحمن : القيم الجمالية بما فيها اللذة والمتعة شرط وجود الجمال، وليست كل شرطه، ولهذا يكون الجمال المجاني أحط درجات من الجمال الباعث المحرك إلا في حالات تكون المتعة الجمالية مقصودة لذاتها .قال أبو عبدالرحمن : ويتبع تصور معنى الجمال التعريف بعلم الجمال وتاريخه، وقد تحدث الأستاذ مجاهد عبدالمنعم مجاهد في صدر كتابه "دراسات في علم الجمال" عن اختلاف مذاهب الفلاسفة وعلماء الجمال في مأخذ تعريف علم الجمال، فعزا إلى أفلاطون وإلى الفيلسوف الأمريكي المعاصر جورج سانتايانا أن مأخذ التعريف يجعل علم الجمال دراسة للجمال ذاته . وعزا إلى آخرين أن مأخذ تعريف الجمال يجعل الجمال مجرد دراسة للمفاهيم والمصطلحات الجمالية، وذلك بتحليل معني الشكل والمضمون والنمط والذوق . ونقل عن المعجم الفلسفي لأندريه لالاند قصر علم الجمال على دراسة موضوع حكم التقدير والذوق (13) . قال أبو عبدالرحمن : أهل المذهب الأول يميز مذهبهم عن غيره اتجاههم لدراسة الجمال ذاته . ولا ريب أن كل مذهب ينحو إلى دراسة الجمال ذاته، ولكنهم يختلفون فيما هو الجمال الذي تراد دراسته، فأهل المذهب الثاني اتجهوا إلى مفاهيم الناس للجمال ليعرفوا ما هو الجمال . ومن أهل هذا المذهب الثاني من درس ملكة الحكم ليأخذ من مقتضاها معنى الجمال. وأهل المذهب الأول نظراتهم أشمل تتجه إلى أخذ معنى الجمال من كل علاقة بالجمال الطبيعي والفني، والذاتي والموضوعي، وسبر الذاتي والمتغير من الحكم الجمالي(14) . وذكر مجاهد اتجاهاً ثالثاً يجعل الجمال للصور الفنية، ونقل عن كتاب "علم الجمال الفرنسي المعاصر" قوله "إن غاية علم الجمال هي الوقوف على المقولات الأساسية أو المبادئ الصورية الجوهرية الثابتة التي تًنظم وفقاَ لها شتى المظاهر الجمالية لهذا الكون المنظم الذي نعيش في كنفه" (15) . قال أبو عبدالرحمن : حقيقة هذا المذهب قصر علم الجمال على الجمال الفني بدراسة صوره دراسة تقيم الجمال الفني على ثوابت من مبادئ الجمال الطبيعي . وذكر اتجاهاً رابعاً يفرق بين الفن الجميل ، والفن الصناعي، ويستبعد الجمال الطبيعي، ويجعل كل اتجاه للجمال مرتبطاً بالإنسان، فالفن إنتاج إنساني، والتذوق بعدُ إنساني، والحكم إنساني. وجعل هذا مذهب هيجل في كتابه "محاضرات حول فلسفة الفن الجميل" و "علم الجمال والنقد" . وقد اعتبر علم الجمال فرعاً من الفلسفة النقدية . قال أبو عبدالرحمن : حقيقة هذا المذهب جعل الجمال فنياً ذاتياً . ومال الأستاذ مجاهد إلى تعريف الجمال، واختار متابعة هيجل في تعريف علم الجمال أنه فلسفة الفن الجميل . أي فاسفة الوعي الجمالي، وفلسفة القدرة على الإبداع والتذوق(16). ولخص مجاهد تاريخ علم الجمال بقوله :"وفي الحقيقة أن هناك تيارين رئيسين على مدى تاريخ علم الجمال . تيار يدرس المشكلات الجمالية معزولة عن الإنسان وتيار يدرسها في علاقتها بالإنسان . وتاريخ علم الجمال هو تاريخ الصراع بين هذين التيارين من أجل الوصول إلى أن يستحيل علم الجمال إلى علم الإنسان داخل نطاق ما هو جمالي وفني" (17) . وقال :"يمكن القول بصفة عامة إن تعريف أي علم ليس إلا تاريخ صراع هذا العلم لمحاولة الوصول إلى تعريف حقيقي له. أي أن التعريف الصادق لا يأتي في البداية، بل يكون في خاتمة كل حقبة تاريخية" (18) . |
|
|
#5 |
 |
الفصل الثاني : الحكم الجمالي : صفة الحكم الجمالي عند كانت أنه تذوق، وأنه حيادي غير متحيز . ومعنى حياديته أنه لا يحصِّل أي شئ آخر غير الحكم بتأثير الشئ فينا بأن يكون لذيذاً (وذلك هو الجمال)، أو مؤلماً (وذلك هو القبح). قال أبو عبدالرحمن : المحك للحكم الجمالي أن يثير فينا لذة وبهجة، والانسجام مع ذلك هو الذي يعبر عنه كانت بالرضى . والرضى وجود ذاتي في القلب صادر عن مؤثرات في الموضوع الذي حكمنا بأنه جميل . وبمجرد حصول الرضى تتحقق ملكة الذوق في فلسفة كانت . قال "الذوق هو ملكة الحكم بالرضى أو بعدم الرضى على شئ ما . أو على شكل تقديمه . والشئ الذي يرضي هو بالتالي الجميل" (19) . قال أبو عبدالرحمن : تنتقل الفلسفة الأدبية والفنية من الفلسفة الأم إلى حقل النقد الأدبي الذي يلجه ذوو التفكير الشعبي، فتنتقل من لغة رياضية مباشرة محددة إلى أسلوب عائم، وفكر متمعلم . ويزداد الطين بلة إذا كان الفيلسوف من المحدثين الذين مزقتهم اللغة المجازية وكثرة المصطلحات كما نجد في الفلسفة الفنية لدى برجسون وكروتشه . عالج كروتشه مسألة الحدس الفني في كتابة "علم الجمال" واعتبر الحدس أدل على الإدراك الفطري، أو الإحساس الفطري للطبيعة، أو البديهة. إذن الفن معرفة . والمعرفة المنطقية مصدرها العقل ، والمعرفة الفنية مصدرها الخيال . ومعنى الحدس لغة يشمل الحدس العقلي الذي معرفته منطقية، ولهذا تميزت معرفة الخيال بالحدث الفني . وأضخم دعوى في الحدس الفني أن ما فيه من مضامين عملية أو نفعية أو منطقية أو أخلاقية ذاب وتغير عما كان عليه . ولعل هذه الدعوى تفسر باتحاد الشكل والمضمون ، والذات والموضوع. وبهذا يتحول الموضوع الخارجي لأي غرض من أغراض الشعر إلى عمل فني متحد . قال الدكتور محمد زكي العشماوي "لا يمكن أن يكون اختيار الخريف موضوعاً لقصيدة ما أبلغ أو أكثر شاعرية من اختيار موضوع آخر مثل منازل الفقراء المدقعين مثلاً . ولو جاز أن يكون للموضوع قيمة في ذاته لكان همنا من القصيدة المعرفة العقلية عن مسألة أو موضوع ما . ولو كان هذا هو هدفنا لكان الأولى بنا أن نستمع إلى مقال علمي عن الخريف ، أو لذهبنا لعالم من علماء الاقتصاد أو الاجتماع لنجد عنده الدراسة الجادة لمنازل الفقراء المدقعين،وما تحتوي عليه من ظواهر اجتماعية واقتصادية . ولاستطاعت هذه المقالات العلمية أن تصل بنا إلى معرفة أدق وأشمل مما يمكن أن تقدمه إلينا القصيدة الشعرية . إن العبرة في النقد الجمالي ليست للموضوع باعتباره شيئا خارجياً ولا بالفكرة باعتبارها مجرد فكرة ، وإنما العبرة بما صار إليه الموضوع أو الفكرة بعد أن سيطر عليهما الشاعر أو الفنان، وبعد أن اصهرتا في ذاته، وبعد أن تحولتا إلى فن. إن كل موضوع وكل فكرة ليسا إلا مجرد مادة من المواد الخام التي تتحول عند تناولها إلى شيء جديد"(20). قال أبو عبقد الرحمن : قيمة الفن قيمة جمالية بلا ريب، ولكن هذا لا يعني أن الجمال محصور في ظواهر الفن الجمالية، بل هناك جمال عنصره العظمة والكمال، أو الفكر وجبروته، وهو جمال يسمق بقيمتي الحق والأخلاق . وقد يوجد موضوعان مختلفان تتساوى قيمتها الجمالية الفنية، ولكن موضوعاً منهما تزكِّيه قيمتا الحق والأخلاق من أجل جمال العظمة المذكور آنفاً لصلته (21) العملية بالجمهور، أو لسموقه الفكري، فيكون أجمل فنياً بعناصر جمالية خارج عناصر الجمال الفني . إذن للموضوع قيمة جمالية في ذاته، ولكن هذا لا يعني أن المبتغى في كل موضوع قيمتُه الفنية الجمالية لا المعرفة المنطقية المباشرة .. وقلت المباشرة لأن الفن إيحاء بالحقيقة . وعن الوحدة بين الشكل والمضمون يلخص الدارسون مذهب كروتشه بأنه : "لا ينبغي أن نفرق بين حدس الفنان وتعبيره، (22) فالفكرة الشعرية ليست شيئاً مبايناً لوزنها وإيقاعها وألفاظها، (23) والحدس والتعبير ليسا سوى شيء واحد . صحيح أن الصنعة قد تدخلت في إنتاج الأداة الفنية . (24) في طريقة مزج الألوان، وفي تسجيل النغمات، وفي قطع الحجر دون تهشيمة . لكن ليس في الإمكان فصل التعبير عن الخيال . فالقصيدة والسوناتا والرواية توجد مكتملة قبل أن يقوم الفنان بالعمل الآلي الذي تقتضيه كتابة العمل الفني بالفعل . لكن علينا أن نفرق بين الخيال الفني ومجرد الوهم.(25) فالخيال الفني خيال مبدع يعبر عن شعور أو عاطفة ما (وإن لم يكن يجوز لنا أن نفرق بين الشعور الذي يعبر عنه الفنان باعتباره مضموناً من ناحية، والصورة الذهنية باعتبارها شكلاً من ناحية أخرى)، ذلك لأن الفن هو التركيب القبلي الذي يؤلف بين الشعور والصورة الذهنية. الفن إذن ليس سوى عرض الشعور مجسماً في صورة ذهنية" (26) . قال أبو عبدالرحمن : يظل كلام المفكرين والأدباء مجرد تلاعب بفهم المتلقي ما ظل تعبيرهم يلغي الفروق المؤثرة، أو يغاير بغير فروق مؤثرة . ويظل مجانياً ما ظل دعوى بلا برهان . وإنني أجد هاتين الآفتين فيما حكي من مذهب كروتشه عن شرح دعوى الوحدة في الشكل والمضمون . وبيان ذلك أن حدس الفنان رؤية مباشرة بلا وسائط، ومعنى ذلك أنه أدى المضمون بتعبيره الفني وشكله الذي جاء به دون تخطيط مسبق للفكرة التي يريدها، وبدون أناة زمنية لتحبير الشكل وتجميله . وهذه التلقائية في ميدان الحدس فحسب، ولا ينسحب ذلك على كل إبداع لكل فنان!! . والفنان نفسه قد لا يعي تفسير هذه التلقائية . والوحدة التي حصلت هاهنا وحدة زمنية جمعت عناصر المضاهاة الفنية من مضمون وأشكال، فولدت العناصر دفعة واحدة دون أن يكون لعنصر أسبقية زمنية على العنصر الآخر . إلا أن هذه الوحدة الزمنية لا تعني وحدة الشكل والمضمون بإطلاق، بل هما غيران جمعهما ترتيب زمني واحد . إذن الفكرة شيء مباين لوزنها وإيقاعها . إلخ . وقد بينت في كتابي "الالتزام والشرط الجمالي" أن الفنون تقبل التعبير، وقد يدل الوزن والإيقاع على الفكرة إضافة إلى الدلالة اللغوية، فلا يكون الوزن والفكرة شيئاً واحداً، وإنما يكون الوزن شيئاً غير الفكرة، ولكنه دل عليها! . والفن لا يكون تركيباً قبلياً بإطلاق، وإنما يكون كذلك عندما يكون تلقائياً (حدساً) . والجامع بين الوهم والخيال أنهما في صورة تحاكي حقيقة، والفارق بينهما أن الفنان يعي بتخييله ويقصده، فليس متوهماً . وقارن أصحاب الموسوعة الفلسفية بين مذهب كروتشه - وكانت على أساس هذه الوحدة المدعاة بين الشكل والمضمون - فقالوا : لقد كان أعمق البحوث الكلاسيكية لعلم الجمال أثراً هو المناقشة التي نجدها في كتاب "كانت" نقد الحكم.(27) وخاصة عندما يصر على أن الحكم الجمالي يرتد إلى أصول سابقة على تكوين التصورات الذهنية، وعلى أن معايير القيمة الجمالية لها طابع شكلي . وتستمد مناقشته صورتها المحكمة من وجهة نظره التي مؤداها : أن الأحكام تختلف من حيث الكم والكيف والنسبة والجهة بحيث تنحصر مشكلة علم الجمال أساساً في أن نحدد كيف تختلف الأحكام الجمالية من هذه الجوانب الأربعة عن غيرها من الأحكام (28) . أما في العصر الحاضر فإن أشهر نظرية جمالية هي نظرية كروتشه في كتابه الاستطيقا التي تشبهها بصورة جوهرية (29) نظرية كولنجوود في كتابه أصول الفن . يرى كروتشه أن العمل الفني حدس حسي لعاطفة بعينها جاء ذلك العمل الفني أيضاً تعبيراً كاملاً عنها. فما اللوحة أو الكلمات المكتوبة أو الأصوات سوى مساعدات سببية تعين الآخرين على أن يحدسوا الحدس نفسه . والرأي الذي بسطه كاسيرر في كتابه فلسفة الأشكال الرمزية كان أيضاً ذا تأثير كبير . وخاصة بالصورة التي أعيد عرضه بها في كتاب س . ك . لا نجر "الشعر والشكل" . وتشترك هذه الآراء في أنها تعد الخبرة الجمالية في جوهرها تعبيراً عن شعور أو رمزاً له، وفي أنها تصلها من حيث هي كذلك بكل استعمال للغة وغيرها من طرائق الرمز . بل إن كروتشه يعد علم اللغويات العام وعلم الجمال شيئاً واحداً بذاته" (30) . قال أبو عبدالرحمن : الجمال ارتياح قلب، وذوق عقل . هو ارتياح قلب بالنظر إلى ذاتيته، لأنه لا تعريف له إلا سرور القلب ولذته . وذوق عقل بالنظر إلى موضوعه، فإن العقل يستنبط الملامح من أشكال ما هو جميل فتكون عنده ملكة ذوقية بها يصل السرور أو الانقباض إلى القلب من الشكل الذي يكون جميلاً أو قبيحاً . والعقل والقلب يتساقيان الأفكار والعواطف، فالعقل محل كل الملكات الفكرية، ومجمع الأضغان (القلب) محل الانفعال بالأفكار حباً وكرهاً، وتحمساً وفتوراً، وتصديقاً وتكذيباً، ولذة وألماً . أي بمقدار تربيته العقلية علماً ومراناً يكون سموق ذوقه القلبي، وإحساسه بمجالي الجمال . وإذن فلا معنى لدعوى الفيلسوف الألماني "كانت" بأن الحكم الجمالي يرتد إلى أصول تسبق تكوُّن التصورات الذهنية !!. قال أبو عبدالرحمن : لا نعرف للحكم الجمالي أصولاً لاحقة أو سابقة تخرج عن التصورات الذهنية . وإنما نعلم أن الحكم الجمالي وجد أن في الذوات المحسِّة بجمال ما هو جميل . كما نعلم أن الحكم الجمالي تصورات ذهنية واستنباطات عقلية من موضوع الجمال . كما نعلم أن القلب لا يحس بالجمال من فراغ ، بل يحس وعنده عقائد فكرية . ومن المنتقد إطلاق "كانت" القول بأن معايير القيمة الجمالية ذات طابع شكلي . والواقع أن شكل الأداء للجمال - كأشكال الأداء في الفنون الجميلة من صوت وصورة وحركة - موضوع للقيمة الجمالية . والقيمة فكرية بلا ريب، ولكنها مأخوذة من وجدان قلبي . والجوانب الأربعة التي يختلف من جهتها الحكم الجمالي تعود إلى اختلاف مستويات التربية الثقافية والفكرية، فلن تكون أغنيات التخت الشرقي أجمل من صوت الربابة، ولن تكون ألحان السنباطي أجمل من ألحان التخت الشرقي إلا بعد تدرج في التربية الثقافية والفكرية، ولهذا قلت مراراً : الإحساس بالجمال فئوي، ولكن له مثل أعلى ! . والدارسون والمترجمون يستقون فلسفة الجمال لدى كروتشه من آثاره التي لم تترجم إلى العربية بعد، وهي المجلد الأول من "فلسفة الروح" وكتابه"موجز في علم الجمال" ، ومقالته عن علم الجمال التي نشرها بـ "دائرة المعارف البريطانية". |
|
|
#6 |
 |
الفصل الثالث : برجسون والحدس الفني : للحدس معنى فلسفي مشتق من معناه اللغوي، وقد أسلمته الفلسفة الحديثة إلى النظرية الأدبية . قال أبو عبدالرحمن : بيد أن الفلسفة الحديثة فلسفة التمزق بالمصطلحات دون فقر إلى المصطلح أو ضرورة . وسرت هذه العدوى إلى النقد الأدبي !. والمصطلح لغير ضرورة يبعدك عن المأثور الدال، ويوهمك بحضور علم جديد لا يدل عليه إلا مواضعة مستأنفة، وهذا تمزق وتمعلم في آن واحد، لأنه يتعالى على المعارف الإنسانية السالفة وهو من معطياتها . والمصطلح الجديد لغير ضرورة يكون عنوان مذهب جديد يتسع بالشروح، والاحترازات، والدعاوى، والاستدلالات، (31) وجعله في دور المعارضة للمصطلحات الأخرى . وبذلك اتسع جانب المغالطة في فلسفة المصطلحات ، وبرزت المغالطة في ناحيتين : أولاهما : عملقة معنى المصطلح، وحصر الحقيقة فيه، وتقزيم ما سواه . وأخراهما : الاعتداء على الأعراف والمفاهيم المصطلح عليها كجعل العقل ثانوياً، وجعل الخيال أساس المعرفة بإطلاق . وينبغي أن نعلم المعنى اللغوي الذي اشتق منه المفهوم الفلسفي للحدس، ثم نفهم في آن واحد الفروق والعلاقات بين المشتق والمشتق منه . فأما المعنى اللغوي فقد قال ابن فارس :"الحاء والدال والسين أصل واحد يشبه الرمي والسرعة وما أشبه ذلك". وذكر الظن كأن الحدس رجم بالظن . كأنه رمى به . وذكر الحدس بمعنى سرعة السير(32) . وذكر اللغويون الحدس بمعنى النظر الخفي(33) . ونقل الأزهري أن الحدس بمعنى التوهم في معنى الكلام، وجعل الحادس قائلاً بالظن والتوهم معاً . قال أبو عبدالرحمن : تفسير الحدس بالظن فهم خاطئ من أحد علماء اللغة الأجلاء، وليس نقلاً عن العرب(34). وقد يتيقن الإنسان الشيء، ويكون تيقنه وهماً . أما الظن فليس توهماً، ولكنه مجرد احتمال مستوى الطرفين، أو ترجيحٍ لأحد الاحتمالات، ولا يكون المقتضي التسوية أو الترجيح وهماً . وإنما يغيب عنه علم مرجحات أخرى وموانع . وغياب العلم ليس وهماً . ومن معنى الرمي اشتقت معانٍ لغوية منها القصد بأي شيء كان ظناً أو رأياً أو دهاء، والحدس بمعنى الوطء بالرجل، والغلبة في الصراع (ومنه إناخة الناقة لذبحها) ، والمضي على استقامة وطريقة مستقيمة - وخالف الأزهري، فقال : على غير استقامة - . وَحَدس أخت عدس زجْر للبغال في استعمال العرب، ثم جاء ابن أرقم الكوفي بدعوى أن الحدُس قوم يعنفون على البغال على عهد سليمان بن داوود عليهما وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام فتنفر منهم . وهذه الدعوى تحتاج إلى نقل موثق لكثرة القرون بين ابن أرقم وسليمان عليه السلام . وذكر ابن السكيت : بلغت به الحِداس . أي الغاية التي يجري إليها أو أبلغ . والمحدس المطلب . يقال فلان بعيد المحدس . وتحدَّس الأخبار طلبها بخفية . والحدس الفراسة، وتعسُّفُ الكلام على عواهنه، والضرب في الأرض على غير هداية . قال أبو عبدالرحمن : وجرى جُمَّاع اللغة على تعريف الحدس بالتخمين والظن، والرجم بالغيب . وتعريفه بالظن صحيح لغة، ولكنه مجامجاز، والأصل ما أسلفته . إذن الحدث التي نتيجته الإصابة أعرق استعمالاً، وأقدم، فكان ذلك دليلاً على أن الحدس في أصل وضعه إصابةُ جُهلت أو خفيت وسائط الوصول إليها . قال أبو عبدالرحمن : المرجَّح عندي أن الحدس بمعنى إصابة الحقيقة بلا وسائط فكرية وحسية . ولما كان الحادس لا يفسر إصابته الحقيقة ببراهين ووسائل فكرية اتبر حدسه ظناً بغض النظر عن إصابته، والظان يصيب ويخطئ . إذن المعنى الحقيقي الأولي الوضعي الجامع للحدس هو الإصابة بلا مقدمات فكرية . ثم استعمل الحدس مجازاً بمعنى الظن، لأن الحادس لا يفسر حدسه بمقدمات فكرية، فكانت صفته صفة من يظن ظناً . والبرهان على هذا التأصيل أن أكثر معاني هذه المادة ثبوتية لا سلبية، فالحدس رمي، وقلما يوصف أحد بالرمي إلا بصفة الإصابة . وهو سرعة سير، ولا يوصف بالسرعة إلا من وصل إلى غايته. أما من أخطأها فلا يوصف بأنه أسرع إلى المتاهة . والحدس نظر خفي، فَوَصْفُه بأنه نظر وأنه خفي كناية عن إعجازه، ومن أخطأ لا يُمجَّد نظره بأنه خفي . وإنما كان خفياً لأن الحادس نفسه قد لا يعرف كيف أصاب، ومن معاني الحدس الثبوتية القصد، ومن كان اتجاهه غير منتج لا يوصف بأنه قاصد . ومن المعاني الثبوتية الوطء والغلبة، والحداس الغاية، والمحدس المطلب، والفراسة . ولا يوصف أحد بالفراسة إلا مع الإصابة . وطلب الأخبار بخفية تحدس، وذلك أخذ من خفاء وسائل الإصابة في الحدس . وحَدَس صوت تستجيب له البغال يخرج عن قصد الواضع، فهو حكاية صوت لا يطلب معناه من المعنى الحقيقي الأولي . والتفسير ببغَّالي سليمان عليه السلام نقل مرسل يدخل في باب الميتافيزقيا اللغوية، فلا يقبل إلا ببرهان توثيقي . فهذه جمهرة معاني الحدس اللغوية، وكلها ثبوتية،فهل يعد هذا يقال: إن الأصل في الحدس ظن ؟!. والحدس لا يكون إلا صائباً، ومع هذا نضطر إلى ثنائية حدسٍ نصفه بأنه صائب، وحدس نصفه بأنه خطأ . وأما المعني الفلسفي فقد ذكر ابن سينا في كتابه "النجاة" الحدس بمعنى سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول، ومثَّل بمن يرى تشكل استدارة القمر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس، فيحدس أنه يستنير من الشمس . ويصف الحدس في كتابه "التعليقات" بأنه يسنح للذهن دفعة واحدة . ويقول الجرجاني "الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب . ويقابله الفكر . وهي (أي الحدسيات، أو المطالب المكتشفة بالحدس) أدنى مراتب الكشف" (35) . وتقيد بمثال ابن سينا فقال عن الحدسيات"هي ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة بتكرر المشاهدة كقولنا : القمر مستفاد من الشمس لاختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قرباً وبعداً" اهـ . وسياق أبي البقاء الكفوي يقضي بأن الحدس قوة لا تنتج ظناً، فإنه قال عن الإدراك "واعلم أن أول مراتب وصول العلم إلى النفس الشعور، ثم الإدراك، ثم الحفظ . وهو استحكام المعقول في العقل . ثم التذكر وهو محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات . ثم الذكر وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن . ثم الفهم وهو التعلق غالباً بلفظ من مخاطبك . ثم الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه . ثم الدراية وهي المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات . ثم اليقين وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه . ثم الذهن وهو قوة استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة . ثم الفكر وهو الانتقال من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب . ثم الحدس وهو الذي يتميز به عمل الفكر . ثم الذكاء وهو قوة الحدس . ثم الفطنة وهي التنبه للشيء الذي يقصد معرفته . ثم الكيس وهو استنباط الأنفع . ثم الرأي وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها . ثم التبيُن وهو علم يحصل بعد الالتباس . ثم الاستبصار وهو العلم بعد التأمل . ثم الإحاطة وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه . ثم الظن وهو أخذ طرفي الشك بصفة الرجحان . ثم العقل وهو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة . والمدرك إن كان مجرداً عن المادة كإمكان زيد فإدراكه تعقل أيضاً، وحافظهُ ما ذكر أيضاً . وإن كان مادياً : فإما أن يكون صورة وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة . فإن كان مشروطاً بحضور المادة فإدراكه تخيل وحافظها الخيال . وإما أن يكون معنى وهو ما لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة، فإدراكه توهم، وحافظها الذاكرة(36) كإدراك صداقة زيد وعداوة عمرو، وإدراك الغنم عداوة الذئب.(37) ولابد من قوةٍ أخرى متصرفة تسمى مفكرة ومتخيلة" (38) . فالحدس عنده عمل فكري قوته الذكاء. على أن تعريفه خارج عن المعاني اللغوية. واستعمل ديكارت وغيره الحدس بمعنى رؤية القلب المباشرة . قال أبو عبدالرحمن : كل هذه المعاني الفلسفية جاءت عن وعي لغوي بالمعنى الحقيقي الأولي، لأنها راعت الإصابة بسرعة . وجاء الحدس بمعانٍ ألصق بالنظرية الأدبية لدى الفيلسوف اليهودي الفرنسي برجسون، والفيلسوف الإيطالي بندتوكروتشه. وبرجسون فيلسوف يهودي مراوغ يعمل في برنامج الصهيونية السياسية التي تسعى إلى خلخلة حقائق العقل والعلم، المادي، ونشر الإلحاد، ومزج الغوغائية بالريح . وجوهر مذهبه المادية المتهالكة تاريخياً التي تزعم أن الكون وجود واحد ينحل ويتركب (في صور أخرى تلقائياً . وغاية) هذه الفلسفة إلغاء الثنائية بين خالق ومخلوق، ونفي خالق لهذا الكون . وهو يراوغ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في تكريس الإلحاد بحيلتين : أولاهما : أنه يستعمل لفظ الجلالة بمعنى احتمالي، كما يستعمل سبينوزا اليهودي لفظ الجلالة في كتابه "رسالة في السياسة واللاهوت" بعد أن أفرغه من مضمونه الذي جاءت به الأديان السماوية. فالأخلاق الوضعية، والدين الوضعي - اللذان يصفهما بأنهما مفتوحان - لهما دافع عند برحسون يسميه المحبة ولا يدري أهي (أي المحبة) الله ذاته، أو صادرة منه ؟!. وهما على نقيض الأخلاق العقلية السماوية، والدين السماوي اللذين وصفهما بالانغلاق . وأخراهما : أن فلسفة الحدس والديمومة مغلفة بالميتافيزيقيا والمجازات بحيث تأتي فلسفة المادة الإلحادية دساً وتسويلاً!!. إن برجسون يصطنع مضغه الفلسفي من ثنائية الحركة والسكون في المحسوس من هذا الكون . فالسكون ظرفه المكان، والحركة ظرفها الزمان . قال أبو عبدالرحمن : وهذا الفصل بهلواني، بل المكان والزمان ظرفان متلازمان، فالمكان الحيز، والزمان هو المقياس الآني للحركة أو السكون في الحيز . ويزعم برجسون أن معرفة العقل دونية، لأنها تفكير في الأشياء السكونية المتجاورة في المكان. ولا يدرك العقل المتغيرات المتعاقبة التي تحدس في الزمان. إذن معرفة العقل تحليل وتصنيف، وهو يجعل للأشياء حيزاً مكانياً، ولهذا فالصورة المثلى للتفكير العقلي إنما هي الهندسة . والمعرفة العليا عنده معرفة الحدس الذي هو خبرة فعلية بالتغير (أي الحركة) . وهذا التغير الذي لا يدركه العقل ويدركه الحس تغير في الزمان لا ينقطع، ولهذا وصفه بالديمومة. وخبرة الحدس به إدراك للطابع الكيفي للوعي الداخلي وتياره . فإدراك هذا الطابع هو الحدس . ولا تجد في تعريفه لما يدركه الحدس برهاناً، بل تجد الدعوى تلو الدعوى . ولا تجد في تعريفه مفهوماً لغوياً واضحاً، بل تجد المجاز تلو المجاز . والفلسفة لا تقوم على المجازات، بل لابد من لغة عرفية عامة مفهومة، أو اصطلاح خاص محدد بلغة مفهومة . وإنما الواضح بعد كل المراوغات سوق القارئ إلى الفلسفة المادية . والمحصلَّة أن الطابع الذي يدركه الحدس تغيُّر غير قارٍّ (ديمومة) نشهدها في النفس ـ الوجدان - الوعي- الذاكرة) لتشهد لنا أن الطبيعة قوة تتبدد في صور من التركيب (أي المتجلية للعقل في المكان) . وهذه الصورة تختزن الطاقة، وتحتفظ بقوة نموها (39) وأمدية تكيُّفها. (40) ثم تعود إلى صورة أخرى في تركيب مشابه . فقوانين المادة هي التي تحوِّل الكون إلى صور وأشكال، ويضاد قانون المادة دفعة الحياة التي يحافظ بها الجزئي من الكون على ما هو عليه بمقدار أمد اختزانه للطاقة ومحافظته على نموها . ومن خبث هذا اليهودي أنه أعفى نفسه من مهمة التعبير بالعرف السائد، أو الاصطلاح المحدد، لأنه لا يريد حقيقة ، وإنما يريد التعويم . وقد تُرجم قليل من كتب هذا الفيلسوف مثل "منبعا الأخلاق والدين"، و "الفكر والمتحرك". وامتلأت المكتبة الفلسفية العربية بعرض أفكاره في كتب الدراسات الفلسفية، ومعاجم الفلسفة والفلاسفة، وكتب المصطلحات . والعرض إما من عربي غير متدين، أو من متدين غبي لا يربط الفلسفة بجذرها الديني أو الإلحادي ، ويفصل الفلسفة عن تاريخ الفيلسوف، ويحمل الأمر على التفلسف الصادق فلا يتنبه للمغالطات، والمراوغات، وإفراغ الألفاظ من مضامينها. وبعض العرض فهم سطحي يكتنفه الغموض والاختصار المخل . خاصة إذا كان الكتاب عالة على غيره ككتاب "موسوعة أعلام الفلسفة" للرئيس شارل حلو، فهو (إضافة إلى كل تلك العيوب) (41) سطو على "الموسوعة الفلسفية الميسرة"، وعلى "موسوعة الفلسفة" للدكتور عبدالرحمن بدوي . وقد داهن برجسون النصاري إذ أعلن في فقرة من وصيته التي كتبها في 8 فبراير سنة 1937 م : أنه كان ستحول إلى الكاثوليكية لولا أنه شعر بمقدم موجة عارمة من معاداة السامية، فأداه ذلك إلى أن يقف إلى جانب يني دينه اليهود . وحتى لا يساء فهم فعله إن تحول إلى الكاثوليكية . قال أبو عبدالرحمن : إن النخبة الممتازة من مفكري العالم - لا مفكري العروبة فحسب - لعبة بين المضغ الدارويني والدركايمي والماركسي والفرويدي والبينوزي والبرجسوني والسارتري والكافكي . وهذا المضغ في شد وجذب، وإبرام ونقض، لأن أقطاب الصهيونية السياسية يعون ما يفعلون لتضليل الجوييم . يشهد بذلك شذرات التلمود، ومسار التاريه للأمة الغضبية، والبروتوكولات . ومن اعتبر كل ذلك خرافة فعلى الله العوض . ثم يأتي هذا الطرح المتسلح بمغالطات العلم - اكتشافاً ةاختراعاً - فيتلقاه الفلاسفة من غير دائرة الصهيونية السياسية ببناء فلسفي صادق لا يقدِّر حقيقة التضليل . ويتلقاه الحاوون على أنه تفلسف صادق . والإلحاد لم يكن قط نتيجة علم مادي، ولا نتيجة تفكير عقلي صادق التحري،وإنما الإلحاد وليد حريتين إراديتين، وليس وليد إيجابية فكرية : الأولى : حرية شبهات الفكر، وشحذه على صنع المغالطة، وهذا دور الأمة الغضبية في ميدان الفلسفة . والثانية : حرية شهوات النفس التي هي شهوات الفكر في التفلسف، وهذا دور الأمة الغضبية في الفلسفة والفنون الجمالية والقانون والإعلام والأخلاق وتفسير الأديان . ويأتي الحاوون وصادقوا التفلسف، فربما بدت لهم الشهوات والشبهات حقائق، وربما عجزوا عن النهوض من بؤرة الشهوة، وربما عجزوا أيضاً عن التحرر من نير الشيهة لقوة الإعلام في عملقة قزم وتقزيم عملاق، ولسياط الإرهاب الإعلامي بألفاظ مثل الرجعية والتخلف، وما أشبه ذلك مما يئد الجسارة على قول الحق واعتقاده. |
|
|
#7 |
 |
والتدين نفسه مما تصون عنه الفلسفة الحديثة مفكريها . ومن بركات المضغ البرجسوني هذه الفكرة الإلحادية الرائعة من كتاب "التطور الخالق" : "الذكاء تكوَّن بتقدم متواصل على طوال خط يتصاعد خلال الحيوانات الفقرية إلى الإنسان . وإن ملكة الفهم وهي ملحقة بملكة العقل هي تكيفُ تزايد في الدقة والتركيب والمرونة لشعور الكائنات الحية مع ظروف الوجود المهيأة لها . ومن هنا فإن الذكاء (العقل) وظيفته هي غمس الجسم في الوسط الذي يعيش فيه، وامتثال العلاقات الخارجية بين الأشياء بعضها وبعض، والتفكير في المادة" . قال أبو عبدالرحمن : فهو يستعير من أخيه دارون فكرة تطور الإنسان من قرد . وهي الفكرة المكذبة لخالق الإنسان والقرد الذي أخبر أنه خلق آدم عليه السلام من تراب، وأنه أبو البشر.(42) لا بشر قبله، وأنه نبي كريم أهبط إلى الأرض في كمال الخلق بفتح الخاء، والخلق بضمها، والدين، والمعرفة، والتربية. ويلزم من هذا أن الفرد في الجاهلية أذكى وأعقل وأعرف من صناع الأهرام لأن الجاهلي جاء في سلسلة التطور . وأن الهمجي من قوم عاد أذكى وأعقل وأعرف من صناع الأهرام، لأن الجاهلي جاء في سلسلة التطور . وأن الهجمي من قوم عاد أذكى وأعقل وأعرف من نوح عليه السلام ومن آمن معه، لأن العادي أيضاً جاء في سلسلة التطور !!. والدين عند برجسون استاتيكي، وديناميكي. فالأديان السماوية استاتيكية ناشئة من الأسطورة، والخرافات ، والامتثالات الخيالية. والبقاء بعد الموت ترياق يضعه الاعتقاد الديني . أما الدين الوضعي (الديناميكي) - وهو الدين الحق عند برجسون- فهو التصوف النصراني . لا التصوف اليوناني، لأنه عقلي !. وليس هو حب الإنسان لله، بل هو حب الله للناس . فجعل الرب عابداً، والمربوب معبوداً !!. ويلي ذلك إلحاد وسفسطة بأسلوب مجازي، فمذهبه أن عقلنا غير قادر على إدراك الطبيعة الحقيقية للحياة، والمعنى العميق لحركة التطور . وأنِّي له أن يدرك الحياة، وما هو إلا جزء منبثق عن الحياة، وخلقته الحياه في ظروف معينة ليعمل في ظروف معينة؟. لو كان ذلك في مقدوره لكان معناه أن الجزء يساوي الكل، والمعلول يمكن أن يمتص علته، ولجاز أن يقال : إن المحارة ترسم شكل الموجة التي حملتها إلى الشاطئ . والواقع أننا نشعر بأن كل مقولاتنا العقلية لا تنطبق على الحياة : من وحدة وكثرة، وعليِّة آلية، وغائبة ذكية . وعبثاً نحاول أن نولج ما هو حي في هذا الإطار أو ذاك، فإن كل الإطارات تنكسر، لأنها ضيقة جداً، قاسية جداً . خصوصاً بالنسبة إلى ما نريد إدخاله فيها . قال أبو عبدالرحمن : لست والله أعلم في أي عقل وجد برجسون أن العارف يساوي المعروف حتى يلزم من معرفة الجزئي للكلي أن تالجزء يساوي الكل ؟!. ولست أعلم في أي عقل وجد أن الموجود المعلول يمتص علته إذا علم علة وجوده؟!. ولا أحد يدعي أن العقل يعلم كل حقائق الوجود، وإنما يعلم ما غاب عنه من خلال ما حضر عنده من مدركات الحس، فيكون علمه علمَ أحكامٍ كلية من خلال أفكاره الفطرية التي لا يخطو العلم دونها، ومعرفةَ وجودٍ لبعض الأشياء، وعلمَ وصف (لا تكييف) من خلال أحكامه الفطرية الخالصة . ومن خلال آثاره الموجود المشاهدة . وهو علم كيفية وكمية لما يخضع لإعادة إحضار المعرفة بالحس المكرر (التجربة) . وليس في سياق برجسون ما يقتضي تمثيله الفضولي بالمحارة وشكل الموجة، ولا دلالة ألبتة في هذا المثال على نفي معرفة العقل لما هو جزء منه، وهو الطبيعة . وبرجسون يتحدث باسم العلم افتراء، وذلك عند نفيه السكون، والتجزؤ في المكان، ورد البدهيات التي تميز الموجودات من وحدة وكثرة، ورد البدهيات في وصف المعلوم من الكون وتفسيره بالعلية والغائية . وحجته المادية الإلحادية أن الكون في حركة دائبة، وتغير، وصيرورة . ولازم فلسفة برجسون حينئذ - وهذا ما صرح ببعضه كثيراً - أن العقل لا يحدد مفهوماً، وأن المكان لا يمسك جزءاً ولا سكوناً، لأن ما نحسبه سكوناً وجزءاً وتحيزاً في توالي المتغيرات مدفوع إلى صيرورة جديدة . وهو يدفع نفسه بنفسه . قال أبو عبدالرحمن : ومع أننا لم نحصل على برهان من برجسون، وإنما حصلنا على الدعوى والمجاز:(43) فليكن البرهان من جانبي تطوعاً، وهو أن دعوى المؤمنين بالله هي الدعوى الموافقة للعلم، وموجزها أن الإنسان العارف غير محيطة معرفته بالكون، وأن ما أذن الله له بمعرفته على كثرته بعقولهم ووسائلهم الحسية معرفة كمية وكيفية مشاهدة، أو معرفة متعاقبة الكيفية في المشاهدة لا يحصيها العد كماً، ولا الوصف كيفاً . وهذه المعرفة لا تخلو من أحد أمرين : أحدهما : مفعول مشاهد يحصره المكان، ويتجزأ فيه . وتلك معرفة حقيقية . وعلى فرض وجود أي ميتافيزيقيا علمية تدعي أن المتجزئ المتحيز في المكان في حركة وتغير وترقب لصيرورة : فلا ريب أن معرفته على ما هو عليه من سكون مشهود، وتغير غير ملحوظ معرفةُ حقيقية مقيدة بحالتها ووصفها . وثانيهما : فعل في المفعول كالتخلق والنبات، وتلف خلية وبناء خلية . إلخ . فدعوى هذا العقل تقبل ببرهان علمي، وهي لا تنفي المعرفة بالمفعول على ما هو عليه . واستعاض برجسون بالمجاز عن البرهان في بهرجة دعواه، ولهذا قال الدكتور عبدالرحمن بدوي بعد السياق المذكور آنفاً "ويستمر برجسون في بيان تطور الحياة مستخدماً صوراً وتشبيهات شعرية، مما باعد بينه وبين اللغة العلمية والوثيقة التي استعملها البيولوجيون، وهو أمر جعله هدفاً سهلاً لسهام خصومه" . قال أبو عبدالرحمن : لا يهم برجسون سهام خصومه، لأنه في مجال مكابرة الحقائق، ولأن أهل الخصوصية العقلية قلة في المجتمعات . وإنما يهمه كثرة من يصطاده من أنصاف العقلاء . والأجهزة الصهيونية السياسية التي تملك التلميع بالمال والإعلام قادرة على جعل الفكر العفن للملمَّع - بصيغة المفعول - مظهر كمال فكري يتربى عليه أنصاف العقلاء، فيتنازلون عن النصف الآخر تهيباً من معارضة فكر حضاري !. ويشفع برجسون سياقه بأضخم دعوى طفولية، وهي أن الإنسان يخلق بعضه، وهو متكون من مخلوقات الطبيعة على مدى سنة التطور !. يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي في سياقه لمذهب التطور لدى برجسون : والغريزة التامة ملكة استخدام وبناء آلات عضوية، والعقل التام هو ملكة صنع واستعمال آلات غير عضوية . ويقصد بكلمة "عضوية" هنا أنها تصلح نفسها بنفسها، بينما غير العضوية لابد أن يصلحها فاعل آخر غيرها . ويقول برجسون في التطور الخالق : بالنسبة إلى الوجود الواعي أن يوجد هو أن يتغير، وأن يتغير هو أن ينضج، وأن ينضج هو أن يخلق نفسه باستمرار . إن الكون يعاني المدة، المدة معناها الاختراع وخلق الأشكال، والصنع المستمر لما هو جديد على وجه الإطلاق . والمدة تقدم مستمر من الماضي الذي يعرض المستقبل وينتفخ وهو يتقدم . وأينما حي شيء : فثم يوجد . في مكان ما سُجِّل : يُسجَّل فيه الزمان . إن استمرار التغير، والاحتفاظ بالماضي في الحاضر، والمدة الحقة .. هذه الصفات مشتركة بين الشعور وبين الكائن الحي . إن الحياة تلوح كتيار يمضي من جرثومة إلى أخرى عن طريق كائن عضوي متطور . قال أبو عبدالرحمن : أسلفت نوع المعرفتين، وهما معرفتنا لسكون الشيء حينما لا نلاحظ بأي وسيلة علمية حركته وتغيره، فهي علم حقيقي بما هو عليه في صيرورته، وهي علم بمفعول . ومعرفتنا للشيء حال تغيرة وسيره إلى صيرورة أخرى، وهي معرفة بالفعل خلال المفعول، ومعرفة بالفعل حال حركته . وكل معرفة لا تنفي حقيقة المعرفة الأخرى . والعلم بالتغير والحركة لا يثبت في كل شئ، ولا يُنفي عن كل شئ، بل الإثبات والنفي رهن البرهان العلمي . ولكن برجسون ينفي قدرة وإرادة وعناية المقدِّر للحركة والسكون سبحانه، فيجعل الكون في عملية خلق دائبة من قبل نفسه . قال الدكتور عبدالرحمن بدوي : ومن الأفكار الأكثر أصالة في فلسفة الحياة عند برجسون فكرة السورة الحيوية، ومفادها أن الحياة منذ نشأتها هي استمرار لسورة واحدة توزعت بين خطوط مختلفة للتطور . لقد نما شيء، وتطور بسلسلة من الإضافات التي كانت ألواناً من الخلق . وهذا النمو نفسه هو الذي أدى إلى انفصال الميول التي لم تكن تقدر على النمو بعد نقطة معلومة دون أن تصير غير متوافقة فيما بينها. لا شيء يمنع من تخيل فرد وحيد فيه.(44) بسلسلة من التحولات المتوزعة على آلاف القرون يتم تطور الحياة . أو إذا انعدم وجود فرد وحيد : يمكن أن نفترض كثرة من الأفراد يتوالون في سلسلة على خط واحد . في كلتا الحالتين لن يكون للتطور غير بعُد واحد . لكن التطور تم في الواقع بواسطة ملايين من الأفراد على خطوط مختلفة كل منها أفضى إلى تقاطع.(45) منه تفرعت طرق جديدة، وهكذا باستمرار إلى غير نهاية . وعبثاً حدثت تقاطعات، فإن حركة الأجزاء استمرت بفضل السَّرة الأولى للكل . فشيء من الكل يجب إذن أن يبقى في الأجزاء . وهذا العنصر المشترك يمكن أن يكون محسوساً للعيون على نحو معين . ربما بحضور أعضاء واحدة في أجهزة مختلفة كل الاختلاف . قال أبو عبدالرحمن : صدق الله وكذي برجسون، فهناك حقيقتان : أولاهما : أن الخلق منذ آدم ما زال ينقص . بهذا جاءت الأديان السماوية خلافاً لدارون وبرجسون . وأما التطور سلوكياً وعقلياً وعلمياً فالتاريخ في صعود ونزول، ونزول وصعود . حيث يكون الاتِّباعُ للأنبياء عليهم السلام، والمصلحين، وحقائق العلم والعقل . أو عدمه . وثانيهما : أن التطور في مراحل عمر الفرد، ولم يأت تطور الفرد في مراحل أعمار الأجيال . وقال الدكتور عبدالرحمن بدوي عن نظرية المعرفة عند برجسون التي هي إما منطقية وإما حدسية : لكن هذا الوجدان ليس وليد الغريزة، بل هو وليد التفكير العقلي المتواصل، والتأمل الفكري المستمر، وحشد الوقائع العلمية السليمة، ومقارنتها بعضها ببعض . والعقل هو الذي يحقق الوجدان ويجعله محدداً، وينميه في قول منطقي . قال أبو عبدالرحمن : إذن المعرفة الفطرية ذات مصدرين : معرفة غريزة صفتها عنده أنها تصنع نفسها بنفسها، ومعرفتها معرفة بالمادة، وهي معرفة شيء . ومعرفة عقل، وهي معرفة علاقة بين شيئين أو أشياء، فمعرفة العقل معرفة بشكل المعرفة ؟!. وبرجسون هاهنا ادعى على الغريزة ما ليس فيها، واعى أن سلوكها معرفة . والسلوك غير المعرفة . وإنما الغريزة طبيعية مخلوقة في الشيء صفتها الميول والنزوع والاستجابة . ولا يوصف نزوعها بأنه معرفة، وإنما هي من علم الخالق وقدرته . ومن الغرائز ما هو ذو نفع للشيء، وقد جعل الله استجابته ونزوعه حتمياً مدة بقاء ذلك الشيء، للاحتفاظ ببقائه. ومنها ما هو ذو نفع وضر، فتتضارب وتتعارض، كنوازع الأنانية والإيثار، والغضب والرضى . إلخ . والسلوك الحر ينتج عن الاستجابة لإحدى هذه النوازع، ولم يجعل الله كل نازع حتمياً، بل جعله الله لحرية الفرد تطويع النازع بالتعويض والتربية والاحتكام للعقل. وثنائية المعرفة بين الغريزة والعقل من كيس برجسون، وإنما الثنائية بين الوجود والمعرفة . وتحقق وجود الشيء لا يُشترط بتحقق معرفته. إلا أن المعرفة لا تكون معرفة إلا بحكم العقل، فما يحصل بالحس الباطن وجدان، وما يحصل بالحس الظاهر وجدان، وما روى بالخبر وجدان سمعي، ولا يكون معرفة إلا إذا أثبت العقل صورته أو حكمه . إذن المعرفة عقلية فحسب، وتكون عقلية بالحس، وعقلية بالشرع، وعقلية بالإلهام والحدس، لأن العقل صححها بعد وجدانها . وإسناد الصناعة إلى العقل لا معنى له إلا على سبيل المجاز، بمعنى أن الصناعة تتم بعقل سابق، وعقل مصاحب، وعقل متابع . والمجاز لا تبني عليه الفلسفة . وليس بصحيح أن معرفة العقل معرفة علاقات فحسب، بل هي معرفة أشياء بتصوراتها ومنافعها وأضرارها وبقية أحكامها، ومعرفة العلاقات والفوارق بين الأشياء كالقبل والبعد والطول والقصر والشبهية والضدية . إلخ . والمعرفتان اللتان مضتا دونيتان عند برجسون، وإنما المعرفة العليا ما صدر عن ملكة الوجدان (العيان الميتافيزيقي). قال أبو عبدالرحمن : ليسمِّ برجسون الوجدان بما شاء من خلق وديمومة، وليسم معرفته بالحدس أو العيان، فالمحقق أنه وجدان حتى تصدر صورته أو حكمه عن العقل . ومع عزوب العقل لا معرفة . وقال برجسون في كتابه عن "الفكر والمتحرك" ومهما تكن بساطة العيان . هذا الوجدان : فإن فيه من الخصوبة والثراء ما يجعله حافلاً بالمعاني والنتائج بحيث لا يستكشفها إلا بعد جهد طويل يبذله في المشاهدات والتجارب، وإجراء العمليات المنطقية ، وبهذا الجهد يُخضع هذه الفكرة للامتحان الدقيق الذي بدونه لن تحظى فلسفته بأي اعتبار . والعيان هو وحده القادر على فهم الحياة، وإدراك ما هو حي ومتغير ومتحرك في المدة" . قال أبو عبدالرحمن : هذا تلاعب باللغة الموصلة، وإفراغ للفظ من مضمونه اللغوي، والعرفي العام، والاصطلاحي الخاص، وشحن له بدعاوى جديدة ولا يسلك هذا إلا متلاعب بالعقول . والوجدان شيء، وعيانه شيء آخر. والوجدان هو مصدر المعرفة، وليس هو هي. وما ذكره عن الوجدان هاهنا إنما هو كلام عن مصدر المعرفة، وهو كلام عن نوع من الوجدان خصيب . وقد يكون الوجدان أمنيات وأوهاماً وإرثاً حسياً خاطئاً. والزمان عند برجسون آنية (أي آنُ غير قادر- متحرك لا ساكن . لا مدة) . يقول في مذكراته التي كتبها من أجل وليم جيمس عام 1908 م : فلشدة دهشتي أدركت أن الزمان العلمي لا يتصف بالمدة، وأنه ما كان ليتعين شيء في معرفتنا العلمية بالأشياء لو أن مجموع الواقع قد نشر في لحظة، وأن العلم الوضعي يقوم جوهرياً في استبعاد المدة . ولهذا فمفتاح فلسفته عيان المدة حركة وتغيراً وصيرورة .وحقائق هذا المفتاح : 1. أن الحركة غير قابلة للقسمة بخلاف مكانها ومسارها، وأنها كيفية لا كمية . وإنما ضل زينون بتوحيده هوية المكان والحركة . 2. التغير لا يجري على موضوع ثابت، بل التغير هو المتغير. فلا توجد متحركات تتحرك . بل يوجد حركات تتحرك !!. قال أبو عبدالرحمن : سلف الحديث عن نوعي المعرفة للمفعول غير ملحوظة حركته، وللفعل حال ملاحظة الحركة والتغير . بيد أن برجسون يختفي وراء الحسبانية والسفسطة . وهي سفسطة شرسة حيلتها إسقاط هوية الأشياء ولا هوية إلا باستقرار ينظِّم الأشياء حسب الماضي والحاضر والمستقبل . ولكن التوالي (المعية) بين هذه الأزمان يجعل الأشياء في حركة وتغير وصيرورة تذوب معها الأزمان كذوبان نغمات الجملة الموسيقية في بعضها . ولهذا وصف المدة غير القارة بأنها خلاقة . وتتجلى هذه السفسطة في إنكار مبدأ العلية، لأن شرط اعتقاد هذا المبدأ وجود العلة والمعلول في هويتين منفصلتين . بيد أن الزمن خلق واختراع دائب لا تنفصل معه هوية . ومن السفسطة رفض البدهيات دون تحديد بديل مفهوم، فحينما ضخَّم الدعوى بأن الأحوال العقلية والنفسية لا يتلو بعضها بعضاً كالتتابع بين العلة والمعلول، وأنه لا يعيِّن بعضها بعضاً : رفض تميز الأنابهويات متعينة من وقائع الشعور . من إحساسات، وعواطف، وأفكار . وها هنا لا يحدد بديلاً . وليس العجب من مثل المستوعب الرائع الدكتور عبدالرحمن بدوي الذي يستعرض مثل هذه الأفكار من مصادرها الأصلية بلغة مؤلفيها، ويجريها كلها على صدق التفلسف !!. ومن السفسطة الشرسة جعل النوازع المريضة التي تخل بالسلوك صيرورة لا مفر منها . فالإنسان ليس بين عاطفتين متضادتين يختار إحداهما برياضة وتربية . وإنما هو في حركة دائبة وصيرورة، فالإنسان يحيا بالعاطفة الأولى ثم يتغير حين تطرأ العاطفة الثانية . ومن سفسطاته دعوى أن الامتداد أسيق من المكان . وكذلك بقاء الروح بعد الجسد، فهو عنده احتمال في احتمال !!. ورد الثوابت - لا مجرد الشك - ضرورة فكرية في الفلسفة البرجسونية .. يقول "أمام الأفكار المقر بها دائماً، والمقالات التي تبدو بينة، والتوكيدات التي كانت تدعى حتى ذلك الحين علمية : فإن هذا العيان الجديد يهمس في أذن الفيلسوف بكلمة : مستحيل" . قال ابو عبدالرحمن : ولو كان الأمر شكاً توسلياً بنَّاء لكان الشك مرة في العمر في كل توكيد جديد حتى يقوم البرهان على أنه من الثوابت . وعن تقسيم برجسون للذاكرة يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي في موسوعت: "تناول برجسون مسألة الذاكرة في كتابه المادة والذاكرة سنة 1869 م، فميز بين نوعين من الذاكرة : الذاكرة العادة، والذاكرة المحضة . الأولى يمكن أن تقيم في الجسم، وهي مجرد\ تركيب لحركات . أما الذاكرة المحضة فهي وظيفة للروح (أو العقل)، وهي التي تمنحنا رؤية ارتدادية لماضينا. ويضرب مثلاً على الأولى حفظ قصيدة ، وعلى الثانية استحضار الذهن لدرس سمعه . فنحن في الحالة الأولى بإزاء عادة، لأن الحفظ يقوم في تكرار مجهود واحد هو ترديد القصيدة مرة تلو مرة . أما في حالة استحضار درس سمعناه فإن ذاكرة قد سجلت مرة واحدة، وكأنه حادث وقع لي . إنه مثل حادث في حياتي، وماهيته تقوم في أنه يحمل تاريخاً، وبالتالي لا يمكن أن يتكرر . والشعور يكشف لنا عن اختلاف في الطبيعة بين هذين النوعين من الذاكرة . ذلك أن ذكرى درس سمعته هو امتثال (وامتثال فحسب) أستطيع أن أطيله، أو أن أقصره، وأستطيع أن أدركه بنظرة واحدة وكأنه لوحة . أما القصيدة المحفوظة فإن تذكرها يقتضي زمناً محدداً هو زمن إنشادها بيتاً بيتاً، إنه ليس امتثالاً، بل هو فعل. والقصيدة بمجرد حفظها لا تحمل أية علامة تدل على منشئها وموضعها من الماضي . إنما صارت جزءاً من حاضري، وعادة من عاداتي مثل المشي. وبالجملة فإن الذاكرة الأولى تسجل على هيئة صور ذكريات كل أحداث حياتنا اليومية كلما جرت، ولا تغفل أيه تفاصيل، وتترك لكل واقعة مكانتها وتاريخها دون أيه نية للمنفعة أو التطبيق العملي، فإنها تختزن الماضي بتأثير ضرورة طبيعية . وبفضلها يشير التعرف الذكي (أو بالأحرى العقلي) على إدراك قمنا به من قبل، وإليها نلجأ في مرة نصعِّد منحدر حياتنا الماضية بحثاً عن صورة من الصور . لكن لكل إدراك يستطيل إلى فعل ناشئ، وبقدر ما تثبت الصور بعد إدراكها، وتصنف في هذه الذاكرة : فإن الحركات التي تواصلها تعدل الجهاز العضوي، وتخلق في الجسم استعدادات جديدة للعقل . وعلى هذا النحو تتكون تجربة من نوع خاص جديد يستقر في الجسم، وشلشلة من الميكانسمات المركبة، وردود فعل متزايدة العدد والأنواع ضد المهيجات الخارجية، مع(46) أجوبة حاضرة عن عدد متزايد باستمرار من استجوابات ممكنة. ونحن نشعر بهذه الميكانسمات حين نأخذ في العمل، وهذا الشعور بماض من المجهودات المختزن في الحاضر هو أيضاً ذاكرة . لكنها ذاكرة مختلفة عن الأولى كل الاختلاف، متوجهة دائماً إلى الفعل، وقاعدة في الحاضر، ولا تنظر إلى المستقبل . وهي (أي الذاكرة الثانية . أي المحضة) التي تمثل منها المجهود المكدس . وهي لا تلغي هذه المجهودات الماضية في الصور (الذكريات) التي تستعيدها، بل (47) النظام الدقيق والطابع المنظم اللذين بهما تتم الحركات الحالية . |
|
|
#8 |
 |
والحق أنها لا تمثل لنا ماضياً، بل تلعب دوره (48) . وإذا كانت لا تزال تستحق اسم ذاكرة فلبس ذلك لأنها تحتفظ بصور قديمة، بل لأنها تطيل أثرها المفيد حتى اللحظة الحاضرة" . قال أبو عبدالرحمن : دعوى ذاكرتين ذات مكانين من ابن آدم دعوى ليست في خبرة جيل مأثورة، ولا من نتائج علم راهن . ولكنك تقول مجازاً، أو تخيلاً، أو مبالغة : فلان يعيش بذاكرتين، أو ثلاث، أو عشر . وما عدَّده برجسون ليس في حقيقته تقسيماً للذاكرة، وإنما هو ذكر لبعض أنواع عمل الذاكرة، وأنواع ما يحصل تذكُّره . وما ذكره عن حفظ القصيدة وصف لعملية الحفظ وليس تمييزاً لذاكرة أخرى . والقصيدة كالدرس تحمل مضامين حياتية لأنها ترتبط بمكان وزمان وفعل، وربما ارتبطت بمشاركة زملاء . والحفظ مع الفهم والوعي يُحدث أيضاً ما يحدثه وعينا وفهمنا لدرس سمعناه، فنمتثلها منفعة وسلوكاً . وإذا فصدت استرجاع معانيها كان حكمها حكم الدرس فحسب . وهكذا قل عن قصدك من استرجاع الدرس. وكل فرق زعمه بين الذاكرتين المزعومتين فهو لغو كلامي لا يحقق وجوداً عيانياً. والحدس عند برجسون معرفة عليا مقدسة تدرك المطلق، وتفوق المعرفة المنطقية العقلية !. قال أبو عبدعبد الرحمن : لا مجال لهذه الثنائية بين متفوق - بصيغة اسم الفاعل - ومتفوق عليه . بل الثنائية بين معرفة مباشرة بلا وسائط تكون وعياً روحياً، أو بدهية عقلية . وبين معرفة عقلية بوسائط . وكون معرفة أسهلَ من معرفة : لا يعني أن الأسهل أصح وأصوب ، وقد بينت مراراً أن 2+2= 4 في درجة 479×395= 189205 من ناحية الصحة (49) وإن كانت النتيجة الأولى أسهل عملية ضربية !. والحدس في معناه اللغوي وصول إلى الحقيقة مباشرة إما بوعي، وإما ببداهة . والوصول مرفوض إلى الحقيقة مصادفة بلا وسائط صورته الحدس وليس حدساً، لأنه محض المصادفة، وليس فيه رؤية قلبية أو عقلية . ووصول الحادس إلى الحقيقة قد لا يستطيع الحادس تفسيره، ويكون دور المتلقى وتحليله النفسي تحقيق مصدر هذا الحدس : أهو وعي (رؤية قلبية، أو روحية) ، أم بداهة (رؤية عقلية) ، أم مذخور ذاكرة، أم مصادفة !!. ويظل عمل الحادس حدساً أو في صورة الحدس . ولا مجال البتة لزعم برجسون أن الحدس أعلى من المعرفة العقلية، لأن المعرفة الحدسية لا قيمة لها حتى يشهد العقل أو الواقع الحسي بوقوعها، فيحكم العقل حينئذ بأنها معرفة صحيحة جاءت عن طريق الحدس . وإدراك الحدس للمطلق يقتضي وقفة عند المطلق ما هو ؟ فهناك في عرف الفلاسفة المطلق المحض أو البسيط ويعرفونه بأنه "ما هو بذاته" وهو المستقبل بذاته، والمراد فاطر السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى . والله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ومعنى كل تسمية غير شرعية يؤخذ به أو برد بمقتضى الشرع والعقل . ومعرفة المطلق بهذا المعنى تكون حدساً، والحدس حينئذ بمعنى الوعي . وهو وعيه بفقره، ووعيه بكمال خالقه، والفزع إليه بداهة وضرورة . ولا يبدرك الحدس معرفة تفصيلية للمطلق بهذا المعنى أن يكون غير مشروط . أي بشرط الإطلاق . وهذا لا يحقق وجوداً، بل هو عدم محض . وهذا يبينه متكلمو أهل السنة والجماعة في نفي وجود ذات بلا صفات . ومن المطلق ما هو مطلق بذاته، أو مطلق بالنسبة إلى غيره، أو مطلق في جنسه. وأصحاب المذهب الحدسي لا يريدون هذه المعاني . وقد يريدون أعلى درجات المطلق لدى هيجل، وهو العقل الذي يتطور وينضج على مدى تاريخ الإنسان . قال أبو عبدالرحمن : والواقع أن الذي حصل بالتطور اتساع نشاط العقل باتساع معارفه، وكثرة الحقائق أمامه . وأما مسألة الخلق الفني فقد عبرت عنها بمصطلح جديد هو المضاهاة الفنية المبدعة . واخترت مواضعتي الجديدة انطلاقاً من حس ديني، (50) وغيره على الحقائق اللغوية . فأما الحس الديني فقد مر علىَّ تحليل أظنه لأبي حامد الغزالي يجيز إطلاق الخلق شرعاً على إبداع البشر، وعلى افترائهم . وهذا على سبيل المجاز . ولنا مندوحة عن استعمال الخلق لغير الله بما هو أدل حقيقة لا مجازاً . وأما الغيرة على حقائق اللغة، فلأن حقيقة الخلق إيجاد من عدم، والمخلوق لا يوجد غيره من عدم، وإنما يصنع ويعمل ويخترع من مادة مخلوقة . وفي ميدان الفن فجميع عناصره الإبداعية من الطبيعة المخلوقة . بالمواهب والملكات المخلوقة . وهي مضاهاة تتصف بالإبداع . وليس من شرط الإبداع الإيجاد من عدم بل إيجاد المعدوم البديع من عناصر مخلوقة . لقد وصف برجسون الحدس الفني بأنه فورة خلاقة . ومن حقه أن يفخر بهذه الصفة، لأن الإنسان عنده صانع قبل أن يكون عارفاً، والحدس هو المعرفة بعد الصنع؟!. وبيان ذلك أن العقل عند برجسون أداة فعل في ذاته، وهو يصنع أدوات تمكن من الفعل . والغريزة عنده قوة فطرية لاستخدام أدوات الطبيعة سواء أكانت أعضاءه هو ، أم كانت مواداً أولية في بيئته . والغريزة تكون حدساً إذا وعت ذاتها، وتنزهت عن الأغراض . وفوق العقل ملكة الوجدان القادرة وحدها على فهم الحياة، وإدراك ما هو حي ومتغير ومتحرك في المدة . ومع هذا التفريق والتمييز يجعل الوجدان محصلاً من العقل، لأنه وليد التفكير العقلي المتواصل، والتأمل الفكري المستمر، وحشد الوقائع العلمية السليمة . إلخ . والوعي يحتوي خبرة الشخص الماضية بأكملها . قال أبو عبدالرحمن : من ها هنا تتضح علاقة الحدس بالذاكرة . وعندما يجعل برجسون العقل في مرتبة دون الحدس معرفة وإبداعاً يفتات على المعرفة العقلية بجعله معيار الحقيقة فيها المنفعة، ويجعله العقل أداة للإنسان للتحكم في البيئة فحسب . ويحجٍّم العقل بأن معرفته نسبية، وأن اعتماده على الوصف والتصورات العامة لتساعد الإنسان في السلوك العملي . ويعملق الحدس بأنه يصل إلى المطلق، وأنه الوحيد الذي يدرك حقائق الشعور الباطني . ولهذا تشرح أميرة حلمي مطر فلسفة برجسون الحدسية بقولها "وحين يتصف الحدس بأنه نوع من التعاطف العقلي الذي نعرف به الشيء حتى نكشف ما هو فريد فيه، ولا يمكن وصفه أو التعبير عنه : تكون المعرفة التحليلية عكس ذلك، لأنها ترد الأشياء إلى عناصر مشتركة بينها وبين غيرها . وبذلك تكون أقرب إلى ترجمة الشيء برموز . أما المعرفة الحدسية فليست كذلك، لأنها فعل مباشر بسيط يحفظ للأشياء وحدتها وفرديتها الأصلية" (51). قال أبو عبدالرحمن : التفريق بين ما يعرف بالحدس وبين ما يعرف بالتحليل تفريق بين متماثلين، لأن ما يعرف عقلياً بالتحليل والوسائط قد يعرف حدسياً. أي برؤية مباشرة . وإنما خَيَّل لبرجسون زمن تابعه أن معرفة المطلق حدسية : (52) أن المطلق ذاته لا يحتاج إلى تحليل، لأنه أعم العمومات عند الفلاسفة، ولهذا عبروا عن الوجود بأنه مطلق . والواقع أنه لا وجود إلا بهوية . وحينما يَعرف العارفُ مطلقاً فإن كان المطلق (53) بمعنى رب الكائنات سبحانه فللحدس مجال في ذلك كما مر بيانه . وإن كان المطلق معنى أعم فلا يكون العلم بذلك حدساً، بل هو تجريد ذهني .؟ أي أن الحادث لم يعرف شيئاً كان يجهله ، وإنما جرد معنى أعم من معارفه . والمعرفة التحليلية التي تعيِّن شروطَ ما هو غير مطلق أعلى وأجل، لأنها زيادة علم . ويتجلى الحدس معرفة ومضاهاة (خلقاً فنياً) في خصوص نظرة الفنان إلى الأشياء حيث يدرك ما هو فريد، وبحيث يلفت نظر الآخرين بما يبدعه من فن . وقد أثنى عربرت ريد على برجسون بأنه نبه الإنسان المعاصر إلى الرؤية الفنية التي تخاطب حس الإنسان بلغة اللون والشكل والصوت ما دامت حياتنا الحسية حياة لا نتزود بها من العلم، أو العقل النظري !! . وهذا نص فيه بحبحة لبرجسون عن الحدس الفني أنقله من كتاب "الشعر والتأمل" لهاملتون ترجمة محمد مصطفى بدوي عن كتاب برجسون"مصدر الأخلاق ومصدر الدين" . وقال "إن في استطاعة من يمارس فن الإنشاء الأدبي أن يتبين الفرق بين العمل حينما يُترك وشأنه، وبينه حين يتوقد بنار الانفعال الأصيل الفريد الذي يولد من توافق بين المؤلف وموضوعه . أي من الحدس . ففي الحالة الأولى يكد الروح ويعمل ببرود ويجمع بين معان تجري في ألفاظ منذ زمن طويل . معان يقدمها إليه المجتمع في حالة جمود وصلابة . أما في الحالة الثانية فيبدو أن المواد التي يقدمها العقل قد دخلت مقدماً في عملية صهر وامتزاج ، ثم تصلبت بعد ذلك وتجمدت من جديد، ثم أخذت شكل معان يأتي بها الروح ذاته . وحينما تجد هذه المعاني ألفاظاً موجودة فعلاً تكفي للتعبير عنها فإن ذلك يعني صدفة (54) سعيدة لم يكن يحلم بها أحد . فالواقع هو أنه لابد لنا من أن نعين الصدفة غالباً، وأن نلزم مدلول اللفظ أن يلائم الفكر أو المعنى . وفي هذه الحالة يكون الجهد شاقاً، والنتيجة غير مؤكدة . إلا أن مثل هذه الحالات هي وحدها التي يحس فيها للروح أو يعتقد بأنه أخلاق . ولا يبدأ الروح ينتقل في خطوة واحدة إلى شيء يبدو في نفس الوقت واحداً وفريداً. شيء يسعى بعدئذ إلى الظهور بقدر المستطاع في حدود التصورات الكثيرة المشتركة التي تُقدَّم لنا سلفاً في شكل الألفاظ" (55) . قال أبو عبدالرحمن : هذا ما استطعت إيجازه من فلسفة برجسون، وأكثر من هذا الإيجاز مخل، وفيه ميتافيزيفيات كثيرة، وهو ظلال فلسفة أعمق من الحدس الفني تتبنى حسبانية ذكية في الصد عن العقل والعلم للترويج للإلحاد. |
|
|
#9 |
 |
الفصل الرابع : كروتشه وفلسفة الفن : عند فلاسفة أهل الإسلام أن القول الفني يكون شعراً بعنصرين معاً : أولاهما : الاستعمال الخاص للغة (المحاكاة) . وثانيهما : الوزن . والعنصر الأول هو السمة الخاصة، والعنصر الثاني سمة مكملة يتحقق بها التعريف للشعر لتميزه عن أنواع النثر الفني . والعنصر الأول يميز القول الشعري عن الأقوال غير الفنية . وتميز الشعر عن أنواع النثر الفني بالوزن مشروط بتميزه مسبقاً بما يميزه من خصائص في العنصر الأول (الاستعمال الخاص للغة) . فقد يوجد الوزن ولا يكون المنظوم شعراً . هذا ما أكده الفارابي في كتاب الشعر، وجوامع الشعر، وابن سينا في الخطابة . قال أبو عبدالرحمن : واستعمل قوم التعبير عن النثر الفني بتجوز، بالوزن . يقول ابن سينا عن الشعر "كلام مخيل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة متساوية متكررة على وزنها" . وجعل الإيقاعات المتفقة فرقاً يميز الشعر عن النثر . وهو بلا ريب يعني النثر الفني . قال أبو عبدالرحمن : فهل العنصران المذكوران هما الظاهرة الجمالية في الشعر؟!. كلا . وإنما هما مميزان لجميل من جميل . مميزان للشعر - الذي هو موضوع للجمال - عن فنون أخرى، وهي مواضيع للجمال . ويهم المنظر الأدبي من الجمال : 1. الإحساس بالجمال الطبيعي، واستنباط عناصر الحكم الجمالي من الذات والموضوع . 2. الجمال الفني إبداعاً، وإحساساً، وحكماً . والأمر الأخير أجد تلخيصه من فلسفة كروتشه من فبل الدكتور عبدالرحمن بدوي الذي وضع بعض المعالم والصوى لفلسفة كروتشه الفنية، وأول معلم تقريره أن الفن "لا يقوم في مضمون معين، ولا في شكل محدد بالذات، فما يكوِّن الجمال في الأثر ليس معناه الأخلاقي أو الديني أو المتعة التي يجلبها للمشاهد . كذلك لا يوجد شكل جميل - أو تماثل أو انسجام - بدون مضمون . وإذن لا يقوم الجمال الفني في هذا المضمون أو ذاك، ولا في هذا الشكل أو ذاك، وإنما يقوم في الرابطة بين المضمون والشكل معاً . قال أبو عبدالرحمن : ليكن موضوع هذا التنظير الفن الشعري، لأن حقل من الفن، ولأنه ألصق بالضمون والشكل . ومن ثم يحق لنا التساؤل : هل يعقل وجود فن شعري لا يقوم في مضمون معين وشكل محدد ؟!. إذن الجمال الفني إحساس يوجد موضوعاً في المضمون والشكل، ولكل من العنصرين قيمة الجمالية . والعلاقة بين العنصرين أيضاً موضوع ثالث للجمال الفني يؤخذ منه المثال الأرقى للجمال . وكون الفن تعبيراً يقبل الالتزام لا يعني خلوه من جمال مجاني كأن يكون النظرُ إلى جمال شكلي بغض النظر عن علاقته بالمضمون الكلي الذي يريده الفنان . وثاني معلم ذكره الدكتور عبدالرحمن بدوي وصفه للرابطة بين الشكل والمضمون بأنها "تقوم في العاطفة والخيال معاً . إنها تركيب قبلي للعيان الجمالي الحسي . ولا يوجد موضوع فني خارج الوحدة العضوية بين الخيال والعاطفة . والصورة الخيالية من العاطفة هي شكل خاوٍ، وكذلك العاطفة بدون صورة هي مادة عمياء" . قال أبو عبدالرحمن : العلاقة بين الشكل والمضمون في العمل الفني الشعري أن يكون المضمون صادراً عن إرادة فكرية، أو جيشان عاطفي. وأن يكون في الشكل الأدائي منسبة للمضمون الفكري أو العاطفي غير مجرد الدلالة اللغوية . والخيال جزء من النشاط العقلي الذي أطلق التعبير عنه بالمضمون الفكري . ثم تبقى القيم الجمالية في المضمون كقيمة الجدة، والابتكار، واللماحية، والقوة . وفي الشكل كالإيحاء، والترقيص. والخيال والعاطفة مصدران للمضمون، وليس من الشرط اتفاقهما معاً في أنه لا توجد صورة جميلة بدون ألوان ولا خطوط، كما لا توجد صورة موسيقية بدون نغمات وتوافقات . قال أبو عبدالرحمن : الأداة التعبيرية هي الشكل الذي يحمل قيماً جمالية . وقد بينت في مقدمة هذا الكتاب معنى وحدة الشكل والمضمون . قال أبو عبدالرحمن : وبقيت نتف أحكام مرسلة من كتاب "علم الجمال بوصفه علم التعبير" لكروتشه . قال الدكتور بدوي مستعرضاً مذهب كروتشه "الفن لا يستغني عن صناعة فنية (تكنيك) . أي أن ثمة صعوبات فيزيائية لابد للفنان أن يتغلب عليها وهو بسبيل التعبير عن العاطفة في عمله الفني . والفن لا يتوقف على المنفعة أو اللذة أو الأخلاق أو الدين أو السياسة أو الفلسفة . وإنما هو مستقبل بذاته وإلا لم يكن فناً . والشعر هو الدرجة الأولى في الفن . إنه اللغة الأم لكل الجنس البشري . ولهذا يمكن أن يوجد الشعر دون أن يوجد النثر، لكن لا يمكن أن يوجد النثر دون أن يكون الشعر موجوداً". قال أبو عبدالرحمن : التعبير الأدق أن الشعر لا يقوم بغير شكل فني . والشكل قد يكون صناعة، وقد يكون حساً تلقائياً . وعندما يكون مضمون الفن منفعة أو لذة أو أخلاقاً أو ديناً أو سياسة أو فلسفة : فلا يتصور انفصال الفن عن هذه المصادر المضمونية، وإنما يكون الأداء تعبيراً فنياً إذا كان هو التعبير الأجمل عن المضمون بإيحاء أو تخييل . والشعر هو الدرجة الأرقى في أجناس النص الفني لقيامه على عناصر جمالية خارجية، ولكن هذا لا يعني أسبقية وجود الشعر . بل إذا أردنا الدخول في الميتافيزيقيات فإن اللغة المباشرة هي الأسبق، والتعبير الفني يكون في الشعر والنثر، وهو في النثر أبسط، فالأبسط أقدم . والحدس والرؤيا عند كروتشه تعبيران عن العمل الفني، وهو الصورة الذهنية التي يؤلفها الفنان . ومن صفة المضاهاة دعوى التمازج بين الذات والموضوع، وبين الشكل والمضمون . والتصور الذي يسبق تحقق المضاهاة يسمى رؤيا، ويسبق الرؤيا الاستغراق في التأمل، ويصفونه بأنه استغراق الذات في الموضوع . ومن السموق الفني في المضاهاة ما ذكره الدكتور محمد ذكي العشماوي بقوله "فالموقف الذي يقفه أديب هذا العصر من الأحداث السياسية أو الاجتماعية هو موقف الفنان أولاً وقبل كل شيء . موقف الفنان الذي يرى وراء كل حدث وكل قضية سياسية أو اجتماعية دلالة إنسانية ما . بحيث تتحول الحادثة أو القضية المرتبطة بزمن ما أو مجتمع ما إلى قضية إنسانية تكتسب الخلود واللازمنية عن طريق تأمل الفنان ورؤيته الخاصة . ولن يتأتى للفنان مهما التزم أن يحقق الإنسانيات، وأن يتجاوز بفنه حدود الزمان والمكان إلا إذا استطاع أن يحول كل ما حولها (مهما بلغت أهمية الأحداث التي تحيط به أو الموضوعات التي يعالجها) إلى فن رفيع . فجميع هذه الموضوعات ليست إلا مجرد مناسبات لا ينقلها الفنان نقلاً مباشراً أو عملياً . بل لابد أن تتحول إلى رموز تمثل غبطة الإنسان أو شقاءه . خيرة أو شره" . قال أبو عبدالرحمن: لنعرف طبيعة الحدس الذي ينتج مضاهاة فنية (الخلق الفني): نحلل المعاني المنفية عن دائرتها، ونحلل خصائص الفن المنتج وعناصر المضاهاة نفسها . فالمنفي أن تكون المضاهاة مجرد وصف، أو مجرد تعبير عن حالات شعورية . ومن مقومات الفنان أن يكون ذا ذاكرة فنية تعي الأعمال الفنية السالفة وأن يكون ذا ذوق وإحساس بمجالي الجمال في الأعمال السالفة والمعاصرة . والذات (الأنا) لا تعرف إلا بالحدس، ولهذا فالحدس حالة عقلية خاصة ندرك فيها الطابع الكيفي للوعي الداخلي وتياره . وأحياناً يجعل الحالة العقلية بمرادف التعاطف مع أعمق جوانب الواقع . وفي حديث مجاهد عبدالمنعم مجاهد عن التعبيرية في فلسفة كروتشه الفنية لوَّح إلى الروح الاستعمارية في مذهبه فقال " بل إن هربرت ريد ليكشف عن نظرة استعمارية أثناء بيانه لأسس هذه المدرسة في كتابه معنى الفن، فهو يرى أن الفن التعبيري يرتد إلى الأجناس الشمالية لأنها أكثر استيطاناً لنفسها . ولما كان يرى أن خير المدارس الفنية هي المدرسة التعبيرية المدافع عنها : فهو يمجد على هذا الأساس تلك الأجناس الشمالية البيضاء . وإذا كان كروتشه قد رفض الدين وأصيب بأزمة روحية : فهو قد أحل محل هذا الرفض نظرة شديدة العداء للبشرية في كلامه عن الفن . وكانت نظريته هو وأتباعه أعلى مراحل المثالية المأزومة المنهارة في القرن العشرين في مجال الجمال" . قال أبو عبدالرحمن : هذا أمر يتعلق بمواهب الشعوب، وخصائص الوراثة، والتحليل السيكلوجي للفنان، وهو خارج نطاق النظرية الفنية . قال أبو عبدالرحمن : فلسفة الفن ، وأصول النقد الأدبي من صميم الفلسفة . والفلسفة علم خاص وليست علماً شعبياً، فهي تقتضي لغة مباشرة، ودقة فكر . بيد أنها في متناول ذوي التفكير الشعبي من الأدباء وهواة الفن . بحكم أنها فلسفة مضافة إلى الأدب والفن ، ففقدت التخصص الفلسفي، واستعير الأسلوب الإنشائي العائم بدل اللغة الفلسفية الموصلة كهذا التفريق غير الفارق بين النفاذ والمعرفة . يقول الأستاذ مجاهد عبدالمنعم عن فلسفة الحدس لدى كروتشه "المعرفة الحدسية هند كروتشه ليست معرفة عن شيء، وليست انطباعات بشيء . إنما هي نفاذ . هي نفاذ الروح بالروح . فلا شيء عنده خارج النشاط الروحي . الروح هي الواقع كله . ومن ثم يوحد كروتشه بين الفن والحدس والتأمل والتخيل والخيال . وهذا التأمل أو الخيال هو خيال الفرد عن مشاعره وتأملها" (57) . قال أبو عبدالرحمن : المعرفة نفاذ وإلا كانت جهلاً . فقد تكون معرفتي بالتفاحة معرفة تامة . أعرف شكلها، وحجمها، زطعمها، ومكوناتها، ورائحتها، وقيمتها الغذائية، فتكون معرفتي التامة نفاذاً في جوانبها . وقد تكون معرفتي بها جانبية عن طعمها ورائحتها، فتكون معرفتي نفاذاً فيما عرفته منها . والزعم عن الروح - بالاصطلاح الكروتشي - ينطوي على مغالطة شرسة، وهي تعميم التوحيد بين "أنا" و "لا أنا" . فحينما ننظر إلى أن ما في ذات المعرفة صورة لما في الواقع نوجد بين المعرفة التي هي المعروف وصورته . وذلك التوحيد تجوزي . وحينما ننظر إلى الواقع كما هو نجد الأصل والصورة، والعارف والمعروف، والذات والموضوع، والأنا واللاأنا. وتوحيد كروتشه بين الفن والحدس . إلخ - إن صح أن ذلك مذهبه ببناء فلسفي دون تجوز أدبي - تفريق لا واقع له إلا في الدعوى المسطرة على الورق، ولكل مفردة واقعها المتميز . فالفن حصيلة معرفة، ونشاط ذهن . يوحي إيحاءً جمالياً بالحقيقة أو يشبهها بحقيقة أخرى، أو يشبهها بالمضاهاة لواقع فني يضاهي الواقع الطبيعي . وهذا النشاط ينفصل عن الفنان ليكون مسموعاً أو مرئياً . والفن الشعري بالذات تعبير إيحائي، أو رمزي أو تشبيهي أو تأليفي (مضاهاة)، فهو التعبير الأرقى للإيحاء بالواقع، أو المضاهاة للواقع ببراعة . إذن الفن هو الصورة على اللوحة، أو الصوت الغنائي في الأذن ، أو الصورة التي ترسمها اللغة في الذهن . إلى آخر الحقول الجميلة . هو كل هذه الأشياء وما فيها من دلالة بسببها قَبٍل الفنُ والأدب الالتزامَ . والحدس نوع من النشاط في ذات الفنان يصل إلى بنائه الفني مباشرة . فالحدس إذن ليس هو الفن، وإنما هو النشاط الذي أنتج الفن . وقل مثل ذلك عن بقية النشاط الذهني من التأمل والتخيل والخيال . ويبني الأستاذ مجاهد - فيما يحكيه من مذهب كروتشه - على التوحيد بين هذه المفردات، وعلى التوحيد بين الأنا والذات أحكاماً يحللها بقوله "ومن هنا لا يعترف كروتشه إلا بالفن الغنائي، لأن الغنائية هي من شأن الفردية والذاتية . فماذا من شأن تعريف الفن بالحدس من الناحية الإيجابية ؟ . الحدس عند كروتشه هو التعبير . والتعبير كما أوضح أوزبورن عندهم بمعانٍ ثلاثة : التعبير عن الذات ، والتعبير عن العاطفة، والرمز على حالة من حالات النفس . ليس التعبير عندهم هو ذلك التجسيد الخارجي، بل هو تلك الحالة الاستنباطية التي يوجد فيها المرء . حتى ولو لم يبدع ؟ . تلك الحالة التي يستحلب فيها المرء مشاعره . ومن المؤكد أن كروتشه - ويتبعه في هذا كل التلاميذ - يرى أن ما يحدسه الفنان قبل الخلق هو أكثر جمالاً مما تم بعد الخلق، وأن ما يتذوقه المتذوق إبداع جديد ليس فيه من حدس الفنان أي شيء . وكل الفارق أن الفنان يشتغل على حدسه، بينما القاريء يشتغل حدسه على حدس الفنان . ومن هنا تَمَّحى صفة التوصيل عن الفن . وكاريت يرى أن الفن لا شأن له بالتوصيل إلى الآخرين" (58) . قال أبو عبدالرحمن : الغنائية نوع من الفن، وليست هي كل الفن، والقاسم المشترك كل القيم الجمالية . والحدس نشاط ذهني ووجداني ليس موقوفاً على الفن، بل يكون الحدس في المنطقيات والخلقيات . والحدس ليس هو التعبير . وإنما التعبير قد يصدر عن وعي أو نشاط ذهني يسميان الحدس !!. قال أبو عبدالرحمن : وأستبعد أن يكون مذهب كروتشه أن الفن هو التعبير الاستبطاني وإن لم يبدع !!. وعلى فرض أن هذا هو مذهبه، فهو مذهب لا يحقق قيمة نقدية، بل الفن ما حقق القيم الجمالية - وأشرفها الإبداع - سواء عبر عن الذات، أم عبر عن خارجها . والفنان - بعبقريته - قد يثير تفاعل الآخرين وإن لم يتعاطف مع موضوعه قلبياً . بل يكفي تفاعله الذهني، وأنه جعل الذوات الأخرى تنفعل . ومن الوهم المحض الثنائية بين الحدس الفني هو المضاهاة الفنية (الوجود بالفعل) الصادرة عن الحدس الذهني أو الوعي (الوجود بالقوة) . قال أبو عبدالرحمن : إذن أي جمالٍ لحدس الفنان قبل المضاهاة الفنية وهو لم يوجد بالفعل ؟! فإن أراد كروتشه أن الحدس بعد المضاهاة (ما يسمونه الخلق الفني) هو الاستلماح ظاهرة جمالية أو دلالة - وقام الدليل وقام الدليل أنها لم تخطر ببال صاحب المضاهاة - فذلك قدرة في الأداة حققت مقصد الفنان وزيادة . إلا أن هذا الاستلماح من المتلقى الذي سماه حدساً لا يوصف بأنه حدس الفنان قبل المضاهاة، أو بعدها . وإنما هو فعل المتلقي . ولكن هذا ليس هو، لأنه قال "مايتذوقه المتذوق إبداع جديد ليس فيه من حدس الفنان أي شيء". وهذا تفريق آخر يذكره مجاهد عن كروتشه، فيقول "ويطلب منا أن نميز بين الفن بمعنى الخلق الفني، وبين الحرفة أو التكنيك . فالفهم هو الخلق الباطني . |
|
|
#10 |
 |
إلا أن هذا الاستلماح من المتلقى الذي سماه حدساً لا يوصف بأنه حدس الفنان قبل المضاهاة، أو بعدها . وإنما هو فعل المتلقي . ولكن هذا ليس هو، لأنه قال "مايتذوقه المتذوق إبداع جديد ليس فيه من حدس الفنان أي شيء". وهذا تفريق آخر يذكره مجاهد عن كروتشه، فيقول "ويطلب منا أن نميز بين الفن بمعنى الخلق الفني، وبين الحرفة أو التكنيك . فالفهم هو الخلق الباطني . اما التوصيل فهو أمر ثانوي يرجع إلى حرفية الفنان . خاصة وأن ما سيصل إلى القارئ سيصبح موضوعاً للحدس من جديد . الحدس عندهم هو التعبير عن العاطفة . والتعبير عندهم كما عرفه هربرت ريد هو ردود أفعال عاطفية . ومن هنا جاء التوحيد لديهم بين الحدس والتعبير . بين الانطباعات والتعبير . كأن ليست هناك عند الفنان مرحلة تلقٍّ ومرحلة إبداع ! . لأنهم يرون أن العارف بالمعرفة الحدسية يخلق بطريقة ما ما يعرفه . ولقد غالوا . فالفن عندهم ليس حتى المضمون . ليس هو هذه الانطباعات أو الحدوس أو التعبير . بل الفن هو وحدة الشكل تلك الوحدة التي تحددها العاطفة . فكشفوا حتى هنا عن نظرتهم المثالية . فالشكل والمضمون في الحقيقة هما وحدة متآزرة عن طريق الزمان الفني للعمل مع أسبقية المضمون . أما كروتشه وأتباعه فيرون أن وسائل الفنان الإبداعية في حرفته إنما ترجع إلى الحدوس حيث أن الإيقاع والتوازن والوزن والتناغم هي جميعا أشياء حدسية، وليست إنتاجات عقلية . فكأن كل هذه الأشياء عندهم ليست إلا نتاجات غرائزية لحدوس الفنان . وهنا يكشفون حتى عن إماتتهم لحرية الفنان في خلقه ما دام ينتج غرزياً تلك الحرية التي كانوا يريدون الإعلاء من شأنها . إنهم صرحاء في إعلانهم عن موقفهم وتعبيرهم عن أزمة الحضارة في الغرب وانهيارها . فيعلنون عن وجهة نظرهم الجمالية المتمشية مع هذا الانهيار . وما المدرسة التعبيرية في الفن إلا أعلى مراحل الفلسفة المثالية المتأزمة في نطاق علم الجمال . هي مدرسة لا تريد أن تعبر عن الوقائع الموضوعية، ولا تريد أن تسلم الناس حتى يتغيروا فيغيِّروا. بل هي الذاتية التي وصلت بها أزمتها حتى الخناق"(59) . قال أبو عبدالرحمن : التلاعب باللغة ضلال فكري، واعتداء على منهج التفلسف، وليس في اللغة ولا في الواقع أن الفهم هو المضاهاة الفنية، وإنما الفهم نشاط ذهني ينتج عنه الأداء الفني . والتوصيل هو الأداء الفني نفسه (الخلق بلغتهم) ، وهو موضوع الحدس . وجعلُ الفن تعبيراً عن العاطفة قَصْرُ للفن على بعض مهمته، وهو تحجيم لا يليق باللغة الشعبية فضلاً عن اللغة الفلسفية . ولا مانع بلغة التشبيه أن نقول عن الفنان المرسل الحادس : إنه يُشْبه مَن يُوجِد ما يعرفه ! . ولكن المتلقي إذا فهم شيئاً يدل عليه النص - وقام البرهان على أن الفنان لم يقصده -فقد تكون معرفة المتلقي حدساً، وقد تكون بوسائط معقولة . والروح المتردد في فلسفة كروتشه بددته فلسفة التمزق الاصطلاحي، فأفرغت الروح من معناها العرفي العام لدى أجيال الإنسانية، وادعت له معنى آخر هو العالم . أي ما هو خارج ضروباً أربعة من الخبرة : فهناك أولاً : الخبرة الإدراكية التي تدرك بها ما هو جزئي حيث تعبِّر الروح عن نفسها في أمثلة جزئية تتجسم فيها، وهذا هو ميدان علم الجمال . وهناك ثانياً : الخبرة الإدراكية التي تدرك بها ما هو كل، وهذا هو ميدان الاهتمامات الاقتصادية . ثم هناك رابعاً : الخبرة العلمية التي تُعنى بما هو كلي، وهذا هو ميدان علم الأخلاق . قال أبو عبدالرحمن : هذا تقسيم لا يحقق جهة قسمة واحدة، ولا يحقق أقساماً متميزة في الواقع . ومعرفة المنطق جزئية وكلية . ولكن من أعمالِ تجريدات لا تكون حكمية إلا إذا كانت كلية . (التطريز نوع من التلاعب بالقوافي في نظم الشعر، ويدعى المحبوك الطرفين . يبدأ البيت فيه بحرف، وينتهي بالحرف نفسه . وتطور المحبوك الطرفين عندهم إلى فن آخر أكثر تعقيداً دعى بالتطريز، وهو أن يؤلف الشاعر من الحروف الأولى للقطعة اسم علم لصديق أو محبوب أو ممدوح، وأغلب معاني هذه القطع المطرزة في الغزل أو في معنى طريف، ويتألف عدد أبيات القطعة عادة على قدر عدد حروف الاسم . قال نظام الدين الحسني قطعة مطرزة باسم خديجة: خلت خال الخد في وجنته * * * نقطة العنبر في جمر الغضى دامت الأفراح لي مذ أبصرت * * * مقلتي صبح محيا قد أضا يتمنى القلب منه لفتة * * * وبهذا الحظ للعين رضا جاهل رام سلوا عنه إذ * * * حظر الوصل وأولاني النضى هامت العين لما رأت * * * حسن وجه حين كنا بالأضا المعجم المفضل في الأدب 1/262 الهوامش : (1)النظريات الجمالية ص32-33. (2)الجمالية ترجمة الدكتور عبدالواحد لؤلؤة ضمن المجلد الأول من موسوعة المصطلح النقدي ص272. (3)قال أبو عبدالرحمن: ما اقبح هذا التعبير والتشبيه معاً! (4)فلسفة الجمال ص8-9. (5)فلسفة الجمال ص14. (6) الإحساس بالجمال ص61 وما بعدها [العشماوي] (7)مشكلة الفن ص12 [العشماوي]. (8)المرجع السابق ص12 [العشماوي]. (9)فلسفة الجمال ص10. (10)هما: أي الإحساسان. (11)جملة "فإنهما" جواب"على الرغم"، ولهذا وضعت النقطتين فوق بعض وهما علامة مقول القول. (12)فلسفة الجمال ص11. (13)دراسات في علم الجمال ص19. (14)انظر المصدر السابق ص20. (15)المصدر السابق ص20-21. (16)دراسات في علم الجمال ص20. (17)دراسات في علم الجمال ص20. (18)دراسات في علم الجمال ص15. (19)النظريات الجمالية ص47. (20)فلسفة الجمال ص55. (21)أنوي إن شاء اله تحرير دراسة مفصلة عن علامات الترقيم، فهي ضرورية لتفهيم الكلام وإيضاحه، وهي جمال في الخط.. وبعض الكتاب يهملونها، وبعضهم يستعملها في غير موضعها.. ولأثري دراستي بالشواهد أحببت أن أحشي مؤلفاتي ببعض اللفتات عن علامات الترقيم. فالأصل كتابتها عند وجود اللبس بدونها، فإذا أمن اللبس فلا حاجة لها إلا علامات التأثر-مثل ؟!-، وعلامة مقول القول وهي النقطتان فوق بعض. قال أبو عبدالرحمن: وهاهنا لم أكتب علامة الفصل بين أجزاء الكلام -وهي الواو المقلوبة هكذا،- بعد "منهما" وقبل "تزكيه"، لأن جملة تزكيه هي الخبر ولم يفصل بينه وبين المخبر عنه بفاصل فلا لبس. ولم أكتبها بين "الحق" و"الأخلاق" لأن التثنية في "قيمتا"، وواو العطف، وعدم الفاصل مشعران بتقسيم القيمتين، فلا لبس ولا ضرورة للشولة. وعبارة "من أجل" تحتاج للشولة المنقوطة من أسفلها "؛" مشعرة بالتعليل، ولم أكتبها للتنصيص على التعليل بعبارة "من أجل"، وعدم الفاصل واللبس. ولم أكتبها قبل "لصلته" لأن الضمير المذكور دال على أن التعليل للجمال.. ولو كان التعليل لـ "قيمتا" لوضعت قبل التعليل علامة الانقطاع في الكلام، وهما النقطتان جنب بعض هكذا"..". (22)وضعت هذه الشولة المنقوطة لأنها مشعرة بالتعليل. (23)لم أنقط الشولة وهي للتعليل، لأن التعليل مفهوم من عطفها على تعليل. (24)من مدلولات النقطتين جنب بعض إشعارهما بقطع الكلام باستئناف، أو فصل دون وصل، فغذا كان في الكلام حذف زدت نقطة ثالثة هكذا... وكلما زادت النقط دلت على كثرة الحذف. (25)استأنفت الكلام عن الخيال استئنافاً يفسر الفرق بين الخيال والوهم فوضعت النقطتين دليلاً على فصل الكلام باستئناف جملة جديدة، وعلى العلاقة بين الجملتين.. وعند تمام الانفصال تضع نقطة واحدة.. ومن المعاصرين من يضع نقطة واحدة ويبدأ من سطر جديد.. وكثرة الابتداء بسطر جديد يمزق الكلام، فيكون معظم الصفحة بياضاً، ولكن لا مندوحة عن ذلك ما دام الكلام بعد النقطة استئنافاً منفصلاً عما قبله. (26)الموسوعة الفلسفية المختصرة ص343. (27)لو كان الكلام:"ويكون ذلك خاصة" لوضعت الشولة علامة الاتصال والتقسيم والعطف.. فلما أشعر الكلام بحذفٍ غطته واو العطف، وأشعرت الجملة بالانقطاع وضعت علامة النقطتين. (28)هذه الأسطر لم تشتمل على غير علامة مقول القول ":" لأمن اللبس وانتفاء الضرورة.. وما بعد النقطتين حكاية للمذهب، فهو في حكم مقول القول. (29)عبارة "بصورة جوهرية" لم أضعها بين علامتي الجمل المعترضة لأمن اللبس. (30)الموسوعة الفلسفية المختصرة ص281-282. (31)أثبت الشولة فيما سبق لأجل الجملة التي بعدها حتى لا يظن أنها مستأنفة، وليعلم أنها معطوفة. (32)مقاييس اللغة ص251. (33)انظر تاج العروس 8/238. (34)قال الزبيدي في تاج العروس 8/237-238:"قال ابن كناسة: تقول العرب: إذا أمسى النجم قمّ الرأس، ففي الدار فاخنس، وفي بيتك فاجلس، وعظماهم فاحدس، وإن سئلت فاعبس، وأنهس بنيك وانهس. قال الزبيدي: قوله: عظماهن فاحدس معناه: انحر أعظم الإبل.. وقيل: قولهم: فاحدس من حدست الأمور.. توهمتها.. كأنه يريد: تخير بوهمك عظماهن". قال أبو عبدالرحمن: ليس في كلام العرب هاهنا إلا احدس الكبرى.. أي تخير الكبرى بحدسك (والأصل في الحدس الإصابة).. وليس فيه أن احدس بمعنى تخير بوهمك. (35)التعريفات ص83. (36)لم أضع الشولة هاهنا لأن الجار والمجرور من تمام الجملة. (37)وضعت النقطتين ولم أضع الشولة لأن ما بعدها استئناف كلام جديد، وليس في سياق الأمثلة. (38)الكليات ص66-67. (39)لم أضع الشولة قبل "وأمدية" حتى لا تشعر بالعطف على تحتفظ. (40)لم أضع الشولة لأن العطف على "تحتفظ" ود فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمعطوف عليه ومعطوف جديدين، فلزم الفصل بالنقطتين. (41)وضعت القوسين الكبيرين بدل الشرطتين (-،-) لأن الجمل المستدركة قد تكثر فتلبس الشرطتان.. فقد يكون في سطرين ست شرطات فلا يعرف من أي الشرطات هو يبدأ الاستدراك. فللكاتب أن يضع مكانهما القوسين الكبيرين، وله أن يراوح بينهما إذا كثرتا، فإذا وضع الشرطتين وجاءت جملة أخرى مستدركة وضع القوسين. (42)تحلو هاتان النقطتان في مواضع الفصل مثل الجمل البدلية. (43)جملة "فليكن" جواب "مع أننا" فهي في حكم مقول القول وقد طال الفاصل بينهما، فناسب لذلك علامة المقول النقطتان. (44)ما بعد النقطتين جملة خبرية، وبدون النقطتين يظن أن الجار والمجرور من تمام الجملة قبلهما. (45)وضعت علامة الفصل، لأن الجملة بعد النقطتين مستأنفة، وبدونها يوهم الكلام أن الجار والمجرور متعلق بما قبلهما. (46)مدلول (مع) هاهنا كمدلول واو العطف في إضافة شيء إلى شيء، لهذا وضعت الشولة قبلها. (47)الأسلوب هاهنا أعجمي، والمراد: بل لا تلغي النظام. (48)قال أبو عبدالرحمن: لا فرق بين الجملتين إلا إن أراد بالدور أنه يمثل الماضي بشكل آخر. (49)لم أضع الشولة -علامة الوصل والتقسيم- هاهنا؛ لأن جملة "وإن كانت" من تمام السياق لا من أقسامه. (50)وضعت علامة التعليل لأن الجملة معطوفة على معلل، ولم يسبق ذكر للعلامة. (51)فلسفة الجمال ص174/دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة سنة 1983م ط م الفنية بالقاهرة. (52)ما بعد النقطتين فاعل "خيَّل" وقد طال الفاصل بينهما، فوضعت النقطتين لأن الفاعل في حكم مقول القول. (53)لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه.. والمراد بالمطلق (إذا عبروا عن رب الكائنات) الذي له العلم الكامل لإطلاق، والقدرة الكاملة بإطلاق..الخ. قال أبو عبدالرحمن: وجب وضع علامة الجمل المعترضة في قولي هاهنا: (إذا عبروا...)؛ ليعلم أن ما قبلها خبر ما بعدها. ويجوز الاستغناء عنها بعلامة مقول القول (:) قبل "الذي". (54)الصواب: مصادفة. (55)الشعر والتأمل ص182-183/طبع بالقاهرة سنة 1963م. (56)لم أضع علامة مقول القول لأنه لا يوجد فاصل فضلاً عن أن يكون طويلاً، ولأنه لا أقسام وتفريعات لمقول القول تقتضي شولة. (57)علم الجمال ص156-157. (58)علم الجمال ص157. |
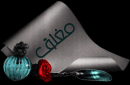 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الرحمن, عقيل |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| احجزوا في قطار السيره ؟؟؟؟؟؟؟؟ | البرق النجدي | …»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… | 56 | 07-31-2010 05:06 AM |
| سلسله يدونها لاعضاء...؟؟؟ | البرق النجدي | …»●[الرويات والقصص المنقوله]●«… | 9 | 02-13-2009 01:10 AM |
| نبذة عن الشاعر :: زهير بن أبي سلمى | a7med | …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… | 0 | 02-09-2009 11:42 AM |
| موسوعه قصايد ليل المعلوماتيه ...؟ | البرق النجدي | …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… | 12 | 01-12-2009 08:18 PM |
| عثمان بن عفان | a7med | …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… | 5 | 10-24-2008 04:02 AM |
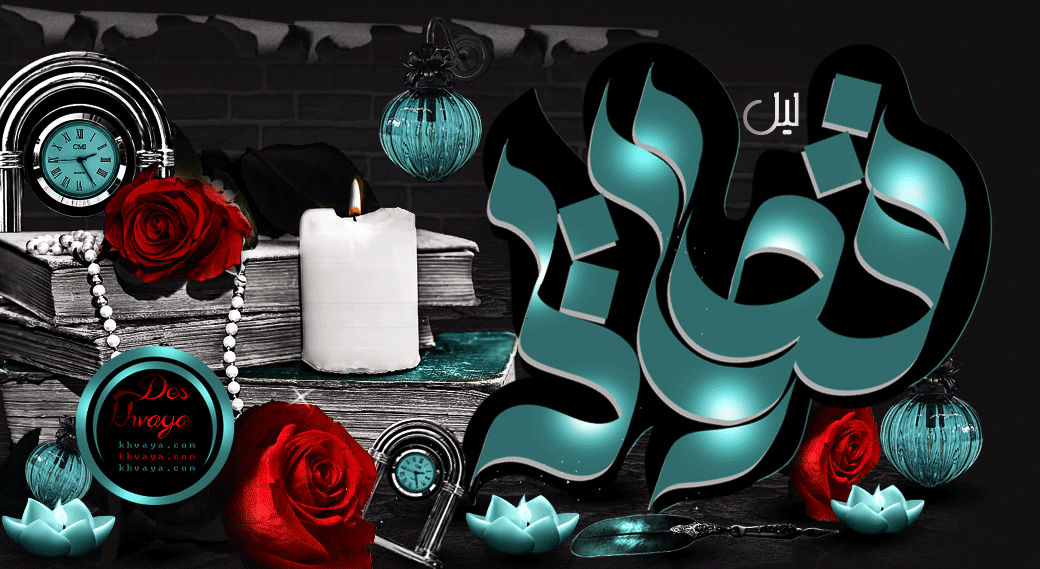 |